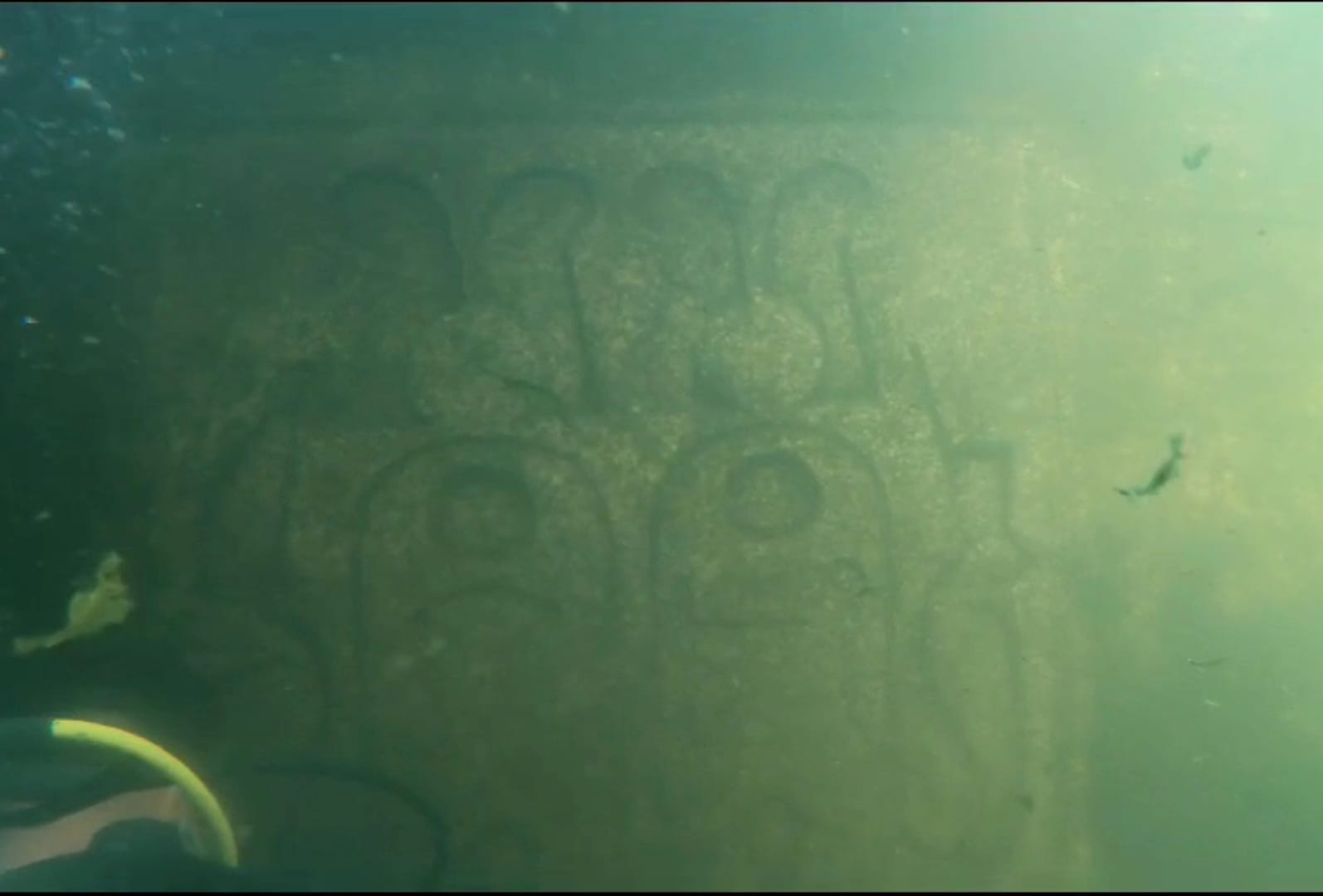- فكر اقتصادي لم يتغير منذ 50 عاما واقتصاد يعبر عن رؤية القيادة السياسية ويعكس الأولويات التي حددتها بالنيابة عن الشعب
- لا بد أن يكون الإصلاح شاملاً ومتسقاً من أجل التعامل مع التناقضات والتوترات الناجمة عن التغير الاجتماعي والثقافي
الأمر جد خطير ولم يعد يحتمل ترف الصمت أو السكوت. وبدأت بالفعل تتعالي الأصوات التي تدعو إلى تغيير المجموعة التي تدير الشأن الاقتصادي في الحكومة المصرية، والأخطر أن تدهور الوضع الاقتصادي الذي بات جلياً للجميع وعنواناً صارخاً للفشل، يثير انزعاج حتى أكثر الناس تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي وسياساته، ويشيدون بإنجازاته ولا يقفون كثيراً عند الثمن المدفوع من أجلها ولا يدعون إلى إعادة ترتيب للأولويات على نحو يظهر انحيازاً للسواد الأعظم للمصريين الذين يعانون ارتفاعاً متواصلا لا كابح له لأسعار سلع تعد من أساسيات الاحتياج وعلى نحو يؤدي إلى تأكل مستمر في القدرة الشرائية للعملة المحلية التي تتراجع بسرعة كبيرة أمام العملات الأجنبية.
كتبت قبل أسابيع محذراً من أي قراءة خاطئة لدلالة عدم استجابة المصريين لدعوات التظاهر في الشهر الماضي، ونبهت إلى خطورة تفسير ذلك على أنه تأييد لسياسات الحكومة، وشددت على خطورة التمادي في سياساتها وما قد يترتب على التمادي في هذه السياسات من نتائج كارثية وعواقب نبه لها، كثير من الخبراء والدارسين المهمومين بالشأن العام واستغلوا المتاح من نوافذ قليلة يمكن من خلالها نشر آراء غير تلك الآراء التي يرددها عدد من الإعلاميين والصحفيين المروجين بشكل دعائي فج للسياسات الحكومية، الذي تربحوا من ممارستهم مهنة "التضليل" و"التطبيل".
الأولوية للاقتصاد أم للسياسة
لقد أولت القيادة السياسية في مصر، ومنذ مطلع الثمانينات، الاقتصاد الاهتمام الأكبر، وأصبح ملف الإصلاح الاقتصادي أولوية للحكومات المتعاقبة منذ المؤتمر الاقتصادي الأول في عام 1982. أربعون عاماً تفصل بين المؤتمر الاقتصادي الأول والمؤتمر الاقتصادي الأخير الذي عقد في مدينة شرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي. ولا اختلاف كبيرا في المسارات التي سار عليها المؤتمر الأول والمؤتمر الأخير والتي تمثلت في ثلاث مسارات أساسية هي: السياسات الاقتصادية الكلية؛ تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال؛ ووضع خريطة الطريق للمستقبل مع ربطها بالقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة. ربما يكون لافتاً أن الفكر الاقتصادي السائد لدى دوائر التفكير الاقتصادي الرسمية في مصر، لم يتغير منذ التحول الكبير الذي بدأ مع سياسات الانفتاح الاقتصادي التي أطلقها الرئيس أنور السادات في أوائل سبعينات القرن الماضي.
جاء المؤتمر الأول استجابة للدعوات المتزايدة من قبل النخبة لتصحيح الاختلالات الهيكلية لسياسة الانفتاح، الذي وصفه الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين بأنه "سداح مداح" أي لا ضابط له ولا رابط. وركز الخبراء الذين اجتمعوا في المؤتمر الأول على حزمة السياسات المعنية بمؤشرات الاقتصاد الكلي. ولم يدرس الاقتصاديون، على ما يبدو، إلى أي نظام من أنظمة اقتصاد السوق، مناسب لحالة مصر التي ظل نظامها الاقتصادي يوصف لفترة طويلة بانه اقتصاد "مختلط" وهو مصطلح غريب بعض الشيء يجمع بين نظامين مختلفين تماماً. ووقع الاختيار على ما يبدو على مدرسة "شيكاغو" النقدية التي تركز على السياسات المالية، متجاهلين الفجوة الشاسعة بين وضع الولايات المتحدة واختياراتها الاقتصادية وبين حالة الاقتصاد المصرية، والتي تقترح حلولاً للمشكلات الاقتصادية تركز على التدفقات النقدية، ومتجاهلين أيضا طبيعة المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وأولوياتها.
يُقال إن "السياسة هي تعبير مكثف عن الاقتصاد" لكن الحالة المصرية تثبت العكس، أي أن الاقتصاد هو تعبير عن رؤية القيادة السياسية ويعكس الأولويات التي حددتها هذه القيادة بالنيابة عن الشعب وقواه الاقتصادية الاجتماعية المنظمة وغير المنظمة. وأثر هذا الوضع تأثيرا بالغ الخطورة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم تحكمه معايير اقتصادية بقدر ما حكمته رؤية القيادة السياسية وأولوياتها التي ظلت محكومة بالحفاظ على توازنات اجتماعية مع الاعتماد بشكل مفرط على مصادر ريعية لتحقيق هدف الحفاظ على التدفقات النقدية، والاهتمام بالتوسع في الاقتراض من مؤسسات التمويل والمساعدات الاقتصادية والمعونات الخارجية والقبول بشروطها من أجل تعظيم الإيرادات من العملات الصعبة والدولار الأمريكي أساسا وتكوين احتياطي نقدي من هذه العملة واعتبار هذا الاحتياطي مؤشرا على قوة الاقتصاد.
وترتب على هذه السياسات، التي تسعى للجمع بين متناقضات يستحيل الجمع بينها عند رسم السياسات الاقتصادية، تعثر برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب الخطوط الحمراء التي وضعتها القيادة السياسية فيما يختص بالتوازنات الاجتماعية والحفاظ على تأييد شرائح اجتماعية واسعة لاعتبارات انتخابية، إلى جانب الحرص على عدم إجراء الإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية، وعدم القدرة على التعامل مع مشكلات تتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد المستشري في الدولة والمجتمع معاً، وإهدار الاستفادة من الفرص التي اتيحت لمصر ومن أبرزها الفرصة التي نجمت عن إسقاط نصف ديون مصر الخارجية مكافأة لموقفها في حرب "تحرير الكويت"، مثلما حدث مع المعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية التي حصلت عليها مصر تشجيعا لها للمضي قدماً في نهج "التسوية" ولدورها في إدارة القضية الفلسطينية بما يتماشى مع السياسة الأمريكية دون الإخلال بالتزامات مصر المبدئية تجاه القضايا العربية.
وإهدار هذه الفرص كان نتيجة أمرين أساسيين: أولهما، هيمنة مدرسة شيكاغو النقدية على التفكير السائد لدى نخبة مصر الاقتصادية، والانشغال إلى حد الهوس بالحفاظ على تدفقات نقدية بغض النظر عن مصدرها أو ضرورتها لحل مشكلات الاقتصاد، وثانيهما، إخضاع السياسة الاقتصادية لأولويات القيادة السياسية المتغيرة، والتي باتت رهينة لشعار "المشروع القومي" الذي تفتقر إليه مصر، فذهب الكثير من الوفورات المالية والنقدية لمشروع "توشكى" دون إجراء دراسات كافية حول الجدوى الاقتصادية للمشروع أو الطريقة الأمثل لتنفيذه. يُضاف إلى ذلك عدم القدرة على إنجاز تحول حقيقي في الاقتصاد الجزئي كي يشعر المواطن بقدر من الاستفادة نتيجة لبرامج التحول الاقتصادي، مع الفجوة بين أثرياء يزدادون ثراء وفقراء يزدادون فقراٌ والموت البطيء للطبقات الوسطى في المدن وفي الريف أيضاً.
محاولة متأخرة وناقصة للإصلاح
ربما كان برنامج حكومة أحمد نظيف، التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، أكثر برامج الإصلاح الاقتصادي جرأة في التصدي لبعض المشكلات الهيكلية المترتبة على سياسات الحكومات السابقة، والتي كانت محاولة لحسم التردد نحو الانتقال الكامل لاقتصاد السوق ومنح القيادة للقطاع الخاص ورجال الأعمال والتحول بشكل كامل إلى اقتصاد رأسمالي، بما تحمله تلك التحولات من ضغوط إضافية على الطبقة الوسطى. قام برنامج حكومة نظيف على ثلاثة مكونات رئيسية: التوسع الصناعي اعتماداُ على تحويل مصر إلى حلقة في التصنيع التجميعي من أجل السوق، مثلما حدث في صناعة السيارات والسلع المعمرة، وبناء قاعدة لتصنيع منتجات جديدة مثل الأسمدة الحيوية؛ التوسع في قطاع الخدمات الذي يشمل السياحة والتجارة والتوزيع؛ التوسع في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. لم تكن الظروف الخارجية والداخلية مواتية وربما اعتمد برنامج الحكومة الإصلاحي على حسابات غير دقيقة للفرص والقيود، والأهم أن هذه المحاولة الإصلاحية أكدت قاعدة مهمة في الاجتماع السياسي تتصل بالعلاقة بين "الإصلاح" و"الثورة".
لقد طرح عالم السياسة الأمريكي الشهير صمويل هنتنجتون في كتابه "النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة" الصادر أواخر الستينات السؤال المحوري: هل الإصلاح محفز أم معوق للثورة؟ والنظرية التي خرج بها من دراسة عدد من الثورات إلى أن الثورة غالباً ما تنشب نتيجة لإخفاق محاولة إصلاحية. وهي فرضية تأكدت في دراسات ثورات أخرى لاحقة مثل الثورة الإيرانية عام 1979 التي جاءت نتيجة لمحاولة إصلاحية فاشلة لآخر حكومة للشاه رضا بهلوي. وقد ينطبق ذلك بشكل جزئي على الحالة المصرية في عام 2011. ربما كانت الإشكالية الكبرى الناجمة عن طرح هذا السؤال والبحوث التي تجرى بشأن فحص هذه الفرضية هو عزوف كثير من النظم السياسية، لاسيما في البلدان النامية عن خوض مغامرة الإصلاح ، الأمر الذي يؤدي إلى ركود لا يسمح برؤية المشاكل المتراكمة في ظله. ومصر في عهد الرئيس حسني الذي حكم البلاد ثلاثة عقود متصلة حالة نموذجية لدراسة أزمة التغيير والإصلاح في مصر.
والملاحظ دائماً، على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عدم الاتساق بين الإصلاح الاقتصادي، الذي يمضي بوتيرة سريعة أحياناً، وبين الإصلاح السياسي، الغائب غالباً إلى جانب الإصلاح الاجتماعي والفكري والثقافي، الأمر الذي يعبر عن غياب كامل لإرادة التغيير وغياب استراتيجية إدارته. إن "الإصلاح" آلية مهمة للقيادة السياسية في أي مجتمع لمواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية أيضا الناجمة عن التطور الاجتماعي الذي بات يجري بوتيرة سريعة نتيجة الانفجار المعرفي الناجم عن ثورة المعلومات والاتصالات، ولا بد أن يكون الإصلاح شاملاً ومتسقاً من أجل التعامل مع التناقضات والتوترات الناجمة عن التغير الاجتماعي والثقافي. وهنا يمكن ملاحظة أن الدعوات لتغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة ناقصة أيضاً. فليست القضية في تغيير أشخاص أقل كفاءة بآخرين أكثر كفاءة، خصوصاً أن نتائج المؤتمر الاقتصادي الأخير لم تكن على قدر التوقعات المرجوة منه، ولم تشتبك مع الواقع ومشكلاته ولم يتحرر التفكير الاقتصادي بعد من أسر المدرسة النقدية التي أثبتت فشل تحليلاتها حتى في الولايات المتحدة.
ولم تعكس نتائج المؤتمر تغيرا في الفكر، رغم إدراك المشاركين في المؤتمر الأخير لطبيعة التحديات التي تواجهها مصر ورغم وضوح الهدف الرئيسي وهو إحداث تحول هيكلي جذري في الاقتصاد المصري كي يصبح اقتصادا انتاجياً قادراً على تحصين مصر في مواجهة التقلبات الناجمة عن الأزمات العالمية الكبرى على النحو الذي أكدته أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من نتائج اقتصادية ثم الحرب الروسية الأوكرانية. والبرنامج المطروح يتطلب نهجا جديدا ومغايرا يستجيب لأولويات الشرائح الاجتماعية الأوسع ويحتاج إلى حوار مجتمعي من أجل ترشيد الاستهلاك لتقليل فاتورة الاستيراد، ويحتاج إلى ترتيب آخر للأولويات وإصلاح هياكل الضرائب والأجور وزيادة وحماية ناجعة للمستهلكين في وتنظيمهم من أجل التعامل مع زيادات الأسعار الناجمة عن جشع التجار، وهي أمور لا يمكن تحققها إلا من خلال برنامج مواز للإصلاح السياسي والانتقال للديمقراطي على نحو يسمح بتوفير آلية سليمة لترتيب أولويات المجتمع.
أخيراً، لا بد من الانتباه إلى أن الشروع في هذا الإصلاح السياسي والاجتماعي وتغيير الفكر لم يعد ترفاً، وإنما قد يكون صمام أمان ضروريا للتمكين من التعامل مع أي نتائج غير متوقعة مترتبة على وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي تحدث تغييرات جوهرية في بنية المجتمع وفي الاقتصاد السياسي للحكم في مصر..
--------------------------------
بقلم: أشرف راضي