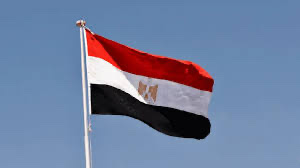* إزاحة الشعارات الأصلية للثورة لصالح شعار النخب السياسية وإزاحة وثيقتي "الأزهر" الأولى والثانية من الذاكرة
يحتفل المصريون بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير كل عام، تخليداً لذكرى 50 شهيدا من ضباط وأفراد الشرطة سقطوا في ذلك اليوم في عام 1952، في معركة من معارك الكرامة ضد بطش سلطة الاحتلال الإنجليزي في مدينة الإسماعيلية، بعدما رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم واخلاء مبنى المحافظة وتسليمه للبريطانيين.
وأقدمت سلطة الاحتلال على ذلك بسبب مزاعم بخصوص دعم الشرطة للمقاومة الشعبية المسلحة ضد الجنود البريطانيين، الذين سقطت شرعية تواجدهم في منطقة القناة، بعدما ألغت حكومة الوفد بزعامة مصطفى النحاس، في 7 أكتوبر 1951، معاهدة عام 1936، و"معاهدة الحكم الثنائي للسودان" الموقعة عام 1899 مع بريطانيا، ودعمت الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية. لقد أراد الشعب بالاحتفال بهذا اليوم، الذي لم يصبح عطلة رسمية إلا في عام 2009، تأكيد تقديره للشرطة التي انحازت للشعب ودورها في الدفاع عنه وتدعيم حقوقه المشروعة.
غير أنه أصبح لذلك التاريخ دلالة أخرى بعد انتفاضة الشعب دفاعاً عن الحرية والكرامة الإنسانية في 25 يناير 2011، والتي أطلقت شرارة الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك لتفتح الباب لتغيير جرى تجميده خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين. وأعادت الأحداث اللاحقة للانتفاضة تطلعات الشعب إلى إصلاح وتصحيح يعيد للشرطة دورها كهيئة لفرض القانون وحفظ النظام العام، وهي التطلعات التي حظيت بتأييد الجيش وقيادته لهذه التطلعات ودعمها، لكن هذا التأييد وذلك الدعم لن يتحقق إلا بعد أن يحصل المصريون على استحقاق دستوري طال انتظاره، منذ ثورة 1919. وغياب هذا الاستحقاق هو مبرر قوي لافتراض أن ثورة يناير 2011 هي امتداد تاريخي لثورة المصريين في عام 1919، للمطالبة بالدستور والاستقلال.
وفي ظل هذا غياب التقاليد الدستورية وترسخها في المجتمع، نتيجة للتعديلات التي تكرس من وضع السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم التحرك للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، أو إجراء إصلاحات تشريعية تنقي منظومة القوانين المصرية التي تتعارض مع بنود الدستور أو مع المواثيق والعهود الدولية التي وقعتها مصر خاصة فيما يتعلق بمنظومة الحقوق، فإن العلاقة بين الأضلاع الثلاثة لمعادلة الوطن: الشعب والجيش والشرطة، ستظل مختلة.
استحقاقات دستورية مؤجلة
تتلخص الفكرة الجوهرية في الحكم الدستوري، الذي هو قاعدة أي نظام ديمقراطي، في تقييد سلطات الحاكم كي لا تطغى على حساب الشعب، مصدر السلطة ومانحها وصاحب الحق الأصيل في السيادة. ويتفق في هذا الرأي المنادون بنظرية السيادة الشعبية وكذلك المناصرون لنظريات الحكم الديمقراطي الأخرى، بما في ذلك الديمقراطية الليبرالية التي تضيف مبدأ حماية الأقليات وحقوقها من استبداد الأكثرية.
غير أن الالتفاف على هذا الجوهر الدستوري بعد ثورة 25 يناير 2011، بتوافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، بالإبقاء على دستور 1971 بما ينطوي عليه من انحياز قوي للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، ورفض إعداد لجنة لوضع دستور جديد يستجيب لمطالب الشعب والأوضاع الجديدة التي كانت القوى المشاركة في الثورة تسعى لفرضها والاكتفاء بإدخال تعديلات لا تمس جوهر الدستور وطرحها لاستفتاء عام في مارس 2011.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قبلت الجماعة التي كانت تسيطر مع حلفائها على المجلس التشريعي بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو 2012، رغم الرفض الشعبي الواسع له، ثم التراجع عن هذه الخطوة لاحقاً، بإصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريٍا آخر في 22 نوفمبر 2012، قوبل أيضا برفض شعبي واسع النطاق، وأحدث أزمة سياسية انتهت بالإطاحة بمرسي وحكم الإخوان المسلمين بعد انتفاضة جماهيرية واسعة النطاق في 30 يونيو 2013، ومهدت المعارضة الشعبية الواسعة لاتخاذ إجراءات أسقطت دستور 2012، الذي أعده المجلس التشريعي الخاضع لسيطرة الإخوان والأحزاب الإسلامية المتحالفة معه والذي تضمن بنوداً تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان الطبيعية والمكتسبة. وجرى تصحيح هذا الوضع بتشكيل لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، الذي كان أكثر توازناً، مقارنة بدستور 2012.
تضمن دستور 2014الجديد بنوداً مهمة تؤسس لجمهورية جديدة، لكن لم يتم الوفاء بكثير من الاستحقاقات التي تضمنتها تلك البنود، كما أن إدخال تعديلات على بعض مواد الدستور، في عام 2019، لا تساهم في ترسيخ مبدأ الحكم الدستوري واحترامه في الثقافة السياسية العامة. كذلك، فإن استمرار اختلال التوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، لصالح السلطة التنفيذية، من شأنه ألا يضمن تحقق مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة، أساس الحكم الدستوري، وهو أيضا الآلية الأساسية لممارسة الديمقراطية، فضلا عن تعثر مسيرة الإصلاح التشريعي الذي يضمن توافق القوانين السارية مع المبادئ التي أقرها الدستور.
وعلى الرغم من الحرص على ضمان التمثيل المتوازن للقوى المختلفة في تشكيل لجنة الخمسين، إلا أن اللجنة لم تٌمنح الفرصة لبناء توافق عام يشكل أساساً للدستور الجديد، كذلك لم يجر الالتفات للجدل الذي فجرته معركة الدستور في أعقاب 2011، بخصوص المبادئ فوق الدستورية التي تضمنتها وثيقة الدكتور علي السلمي، وجاءت بنود الدستور على الأرجح كاستجابة لضغوط القوى الاجتماعية والسياسية وكذلك هيئات الدولة التي شاركت في وضعه، مما أدى إلى كثير من المشكلات التي قد تستدعي إدخال تعديلات أخرى، دعت إليها بعض القوى لكن لم يتسن طرحها أو تمريرها في تعديلات 2012، لا سيما تلك المواد التي تحصن شخصيات تشغل مناصب محددة في الدولة.
إن المضي قدماً في الإصلاحات السياسية المرجوة، يستدعي إزالة قدرٍ لا بأس به من اللبس في الدستور الحالي، فيما يخص تنظيم العلاقات بين مؤسسات الدولة وهيئاتها ويحقق التوازن فيما بين القوى المختلفة. ونُشير تحديداً في هذا الصدد إلى: تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، من ناحية؛ وتنظيم العلاقة بين الدين والدولة، أو العلاقة بين الدين والسياسية بشكل عام، من ناحية ثانية؛ وأخيراً تنظيم العلاقات المدنية العسكرية. وهذه الجوانب الثلاثة، معاً هي الأساس الذي تُبنى عليه الدولة المدنية الحديثة، وهو المطلب الذي توافقت عليه القوى المشاركة في وضع الوثيقة الأولى مما عرف بوثائق الأزهر، في أعقاب 2011.
ثورة من أجل الحرية والكرامة
على الرغم من شيوع الاعتقاد بأن الشعار الرئيسي للانتفاضة الجماهيرية في يناير 2011، هو "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، إلا أن هذا الشعار لم يكن من الشعارات التي تم ترديدها في بداية الحراك الجماهيري الذي أعطى للثورة مضمونها الجوهري كثورة مدنية ديمقراطية لها مطالب سياسية واضحة ومحددة، تتمثل في وضع حد لممارسات أجهزة الأمن التي تنتهك الكرامة الإنسانية، وتدعو كذلك إلى إنهاء القيود على المفروضة على الحريات الأساسية للمواطنين. وعليه، فإن الشعارات الأصلية التي صاحبت الحراك الجماهيري واسع النطاق في بداياته، كانت تسمو بمطالب الشعب ولا تحصرها في المطالبة باحتياجات أساسية يفترض من أي دولة توفيرها وإلا أدرجت في فئة الدول الفاشلة. وفي مقدمة هذه المطالب مطلب "العيش" أي "الخبز"، أو "المأكل"وهو من الاحتياجات الأساسية التي يتعين على المجتمع والدولة إشباعها للمواطنين، وفقا لمواثيق الأمم المتحدة، لاسيما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والتي يقيس النجاح أو الفشل في إشباعها نجاح الدول والمجتمعات أو فشلها.
إن الانتقال من شعارات "الحرية" و"الكرامة الإنسانية" ومن شعار "ارفع رأسك فوق أنت مصري" إلى شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" الذي يعبر عن حالة التردي في الخطاب والوعي والأفق السياسي المسيطر على خطاب "الطليعة" أو "النخب" السياسية، وفشلها إلى صياغة شعارات تعبر عن الأفق التاريخي والوعي الحضاري للجماهير المنتفضة، الذي كان سابقاً، رغم عفويته، على النخبة في بلورة الأشواق والتطلعات التي كانت بمثابة المحرك الرئيسي للقطاعات العريضة التي شاركت بعفوية، في الانتفاضة الجماهيرية الكبرى، والتي تمسكت بتحقيق المطلب المشترك الذي التف حوله الجميع، رغم تباين المواقف والمصالح والأهداف، المتمثل في وضع حد لممارسات مبارك ونظامه، ولم تتزحزح عن مكانها قبل تحقيق هذا المطلب.
لم تسقط الجماهير، في حراكها الثوري في يناير 2011، حكم مبارك فقط وإنما أسقطت معه أحلام توريث الحكم والسلطة في مصر، وكان تطمح إلى تجديد الشراكة بين الشعب والجيش على أسس جديدة تفتح الباب أمام عصر جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة تقوم على الدستور وحكم القانون وديمقراطية الحكم ، وتصحح الخلل في العلاقة الدولة بالمجتمع لإعادة تنظيم العلاقات المدنية العسكرية والعلاقة ما بين الدين والسياسة.
وحاولت الوثائق التي جاءت كثمرة للحوار بين النخب الثقافية والسياسية المختلفة الذي استضافه الأزهر أن تعبر عن تطلعات والشعب وتسعى لتأسيس توافق عام على مستوى طليعته والأجنحة المختلفة في النخبة الفكرية والسياسية. وصدرت وثيقتان في غاية الأهمية حملت اسم الأزهر، وكان من المفترض صدور وثيقة ثالثة عن الأسرة وحقوق المرأة لكن التطورات السياسية وموازين القوى أحبطت هذا المسعى وحالت دون صدور تلك الوثيقة.
ومثلما جرت إزاحة الشعارات الأصلية للثورة لصالح شعار النخب السياسية المسيطرة على المشهد، أزيحت أيضا وثيقتا "الأزهر" الأولى والثانية من الذاكرة، ولم تحظ بالاهتمام الواجب باعتبارها تبلور الأساس الذي يمكن من خلاله التوصل لتوافق عام تأسيسي وتحدد بوصلة للمستقبل الذي يتطلع إليه السواد الأعظم من المصريين.
من المهم مع تجدد ذكرى الثورة المصرية العظيمة، وبعد مرور 12 عاماً، أن نعيد التفكير والنظر والبحث ووضعها في ميزان اللحظة قبل الحكم عليها بميزان التاريخ.. علينا أن نحدد ما هي الفرص التي ضاعت أو أهدرت، وكيف كان يمكن لهذه الفرص لو أُحسن استغلالها ان تغير وجه مصر وأن تحقق للمصريين "مصر الأخرى" التي لا تزال حلما لم يغادر بعد رؤوسهم؟ والعنوان الرئيسي لهذا الحلم هو كيف يتم الوفاء باستحقاقات دستورية طال انتظارها؟ وهو سؤال يستحق منّا التفكير والتوصل إلى إجابات.
-----------------------------------
بقلم: أشرف راضي