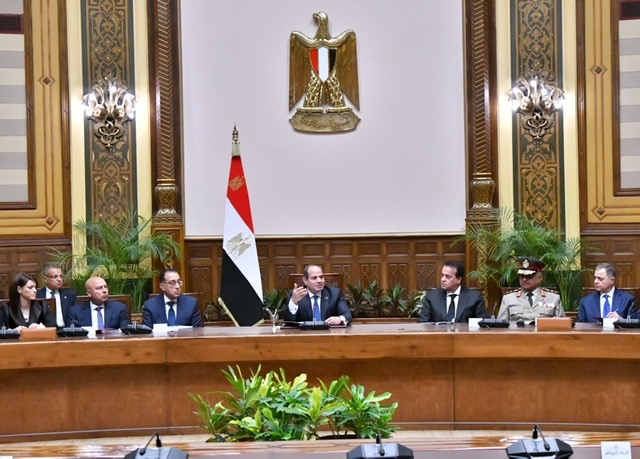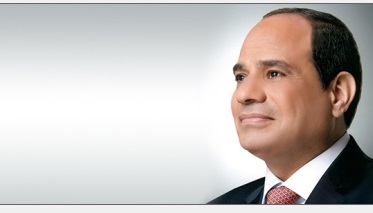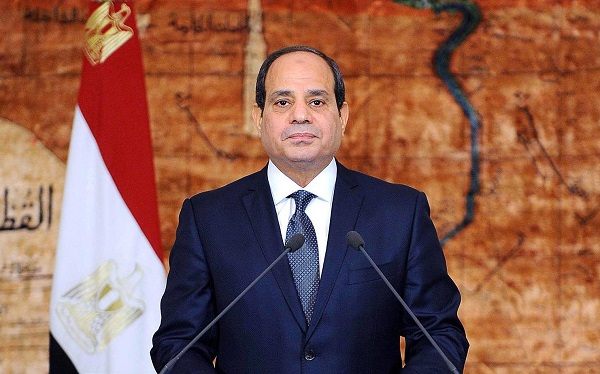خلال الأيام الأخيرة أصدرت مؤسسة "موديز" العالمية للتقييم الائتماني تقريرا خفضت فيه درجة الجدارة الائتمانية للحكومة المصرية (التقييم السيادي)، ثم ألحقته بتقرير ثان خفضت فيه درجة الجدارة الائتمانية للبنوك الرئيسية. تخفيض الجدارة الائتمانية سواء السيادية أو التجارية يعني تضييق الدخول لأسواق رأس المال، وزيادة تكلفة الاقتراض، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية خصوصا الاستثمار في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك فإنه "موديز" بعدما وازنت بين تهديدات المخاطر وبين فرص المقاومة والقدرة على التحمل، إنتهت بإرفاق تخفيض الجدارة الائتمانية مع تحسين النظرة المستقبلية السيادية والتجارية إلى "مستقرة" بدلا من "سلبية"، وهو ما يقلل ثقل الضغوط المباشرة، ويمنحنا الكثير من الأمل في تجاوز الوضع الصعب الذي نحن فيه، باعتباره "مجرد عثرة مؤقتة" كما جاء في التقرير.
ومع أن كثيرين اهتموا بالتقريرين، فإني أحب أن أوضح أن الاهتمام انصب على تخفيض التصنيف، بدون تأمل الأسباب التي أدت إليه، والآليات التي يمكن أن تساعد على إعادته للمسار الإيجابي، أي إلى تحسين درجة الجدارة الائتمانية، وهو لا شك ما نريده ونسعى إليه. وأظن أن دراسة التقريرين، وليس مجرد قراءتهما، هو مسؤولية أجهزة صنع السياسة النقدية والمالية، لأن ما ورد فيهما من ملاحظات هو يتعلق بدورها الاستراتيجي ووظائفها اليومية. كما أن التفاصيل التي وردت في التقرير السيادي تحتاج إلى عناية كاملة من الحكومة، لأن فيها الكثير مما يعيب عملها، خصوصا تصنيف مدى كفاءة ورشادة الإدارة الحكومية، الذي يعد الأسوأ من بين الأسباب غير المباشرة التي تحيط بتخفيض درجة الجدارة الائتمانية السيادية.
وسوف أتناول هنا نقطتين تخصان تقرير التصنيف الائتماني السيادي، ونقطة واحدة تخص تقرير تصنيف البنوك. النقاط الثلاثة، الأولى منها تتعلق بعبء سداد الديون، والثانية تتعلق بالحاجة إلى الاستثمار الأجنبي، أما الثالثة الخاصة بالبنوك، فهي تتعلق بسلامة النظام المصرفي نفسه، وكنت قد نبهت إلى ذلك في رسائل سابقة منذ أواخر السنة الماضية.
أولا: عبء سداد الديون
تقدر موديز قيمة عبء خدمة الديون المستحقة السداد في السنتين الماليتين 2024 و 2025 بحوالي 69.6 مليار دولار، منها 26 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، و 43.6 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل (20.4 مليار دولار عام 2024، و 23.2 مليار دولار عام 2025). هذا العبء يتضمن أقساط وفوائد الدين الخارجي، وليس الفوائد فقط كما يفضل السيد الدكتور وزير المالية أن يحسبها.
وفي تقديري أن الوفاء بأعباء سداد الديون، الخارجية والمحلية وليس تحقيق هدف التنمية، أصبح المحرك الأساسي للسياسة الاقتصادية المصرية. هذا ينطوي على خطورة شديدة، ها نحن نراها أمام أعيننا. وقد طالبنا بسن قانون يضع حدا لسقف الدين العام الداخلي والخارجي، يأخذ في اعتباره القدرة الحقيقية على السداد، ويستهدف أيضا بناء مقومات قوة تحمل للصدمات المفاجئة، وإتاحة هامش للمناورة في أوقات الظروف الطارئة. ولا أظن أن الاقتصاد المصري في وضعه الحالي قادر على الوفاء بأعباء سداد الدين الخارجي المستحقة في العامين القادمين بموارد ذاتية. ومن ثم فإن مصر ستكون مضطرة للاقتراض من جديد من أجل الوفاء بأقساط وفوائد الديون.
تقرير موديز يحذر من ذلك، ويدعو الحكومة إلى استخدام تمويل غير مدين، أي لا تترتب عليه مديونية جديدة. وكانت الحكومة قد قدرت حجم الفجوة التمويلية في السنوات الأربع المقابلة للقرض الأخير الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي (قرض ال 3 مليارات دولار) بحوالي 16 مليار دولار، أي بمتوسط يبلغ 4 مليارات دولار سنويا. الحقيقة أن قيمة الفجوة التمويلية أكبر بكثير، إذا أخذنا في الاعتبار قيمة العجز في الحساب الجاري الذي بلغ في العام الماضي 16.6 مليار دولار.
ومن الملاحظ أن مدفوعات فوائد الديون إستحوذت على حوالي 38% من عجز الحساب الجاري في الربع الأول من السنة المالية الحالية. كما أن علينا أن نتذكر أن خدمة الديون المحلية والخارجية تبتلع حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات وزارتي المالية والتخطيط الوارة في بيان الموازنة. هذا العبء غير مستدام. وقد يصل عمل "العوامل الوقائية"، مثل ارتفاع تكلفة حصول الحكومة على السيولة، أو حتى امتناع البنوك عن إقراضها، إلى أن تعجز عن توفير التمويل الضروري. وحتى لا يجد البعض فيما أقول مبالغة، فإن وزارة المالية تقوم حاليا بتغطية أكثر من من 90% من الاحتياجات التمويلية بقروض قصيرة الأجل من السوق المحلية بفائدة تتجاوز 22%. وطبقا لبيان موازنة العام الحالي، فإن الحكومة كانت تستهدف ملء الفجوة التمويلية المقدرة بقيمة 1523.6مليار جنيه بواسطة تمويل محلي بقيمة 1377.2 مليار جنيه (90.4%) مع زيادة إصدارات السندات لأكثر من نصف الاقتراض المحلي، وتمويل أجنبي بقيمة تعادل 146.4 مليار جنيه (9.6%)، منه سندات دولية بما يعادل 91.5 مليار جنيه (6%) لكن ذلك لم يتحقق.
ثانيا: الحاجة للاستثمار الأجنبي
الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا والصين من أكبر الدول المتلقية للإستثمار الأجنبي، كما أن السعودية ذات الفائض المالي الضخم ترسم الآن خططها الاقتصادية ورؤيتها للمستقبل على أساس جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية. فهل يجوز لنا أن نعتقد أن أكبر الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي في العالم تحصل عليه بسبب العسر المالي، أو لمجرد زيادة القدرة على التمويل؟ كلا .. الإستثمار الأجنبي أصبح وسيلة من وسائل تعزيز الترابط التجاري والتكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم. فالولايات المتحدة دولة مصدرة لرأس المال، كما إنها أكبر متلقية لرأس المال الأجنبي أيضا بشكل عام. الصين تستثمر في الخارج كما تتلقى استثمارات من الخارج. ولذلك فمن المهم عدم الوقوع في خطأ التسطيح والضحالة عندما نتحدث عن الاستثمار الأجنبي. قد تكون له فائدة في لحظة عسر مالي، لكن هذا لا يجب أبدا أن يكون المحرك الأساسي لطلب الاستثمار الأجنبي في الأجل المتوسط والطويل. الاستثمار الأجنبي في جوهره، هو عملية طويلة الأجل ذات طبيعة هيكلية تكنولوجية تنافسية، وليست أبدا قصيرة الأجل لحل أزمة طارئة، أو للمساعدة على الخروج من عسر مالي.
من هذه الزاوية نقول إننا عندما نفتح دفتر الاستثمار الأجنبي، يجب أن نفعل ذلك بعد أن نحدد بالضبط ماذا نريد. ولأننا لسنا في عالم نعيش فيه وحدنا فإننا يجب أن نتعلم من غيرنا. وعندما نختار ممن نتعلم علينا أن نختار من نطمح أن نصعد لكي نجاوره، لا أن ننظر تحت أقدامنا إلى الأقل منا حتى نقتدي به، فالأقل ليس قدوة، ولا يمكن أن يكون. وسوف أضرب المثل هنا بالدولة التي اخترت منذ سنوات أن أجعل من تقدمها الاقتصادي المقياس الذي أحكم به على الأداء الاقتصادي في بلدنا. هذه الدولة هي فيتنام. هي أقرب إلينا في عدد السكان وفي حجم الناتج المحلي، ونحن نتفوق عليها في كل ما عدا ذلك، أو كنا منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.
في العام الماضي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت في فيتنام 4.3% أي ما يقرب من ثلاثة أمثال نسبة التدفقات إلى مصر، علما بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر في السنة المالية الأخيرة شهدت فيضا استثنائيا من الدول الخليجية. وسوف نلاحظ أن أهم المستثمرين الأجانب في البلدين هم من الدول المجاورة: سنغافورة والصين واليابان بالنسبة لفيتنام، والسعودية والامارات وقطر بالنسبة لمصر. لكننا سنلاحظ ملاحظة شديدة الأهمية، ألا وهي أن أكثر من 77% من الاستثمارات الأجنبية في فيتنام تتجه إلى الصناعات التحويلية، وحوالي 9% إلى قطاعات البنية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، بينما يبلغ نصيب الاستثمار العقاري 6% فقط. الصورة في مصر تكاد تكون مقلوبة تقريبا. وحتى إذا استثنينا قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ وحده على ما يتراوح بين 60% إلى 70% من الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والخدمات الصحية والتعليمية والمالية تستحوذ على النسبة الأعظم. ويعلم المواطن الرشيد أن الاستثمار في الصناعة التحويلية وفي القطاعات السلعية الإنتاجية بشكل عام هو أساس خلق الثروة والرخاء والقوة، وما غير ذلك يكتسب قيمته بأن يكون متمما له، وليس قائما بذاته. الأخطر عند المقارنة هو نظرة الحكومة إلى الاستثمارات الأجنبية على أنها وسيلة للخروج من العسر إلى اليسر، وتجاوز حالة التعثر في السيولة.
وحتى ننظر إلى موضوع الاستثمار الأجنبي في سياق صحيح، فإننا يجب أن ننظر إليه من نافذة أخرى غير نافذة الديون. فالغرض الرئيسي للاستثمار الأجنبي هو خدمة النمو، ولا يتحقق النمو بدون زيادة قوة الترابط بين الاقتصاد المحلي والعالم. وتتحقق قوة الترابط بزيادة الصادرات والواردات من خلال اقتصاد مفتوح وليس بالعودة إلى اقتصاد الإنكفاء الذاتي، وأن يحمل الاستثمار الأجنبي معه فرص التحول التكنولوجي، وتدريب قاعدة واسعة من المهارات البشرية، وتوفير سلع وخدمات أعلى مستوى، وتحقيق تنافسية أكبر. أحد شروط الاقتصاد المفتوح هو المرونة الكاملة لسعر الصرف، فالذي تشتري منه أو يشتري منك لا يجب أن يكون معرضا لتغيرات حادة أو مفاجئة في سعر الصرف، لأن ذلك يقلل مستوى اليقين والثقة، وهما أخطر تهديد للنمو والاستثمار. لذلك فإن أحد الشروط الواردة في تقرير "موديز" في جانب العوامل التي يمكن أن تساعد على تحسين التصنيف الائتماني لمصر، هو ضرورة الإلتزام الكامل بمرونة سعر الصرف. هذا متغير رئيسي تراقبه الأسواق الخارجية.
ولأننا نحقق معدل نمو حقيقي ضعيف، يصل في المتوسط إلى حوالي 2% سنويا بعد خصم نسبة الزيادة في السكان، ولأننا لدينا طموح بأن ننضم إلى نادي الدول النامية الصاعدة؛ فإننا نحتاج في حقيقة الأمر إلى تحقيق معدل للنمو يبلغ في المتوسط 7% سنويا، ونحن فعلا نستهدف ذلك.
وقياسا على تجارب النمو السريع في منطقة جنوب شرق آسيا، فإن تحقيق نمو سنوي بنسبة 7% يحتاج إلى استثمارات تعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي. فهل نحن فعلا نستثمر هذه النسبة من الناتج المحلي؟ الإجابة هي لا. نحن في واقع الأمر نستهلك ما يقرب من 95% من الناتج المحلي الاجمالي، وندخر حوالي 5%. ومن ثم فإن الاستهلاك وليس الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو. وتكتمل المأساة عندما نعلم إننا نقوم بتمويل الاستهلاك بالاستدانة من الخارج. ونظرا لضآلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن معدلات الاستثمار في مصر متواضعة جدا، كما إنها تنحدر لأدنى مستوياتها في الصناعة التحويلية وقطاعات الإنتاج السلعي.
وإذا أردنا تحقيق معدلات نمو صحية، فسيكون علينا استهداف استثمارات أجنبية في قطاعات الإنتاج السلعي أساسا يتراوح بين 5% إلى 6% ولا تقل أبدا عن 4% من الناتج المحلي، مع رفع معدل الادخار المحلي إلى 20% من الناتج الإجمالي عند أقل تقدير. هذا بالقطع لن ولا يمكن أن يحدث مرة واحدة، ولذلك فقد استخدمنا لفظ "استهداف"، مع وضع خطة عملية لتحقيق ذلك، تمهيدا لرفع معدل الاستثمار الكلي (المحلي والأجنبي) إلى 35% من الناتج المحلي. جذب استثمارات أجنبية بنسبة 5% من الناتج المحلي يساوي حوالي 20 مليار دولار في السنة، أي 100 مليار دولار في خمس سنوات، وهو الرقم الذي أعلن الرئيس السيسي في مدينة السادات أننا بحاجة إليه خلال السنوات الخمس المقبلة. الرئيس إذن حدد الرؤية إلى الاستثمار الأجنبي، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، التي هي من اختصاص الوزراء المسؤولين عن النشاط الاقتصادي.
لا يجب أن تتحول الحاجة إلى 100 مليار دولار الى مجرد هدف منفصل عن مضمونه وهو تحقيق الاستثمار، ولا يجب أن تكون هذه الأموال لسداد الديون أو تمويل الاستهلاك. وإذا انفصل الرقم عن الغرض منه فإنه سيتحول إلى عبء إضافي يعجز الاقتصاد عن تحمله. السيد الرئيس تحدث أيضا عن فجوة تجارية بقيمة 30 مليار دولار، ونحن نعرف أن سد هذه الفجوة لن يكون بغير زيادة الصادرات، وليس بالإنكفاء الذاتي، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية للتصنيع تستهدف ليس كفاية السوق المحلية، ولكن زيادة تشابك قطاع الإنتاج مع سلاسل الإمدادات العالمية.
ثالثا: سلامة النظام المصرفي
كتبت في هذا المكان محذرا أكثر من مرة، وأعدت صياغة التحذير في سياقات مختلفة، وقلت أن سلامة النظام المصرفي المصري خط أحمر لا ينبغي الاقتراب منه. الآن، وبعد تخفيض درجة الجدارة المالية للبنوك التجارية الرئيسية في مصر أقول إننا اقتربنا فعلا من الخط الأحمر، ويجب أن نفكر بجدية في دلالات هذا التقرير. البنوك، خصوصا الحكومية، تتعرض لضغوط إدارية وغير إدارية فيما يتعلق بإتاحة السيولة للحكومة. للرد على هذه الضغوط يجب أن نحترم استقلالية البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن نحترم المعايير المهنية والفنية في إدارتها. ذلك أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي والتجاري يعني بالنسبة للحكومة والبنوك تخفيض فرص الحصول على الائتمان، وارتفاع تكلفته، وانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي.
ونتوقع أن ينعكس تخفيض الجدارة الائتمانية للبنوك بشدة على سوق الأوراق المالية الحكومية في الأسبوع القادم، بارتفاع أسعار الفائدة على اذون الخزانة، مع استمرار الحذر الشديد إزاء السندات، وربما الإستمرار في الإمتناع تقريبا عن تمويلها. كذلك فإن البنوك أصبحت تواجه هي الأخرى مخاطر انخفاض السيولة. ومع أن ودائع العملاء ما تزال داخل الحدود الآمنة في الوقت الحاضر، لكنه يتعين على البنوك تخفيض انكشافها على سوق الديون الحكومية. وهذه معضلة كبيرة لأن البنوك تستخدم حوالي 50% من السيولة القابلة للاقراض في سوق الأوراق المالية الحكومية، مقابل ما يتراوح بين 20 - 25% في إقراض القطاع الخاص، كما جاء في تقرير "موديز". تعقيدات خدمة الدين العام، والحاجة للاستثمار الأجنبي وسلامة النظام المصرفي، هي ثلاث قضايا متشابكة، يتعين على الحكومة أن تعطيها كل اهتمامها.
---------------------------
بقلم : د. إبراهيم نوار
خبير اقتصادي
(المقال نقلا عن صفحة الكاتب على فيس بوك)