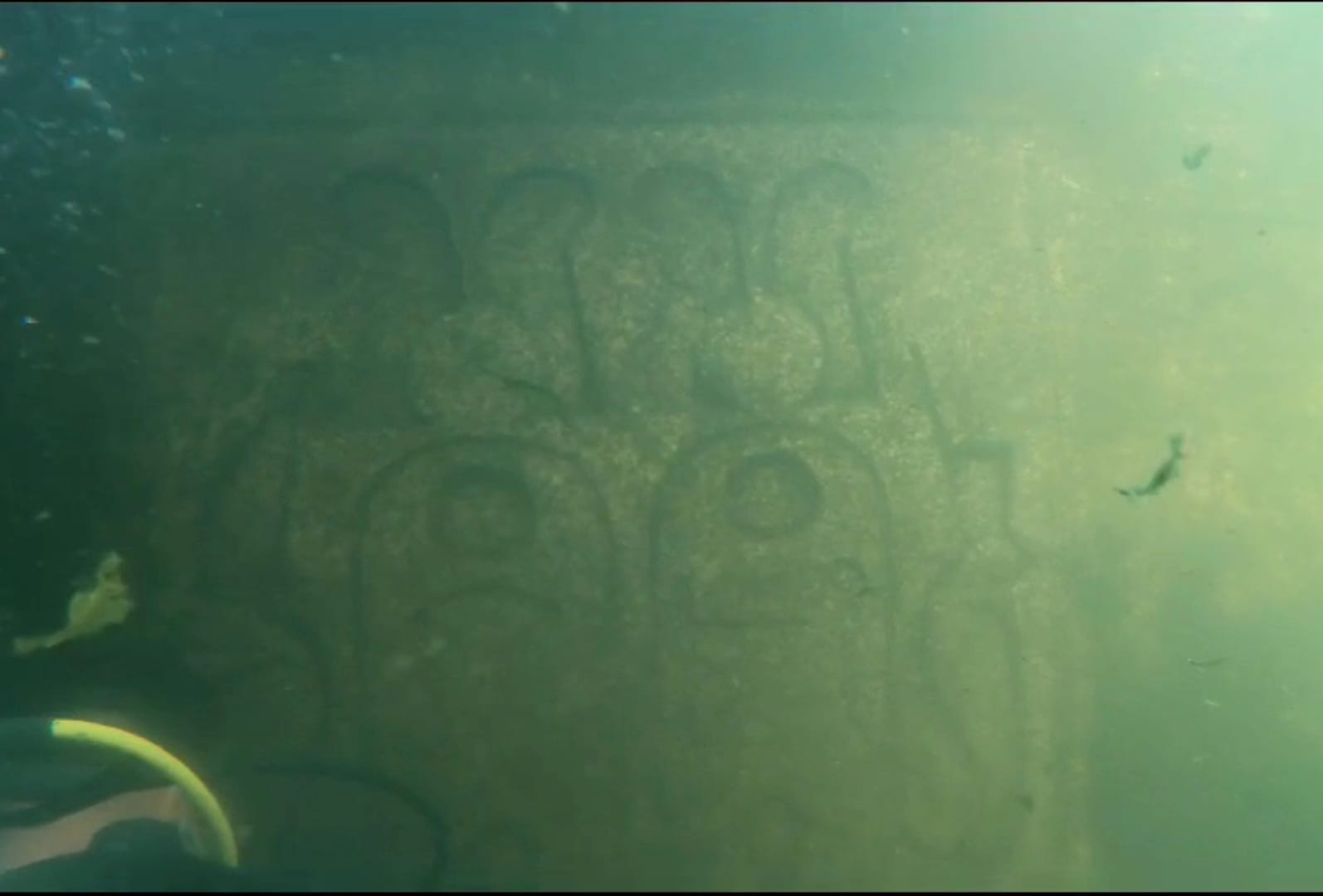- العوامل التي كانت تضع مصر على حافة المجهول قبل 15 عاماً، لا تزال قائمة وعلى نطاق أوسع وأكثر حدة
- الاختيارات السياسية والاجتماعية والاستراتيجية للسلطة الحاكمة لا تعكس إدراكاً للمخاطر ولا تعمل على تأهيل المجتمع لمواجهتها
- لم تتعلم السلطة الحالية درس 25 يناير وهي تظل ضعيفة وهشة في مواجهة الضغوط الخارجية إن لم تستند على مجتمع قوي قادر على حماية مصالحه والدفاع عنها
- انتخابات الرئاسة ومن قبلها الحوار الوطني فرصتان ضائعتان وأصبحنا أمام مشهد هزلي لانتخابات هي أقرب للاستفتاء منها لانتخابات تنافسية
مع بدء الاستعداد لإجراء انتخابات الرئاسة في مصر، قبل شهور من موعدها المقرر، تعلو الرهانات في دوائر التحليل السياسي وفي الدوائر الحزبية والسياسية حول مستقبل مصر في ظل تغيرات إقليمية ودولية، سيكون لها انعكاسات كبيرة على أوضاعنا الداخلية وعلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هذه التغيرات تضع مصر، شعبا ودولة، أمام خيارات صعبة ومصيرية، سواء بقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنصب أو جرى تغييره بإرادة الناخبين، وهو احتمال وارد، ولو بنسبة ضئيلة، فالانتخابات يصعب التنبؤ بنتيجتها مسبقاً وهي عرضة للتأثر بمتغيرات شتى، حتى لو كان الانطباع السائد أنها انتخابات مدارة ونتيجتها معروفة سلفاً.
في كل الأحوال فإننا أمام تحديات تطرح خيارات تتطلب تغييراً جذريا في السياسات وفي التوجهات، ولا عبرة هنا بتغيير الوجوه والأشخاص، فالتغيير المنشود لن يحدث إذا بقيت السياسات وتغيرت الوجوه، فهو مرهون بتبني سياسات بديلة جديدة، وإن بقيت الوجوه القديمة. المهم أن يكون هناك إدراك لضرورة التغيير ومضمونه وأن تكون هناك إرادة لإحداثه، ومن المهم أيضاً إدراك أن مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات في البيئة الإقليمية والدولية، وكذلك التغيرات الاجتماعية المتسارعة في الداخل مستحيلة بدون تغيير السياسات الراهنة التي تعمق الأزمة وتزيد المشكلات التي نعاني منها تعقيداً.
لست من أنصار "نظرية المؤامرة" التي يروج لها البعض، سواء في السلطة أو في المعارضة. ورغم تركيز الخطاب السياسي، لاسيما خطاب السلطة، على المخاطر المحيطة بمصر وعلى دورها الذي يجري تضخيمه في التصدي لهذه المخاطر، إلا أن التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وتراكم الديون الخارجية والدين الداخلي، والتهميش المتزايد للقوى الاجتماعية الناجم عن احتكار النشاط الاقتصادي، والإهدار المستمر للموارد، وفي مقدمتها الموارد والطاقات البشرية، وكلها أمور ناتجة عن الاختيارات السياسية والاجتماعية والاستراتيجية للسلطة الحاكمة، والتي لا تعكس إدراكاً للمخاطر ولا تعمل على تأهيل المجتمع لمواجهتها، بل تصر على حرمان المجتمع من الأدوات اللازمة لمواجهتها بحرمانه من موارده السياسية، وفي مقدمتهاالقدرة على تنظيم صفوفه. ولم تدرك النخب التي تعاقبت على حكم مصر على مدى عقود، فبما يبدو، أن إضعاف المجتمع وإخضاعه يحد من قدرته على مقاومة العدوان الخارجي والدفاع عن مقدراته، وأن السلطة التي لا تستند على مجتمع قوي قادر على حماية مصالحه والدفاع عنها وتنظيم صفوفه، هي سلطة ضعيفة وهشة في مواجهة الضغوط الخارجية، ولا تجد سبيلا لاستمرارها في الحكم سوى تقديم تنازلات مقابل حماية القوى الكبرى وتأمين دعمها في مواجهة الضغوط الداخلية. ولم تتعلم السلطة الحالية درس 25 يناير 2011، على الأرجح.

على حافة المجهول
كي نضع الأمور في نصابها، علينا أن نعود إلى لحظة فارقة في تاريخ مصر وهي لحظة سابقة على ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت محاولة لتصحيح الأوضاع وإنقاذ الوطن. كانت مصر في ذلك العام الذي شهد انتخابات عامة، هي الأسوأ في تاريخها، تقف على حافة المجهول، بتعبير المحلل السياسي الراحل مصطفى الحسيني، الذي قدم تحليلا للوضع في مصر مع نهاية العقد الأول من الألفية. فداخليا كانت مصر على شفا انهيار يتجاوز انهيار النظام العام وما يصحبه من غياب للقانون وانتشار الفوضى، إلى انهيار شامل للدولة الذي يتجسد في غياب مفهوم الجماعة الوطنية والهوية المشتركة التي تربط بين أبناء المجتمع؛ وهناك مسألة "الاستقلال الوطني" وحدوده التي تتجلى بوضوح في حرص الحاكم على تأمين رضا القوى الكبرى في الإقليم والعالم، ولو على حساب مصالح الغالبية العظمى من المصريين الذين يجري تهميشهم؛ وهناك انفصال تام عن الواقع عبر عنه الإصرار على إنكار التغيرات الحادثة في المجتمع ورفض التكيف معها، ووضع معوقات تحول دون حدوث التغيير الضروري؛ والسير بخطى متعثرة على طريق الإصلاح، خشية أن يقود هذا الإصلاح إلى تغيير. والعوامل التي كانت تضع مصر على حافة المجهول قبل 15 عاماً، لا تزال قائمة وعلى نطاق أوسع وأكثر حدة. وتكفي نظرة سريعة على عدد من التطورات التي شهدناها في الآونة الأخيرة.
استبقت انتخابات الرئاسة المزمعة، تطورات خطيرة على الساحة الإقليمية، من المنتظر أن تكون لها آثار بعيدة المدى على أوضاعنا الداخلية، ويتطلب التعامل معها تغيير الصيغة التي فرضتها السلطة طوال السنوات العشر الماضية، كما ينتظر أن تشهد المنطقة تغيرات أخرى تُفرض خلالها تسويات من شأنها توسيع رقعة الصراعات الممتدة منذ عقود لنكون أمام صيغة أخرى "لسلام ينهي أي سلام"، وهي الصيغة التي تأسست عليها الدول في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب الحرب العالمية الأولى خلال السنوات الخمس ما بين 1917 و1922، والتي ورثتها النخب التي حكمت دول المنطقة في مرحلة ما بعد الاستعمار. لكن هذه التطورات تشير أيضاً إلى أن ما كان مجهولاً بالأمس بات الآن معلوماً وواضحاً واستيقظنا على مخاطرٍ تنبئ بكارثة وتحتاج منا إلى خطط عاجلة للتصدي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
في السابق، كان حكّام دول المنطقة يحسدون حكّام مصر لأنهم مهما ارتكبوا من أخطاء فلن تتأثر مصر، بينما أي خطأ يرتكبونه هم قد يؤدي إلى ضياع أوطانهم. اليوم، لم تعد مصر استثناءً ولم تعد تتحمل ترف الاطمئنان إلى أن وضعها مستقر مهما حدث. يكفي استعراض سريع لثلاث قضايا حاسمة ومصيرية بالنسبة لمصر ومستقبلها.
الملء الرابع وأزمة سد النهضة
التطور الأول تمثل في إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي على النيل الأزرق في انتهاك صريح لإعلان المبادئ الموقع عام 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على "قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في عملية الملء"، وهذا الإعلان يؤكد إصرار أديس أبابا على انتهاج "إجراءات أحادية" تتجاهل مصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي، وتفرض أمرا واقعا يقوض المفاوضات المستأنفة ويفرغها من جدواها. ويُحذر خبراء من أن هذا الملء الرابع يضع مصر على حافة العطش والمجاعة، نظرا لتراجع حصة مصر من المياه التي ترد إليها من النيل الأزرق، مصدر أكثر من 86 بالمئة من حصة مصرمن مياه النيل التي تبلغ 55 مليار متر مكعب، يأتي 48 مليار منها من النيل الأزرق. ويتوقع الخبراء أن تتراجع حصة مصر بشدة نتيجة إصرار أثيوبيا على إعادة توزيع هذه الحصة التي مصدرها أثيوبيا كي تحصل على ثلثها بينما تحصل دولتا المصب، السودان ومصر، على الثلثين. ولم تستطع مصر ولا السودان ولا حتى الولايات المتحدة دفع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للالتزام بإعلان المبادئ وحقوق مصر والسودان المكتسبة في مياه النيل. وركزت وثائق بريطانية بخصوص مياه النيل على الافتقار إلى قواعد منظمة في القانون الدولي، الأمر الذي يضعف الموقف المصري ويحد من الاختيارات المتاحة أمام مصر.
لم نصل بعد إلى وضع العطش أو المجاعة، الذي يضع القيادة في مصر في موقف صعب، إذ ستكون مطالبة بتحرك، لاسيما بعد تأكد أن أسلوب التفاوض الذي أصرت عليه لم يكن مجدياً لمواجهة التعنت الإثيوبي. وخلصت وثيقة للخارجية البريطانية في عام 1990، إلى أن مصر "لن تقبل أن تكون رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي". المشكلة أن الخيارات الأخرى المتاحة أمام مصر محدودة، فالتوجه إلى التحكيم الدولي، عبر تشكيل محكمة دولية خاصة بموافقة طرفي النزاع، مستبعد لرفض إثيوبيا اللجوء للتحكيم، كما ترفض الوساطة الرباعية الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي، كذلك، فإن خيار الانسحاب أو التهديد بالانسحاب من إعلان المبادئ أو الانسحاب منه، خطوة لا تكفي بذاتها. كذلك تتضاءل فرص الخيارات العسكرية للتعامل مع أزمة السد وتقليص حصة مصر من مياه النيل الأزرق.
قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام مصر هو البدء في مفاوضات متعددة الأطراف للتوصل إلى "معاهدة إقليمية شاملة" تحظى بدعم الدول المجاورة والقوى الكبرى، بما يتفق مع اقتراح شمعون بيريز رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي الراحل "إقامة نظام إقليمي" للمياه في المنطقة يمكن من خلاله التخطيط وتنفيذ مشاريع تنمية المياه وتوزيع المياه على أساس اقتصادي "بأسلوب عادل ومؤتمن" ، وبعيدا عن مسألة حق إسرائيل في مياه النيل من عدمه، فمن المؤكد أن الساسة الإسرائيليين خططوا لهذا المسار منذ عقود وعملوا على حشد التأييد الدولي والإقليمي له، كما عملوا على إنضاج البيئة السياسية الإقليمية كي ينشأ تعاون إقليمي بخصوص المياه في المنطقة. بينما لم يفعل المصريون شيئا لتوسيع الخيارات المتاحة أمامهم لحماية الحقوق المكتسبة تاريخياً، ولم تفعل شيئا في اتجاه الحلول الأبعد مدى والعودة لتراث وزارة الري المصرية القائم على فكرة تأمين المياه من خلال إقامة مشروعات للتنمية والترشيد على طول المجرى. الأمر المؤكد أن الوضع الذي وصلنا إليه في هذا الملف لم يعد يحتمل ترف وضع الملف في يد السلطة وأن تقف بقية القوى السياسية والاجتماعية مكتوفة اليدين.

الممر الاقتصادي ومخاطر إقليمية
التطور الثاني الذي قد ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة لمصر، ما لم نفكر في كيفية التعامل معه والاستفادة منه، هو الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا عبر منطقة الخليج والشرق الأوسط الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي يوم التاسع من سبتمبر. وأثار الإعلان عن هذا المشروع جدلاً كبيراً في مصر حول تأثيراته على قناة السويس، وهو جدل في غير محله، لسببين: الأول، أن الهدف الأساسي المتفق عليه لهذا المشروع هو إيجاد بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، ويواكب هذا المشروع نقل استثمارات الشركات الأمريكية والأوروبية الهائلة من الصين إلى الهند، والثاني، أن حركة التجارة المتوقع أن تنشأ عن هذا التحول وكذلك نتيجة لمشروعات الحزام والطريق ستكون ضخمة إلى حد لا تقوى قناة السويس على استيعابه كما أن حصتها من هذه الحركة كممر تجاري بحري لن تتأثر كثيرا والأرجح أنها ستنمو.
لكن تظل هناك مخاطر كبيرة لهذا المشروع الذي سيغير من البيئة الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة إلى حد يتجاوز الإضرار بالمصالح المصرية وحدها، وإنما بمصالح المنطقة. فإلى جانب الالتفاف على مبادرة الحزام والطريق، توجد مبادرة الممر الهندي قاعدة لبناء تحالف بين حكومتين يمينيتين متطرفتين في الهند وفي إسرائيل، لهما طموحات توسعية وإمبراطورية في المنطقة، وأنها ستسخر رؤوس الأموال والموارد الهائلة في منطقة الخليج في خدمة هذا المشروع الإمبراطوري وتزيد من تهميش مراكز القوى في المنطقة العربية لتصبح سيطرة الهند وإسرائيل على دول الخليج العربية سهلة.
لا شك في أن إدارة الحكومات المصرية المتعاقبة للعلاقات مع دول الخليج مسؤولة إلى حد بعيد عن هذا الوضع الذي سعى الخصوم للاستفادة منه وتوظيفه. قد تعزز هذه التطورات حجج أنصار نظرية المؤامرة في مصر، وهنا يجب التنبيه إلى أن أحد المثالب الأساسية في نظريات المؤامرة إنما تكمن في التنصل من المسؤولية عما يحدث، بإلقاء اللوم على القوى الخارجية المتربصة التي تتآمر على مصر وشعبها، والخطر الثاني الكامن في هذه النظريات هو الاعتقاد بالنجاح الحتمي لهذه الخطط، وكأن ليس في أيدينا شيئا نفعله فنستسلم لما يجري الترتيب له وتدبيره.
وإذا لم نواجه حقيقة أننا اتبعنا نهجاً خاطئاً في التعامل مع الأشقاء في الخليج واستهداف أموالهم دون اهتمام بجذب استثماراتهم في مشروعات تعود بالنفع على الغالبية العظمى من المواطنين وتوفر فرص عمل وتضيف إلى ثروات المستثمرين وثرواتنا، وبدلا من السعي لحل الخلافات والمشكلات فيما بينهم عبر وساطات مسؤولة، أصبحنا طرفا في هذه الصراعات والتحالفات المتغيرة بتغير حركة الرمال في هذه المنطقة، كذلك مهدت القيادة لتشجيعهم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل إرضاء للسياسة الأمريكية التي تسعى لتغيير البيئة الاستراتيجية للصراع في المنطقة، على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وإيجاد صيغ تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمكن إسرائيل من تحقيق طموحاتها الإقليمية تحت مسمى التطبيع.
وترتب على هذه السياسة تجاه منطقة الخليج والتعاملات مع قادة الدول مزيدا من التهميش للقوة المصرية، وعدم قدرتها على لعب دور إيجابي وبناء في وضع أسس لنظام إقليمي قائم على نهج المصالحات الإقليمية وتصفير الصراعات، وكان أولى بمصر أن تكون المبادرة لذلك لا أن تأتي سياساتها كرد فعل للمبادرات. لكن من المؤسف أنه ما كان يمكن أن نتوقع من هذه القيادات غير ما كان فمشكلتهم الأساسية هي أنهم لا يؤمنون بمصر ورسالتها ولا يؤمنون بأن شعبها هو الثروة والكنز. الأمر ليس شعارات تربينا عليها ونتغنى بها وإنما الأمر أمر أقدار وأدوار وأوزان لا يدركها من يحكمون.
أنتقل مشروع الممر الاقتصادي من حيز التفكير والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ والعمل. لكن هناك مشروع آخر يجري الحديث عنه لسنوات كما يجري التخطيط لفرضه وتنفيذه وهو مشروع هدفه الرئيسي هو التصفية التامة للقضية الفلسطينية وحسم الصراع لصالح إسرائيل كي تتفرغ لطموحاتها الإقليمية وتعزيز مكانتها الدولية.
عن مشروع "الدولة الجديدة" اتحدث، وقد اتخذ هذا المشروع مسميات مختلفة إلى أن جرت بلورته، وهو أحد مشاريع خمسة للالتفاف على حل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أخطرها لأنه يسعى لحل المعضلات الأساسية التي تواجهها إسرائيل، التخلص من قطاع غزة بكثافته الفلسطينية وضم الضفة الغربية التي جرى حصارها واختراقها بالمستوطنات، كما أنه يطرح صيغة بديلة لحل الدولتين، إذ يسمح بإقامة دولة فلسطينية، لكن ليس على أرض فلسطين وإنما على جزء من أرض سيناء المصرية، حسبما جاء في خريطة على صفحة مخصصة للترويج لهذا المشروع الذي طرحه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر في المنامة عاصمة البحرين.
اللافت للنظر أنه لم يصدر تصريح رسمي واضح يعطي إشارة إلى الموقف من هذا المشروع، رغم وجود تحذيرات من دوائر مختلفة رسمية وغير رسمية تحذر من خطورة هذا المشروع. لكن قد يكون صدور هذا التصريح مهم، خصوصاً أنه يجري تفسير كثير من التحركات في سيناء بما في ذلك إدارة الحرب ضد التكفيريين هناك على أنه تمهيد لتمرير هذا المشروع وكذلك الحديث عن "الريع السياسي" الذي يجري التعويل عليه لحل أزمة الديون. وهي الملف الرئيسي الثالث.

أزمة الديون: سيناريوهات كارثية
لا شك أن أزمة الديون المتراكمة على مصر والتي بلغت مستويات خطرة في السنوات الخمس الأخيرة أحد أهم الملفات التي يتعين التعامل معها بعد انتخابات الرئاسة القادمة. والأرجح أنه جرى تبكير موعد الانتخابات لاعتبارات تتعلق بالاستجابة لشروط صندوق النقد الدولية والتي يصعب الإقدام عليها في عام الانتخابات كما أنها تحتاج إلى تفويض جديد يوفره الفوز في انتخابات "تنافسية حرة"، أو هكذا يعتقدون.
المشكلة تتمثل في الإصرار على إنكار مسؤولية السياسات التي طبقت في السنوات العشر الماضية عن الأزمة الاقتصادية الحادة والمتفاقمة في البلاد، والتي يخشى كثير من المراقبين أن تقود إلى انفجار شعبي واسع النطاق وحالات من الفوضى الشديدة بسبب الضغوط التي تفرضها الأزمة والتضخم المتزايد وتدهور القدرة الشرائية للعملة المصرية واقترابها من حد الانهيار.
التقارير التي تحذر من تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر كثيرة. وكلها تقدم سيناريوهات كارثية ومفزعة لما قد تؤول إليه الأمور، يكفي أن نشير هنا إلى تصريح لوزير المالية المصري محمد معيط، في 31 يوليو الماضي، توقع فيه أن يبلغ معدل الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي 97 في المئة هذا الصيف، بزيادة تصل إلى 16.8 في المئة مقارنةً بما كان عليه في يونيو 2022. وإذا صحت هذه التقديرات فإن البلد على وشك الإفلاس، نتيجة للعجز عن السداد، أو اللجوء إلى إشهار الإفلاس لتحسين شروط التفاوض مع الدائنين.
ليست المشكلة في الاستدانة في حد ذاتها. فاللجوء إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة والعجز في الميزان التجاري مقبول طالما كانت الديون في حدود آمنة وطالما يجري استثمار القروض على يسمح بالسداد، لكن المشكلة تكمن في كيفية استخدام أموال القروض التي تحصل عليها مصر والتوسع في مشاريع للبنية الأساسية التي من المستبعد أن تدر أي عائد يساعد على تدبير أقساط السداد.
إننا أمام مشهد مماثل لأزمة الديون في عهد الخديوي إسماعيل الذي كان يحلم بجعل مصر قطعة من أوروبا مع فارق واحد يتعلق بمحصول التصدير الرئيسي لمصر في ذلك الوقت، وهو القطن المصري طويل التيلة، وأنها ترتبت على انهيار أسعار القطن في البورصات العالمية مع عودة القطن الأمريكي المنافس للأسواق بعد انتهاء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة. ولم تكف ممتلكات الخديوي التي باعها لسداد الديون ودخلنا في سلسلة من الترتيبات والإجراءات انتهت باحتلال إنجلترا لمصر وأصبحت بريطانيا ضامنة لمصالح الدائنين.
طبعا من المستبعد تكرار ما حدث في نهاية القرن التاسع عشر، لكن هناك سيناريوهات أخرى. فعلي سبيل المثال، أفلت نظام مبارك من أزمة كانت وشيكة في الديون في عام 1990 نتيجة لغزو الكويت وإسقاط نصف ديون مقابل مشاركتها في التحالف الدولي العربي لتحرير الكويت. على ما يبدو أن التفكير ينصرف في ظرف مماثل قد يؤدي إلى إسقاط جزء من ديون مصر الخارجية. إلا أن مشكلة الاقتصاد المصري ليست مشكلة ديون فقط وإنما يعاني من أزمات بنيوية أخرى تتمثل في ضعف الإنتاجية والبيئة التشريعية التي لا تجذب استثمارات ولا مستثمرين، بالإضافة إلى تدهور شديد في رأس المال البشري نتيجة لتدهور التعليم والصحة، وفي ارتفاع فاتورة واردات الغذاء، لاسيما القمح، والميل الاحتكاري للدولة مما يقضي على القطاع الخاص والمبادرات الفردية، ويضع الأسواق في قبضة مجموعات من قوى الضغط المستفيدة من بقاء الاقتصاد في هذا الوضع الي يحققون فيه مكاسب على حساب مصالح الغالبية العظمى من المصريين.
لقد كانت انتخابات الرئاسة ومن قبله الحوار الوطني فرصة مناسبة لإعادة النظر في السياسات المتبعة والتنبيه لمخاطرها لكن هذا لم يحدث فبتنا أمام مشهد هزلي لانتخابات هي أقرب للاستفتاء منها لانتخابات تنافسية ناهيك عن كونها حرة وتجري بشفافية. لكنها فرصة ضاعت بما يثبت من جديد أن تاريخنا ليس سوى تاريخ عشرات الفرص الضائعة.. ويبقى السؤال عن الصيغة السياسية المناسبة للتعامل مع هذه التحديات الصعبة والمصيرية بعد انتخابات من غير المقدر لها أن تكون انتخابات فارقة ومصيرية؟
----------------------------------
بقلم: أشرف راضي
من المشهد الأسبوعية