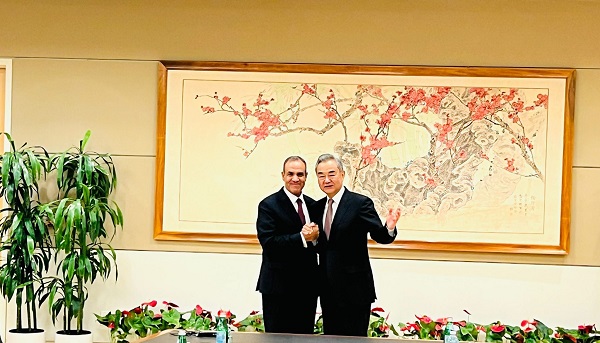بداية ـ وطبقًا للقانون الدولي ـ يُعد تعريف النزاع المسلح الجاري بين جيوش نظامية لدول مُعترف بها دوليًّا بمصطلح (الحرب)، أما ما عداها من أشكال الصراع المسلح بين جماعات أو فصائل من جهة، وبين دولة أو تحالف من عدة دول من جهة أخرى، فلا يخرج التعريف عن كون ذلك نزاعًا مسلحًا لا يصح تسميته بالحرب.
من هنا كانت حرب أكتوبر 1973 بين جيش إسرائيل وبين جيشي مصر وسورياـ وكلا الطرفين لا يعترف بالآخر ـ هي آخر حرب بين إسرائيل ودول عربية شهدتها المنطقة، ومنذ ذلك الحين ـ وإلى يومنا هذا أيضًا ـ لم تعد هناك حروب على هذه الشاكلة، وحلَّت محلها نزاعات مسلحة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أعوام 1978 و1982 كمثالين ـ وهي التي أطلق عليهما المحللون بطريق الاستسهال في التعبير صفة الحرب.
ولا شك أن اتفاقيتي السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 والأردنية الإسرائيلية عام 1994 قد وضعتا نهاية للحروب النظامية في المنطقة ولكنهما لم يمنعا قيام النزاعات المسلحة فيها حتى اليوم؛ حيث قام ويقوم جيش إسرائيل ومنذ عام 1978 وبشكل دوري أحيانًا ـ ومنتظم أحيانًا أخرى ـ بمهاجمة لبنان ردًّا على اعتداءات من جماعات لبنانية ذات هوية دينية مثل حزب الله، وذات هوية قومية عربية مثل فصائل الناصريين المتمركزة في صيدا وصور، لتطول القائمة بفصائل فلسطينية متعددة الانتماءات الدينية والقومية قد تصل إلى عدة أيام أو أسابيع لتعود بعدها حالة اللا سلم واللا حرب، وهكذا دواليك، وذلك طبقًا لقواعد صراع تتعقد حين يكون هذا الصراع مواجهة مباشرة بين أضداد معروفي الهويات، أو مواجهة بالوكالة عن قوة ذات مصلحة في شغل الرأي العام العالمي عن مشكلة ما، أو تمرير رسالة ما، أو إثبات وجود مدفوع الثمن مقدمًا أو لاحقًا، أو في شكل مقاومة صريحة كما تصف كثير من الجماعات المسلحة نفسها.
لبنان حالة فريدة
الحالة اللبنانية حالة فريدة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث إن ما يفصل البلدين ـ لبنان وإسرائيل ـ هو خط الهدنة التي قُرِّرت بعد نهاية الحرب العربية الأولى عام 1949، وما زالت سارية، ويشوبها خلاف حول أحقية أي من البلدين في بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها من قِبَل الطرف اللبناني فيما يخص مزارع شبعا من جهة، والتواجد الفلسطيني المكثف في الجنوب اللبناني، وهو الناتج عن اللجوء إليه مع بدء الصراع منذ عام 1947، ثم انتشاره في بعض مناطق البلاد من جهة أخرى، والمشاكل التي نتجت عنه مع البلد المضيف نفسه ومع إسرائيل المتسببة به.
ولا شك أن ما سُمي وقتها بحرب لبنان ـ بالخطأ أيضًا ـ كان من أكبر النزاعات المسلحة في تاريخ المنطقة؛ حيث قام جيش إسرائيل النظامي عام 1982 بالزحف إلى لبنان، لا ليحارب جيش البلد النظامي، بل منظمة التحرير الفلسطينية؛ بهدف القضاء على جيشها المتواجد في لبنان، ومعه قام الجيش الإسرائيلي الرسمي بالوصول إلى أول عاصمة عربية في تاريخ الصراع وحصارها الذي استمر لأكثر من ثمانين يومًا، وهو الذي انتهى بمغادرة قوات جيش المنظمة وبعض الفصائل إلى تونس ودول عربية أخرى ـ منها اليمن ـ بناءً على وساطات وتدخلات عربية وخارجية قامت إسرائيل بعدها بإقامة حزام أمني بعمق 20 كيلو مترًا داخل الجنوب اللبناني، وهو الذي استمر قائمًا حتى انسحابها منه عام 2000، وهو ما عُدَّ انتصارًا لقوى المقاومة اللبنانية الممثلة في حزب الله أساسًا وبعض الفصائل الفلسطينية الأخرى.
من الحرب إلى قمع الانتفاضات
مع هذا التحول من الحروب بين الدول إلى نزاعات بين بعضها وبين جماعات مسلحة كمحاولات لكبت وقمع هَبَّات شعبية ـ كما في مثال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 ـ حدث تغيير كبير في وظيفة الجيوش النظامية حالت بينها وبين أداء مهامها كجنود تم تدريبهم على خوض حروب لا مطاردة جماعات متجمهرة من الشباب والأطفال دون الثامنة عشرة، وعليها عانت هذه الوحدات القتالية من الترهل والضعف البنيوي، ليس فقط في الأداء على الأرض، بل وفي معنويات الجنود والضباط أيضًا، فعندما كُلًّفت هذه النُّخب العالية الأداء عسكريًّا بمطاردة الأطفال قاذفي الحجارة، وتنفيذ الأوامر الصادرة لهم من أعلى المستويات بتكسير عظام الفلسطينيين (بناء على أوامر وزير الدفاع وقتها إسحاق رابين)، وهدم منازل المشاركين في أعمال اعتداءات على المدنيين والمستوطنين من الإسرائيليين (بناء على أوامر رئيس الوزراء وقتها إسحاق شامير)، ثم بالرد بأنواع مختلفة من القذائف ومن بينها القذائف الحية والمطاطية (إيهود باراك وإيهود أولمرت ثم بنيامين نتانياهو)، وكلها بشعة ومميتة، حدثت هزة نفسية شديدة لدى كثير من الجنود وحتى الضباط المشاركين فيها، وقام البعض الكثير منهم بطرح العديد من الأسئلة حول ماهية عمله في الأراضي المحتلة، وهل له أن ينفذ الأوامر على عواهنها ويعصي تلك التي لا توافق ضميره؟ وأخيرًا الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية التي خرجت عن إطار الدفاع عن سلامة وأمن الدولة على حدودها الدولية ـ إن كانت هناك حدودًا دولية لها ـ وإلى متى تقوم أجهزة الدولة الرسمية ـ كوزارة المالية ـ بتمويل وزارة الدفاع بحماية المستوطنات المقامة بصورة سرطانية وغير شرعية على الأراضي المحتلة في حين تهمل المسألة الاجتماعية لقطاع كبير من مواطني الدولة؟
تفتت أحزاب اليسار وصعود اليمين
لو عُدنا إلى طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي ـ وهو نظام برلماني تمثيلي يقوم على التعددية الحزبية الشديدة ـ يمكن لحزب صغير ـ وليكن ممثلًا عن جماعات المستوطنين في الضفة الغربية حصل على ثمانين ألفًا من أصوات الناخبين ـ أن يجد له مقعدًا في الكنيست (أو البرلمان) المؤلَّف إجمالاً من مائة وعشرين، ويمكن لهذا الصوت الواحد أن يشارك ـ وبقوة ـ في تحديد مستقبل الحكومة المُشَكَّلة من طرف حزب الأغلبية الحاصل على 25 إلى 30 نائبًا في أحسن الأحوال، وينتهي الأمر بمشاركة من خمسة إلى سبعة أو ثمانية أحزاب في حكومة هشة يجري ترجيحها بأغلبية صوت أو صوتين، ووقوف عدة أحزاب صغيرة أخرى على الحياد؛ أي دون التصويت بنعم للحكومة أو لا، لتمرر بذلك هذه أو تلك من الحكومات مقابل بعض الخدمات المقدمة لها ولجمهورها، وهم عادة من المتدينين أو المستوطنين.
لم تعرف إسرائيل هذا التفتت الحزبي البالغ الشدة إلا بعد تولي حزب الليكود ـ بزعامة مناحيم بيجين ـ تشكيل أول حكومة تخلو من الأحزاب العمالية ـ المؤسسة للدولة ـ بعد هزيمته لها وفوزه في انتخابات عام 1977، وقام حزبه خلال هذه الانتخابات بتأمين أصوات كتلة كبيرة من اليهود الشرقيين، ليس حُبًّا في سياسة هذا الحزب، ولكن نكاية في الأحزاب العمالية (العمل والمابام) ذوي القيادات الاشكنازية (الغربية)، وقد قام هذا الحزب بتشجيع إقامة المستوطنات على صورة أكبر، وتسهيل تمويل المتدينين بصورة أسرع مما كان عليه الحال تحت حُكم الأحزاب العمالية، وقد قام هؤلاء بتشكيل جماعات الضغط الخاصة بهم، ثم الأحزاب، لتبدأ موجات من الانحراف يمينًا أكثر فأكثر منذ بدايات تسعينات القرن الماضي ووصول الهجرات الروسية الكبيرة إلى إسرائيل.
قد أدى هذا التحول الكبير إلى الاختفاء التدريجي للجماعات السلامية التي كانت تردد مقولة «السلام مقابل الأرض»، والتي لم تجد لها ظهيرًا داعمًا، أو حتى مُحاورًا، لا في إسرائيل ولا بين العرب، وبذلك لم تعد هناك جماعة ضغط تدعم وسيلة الحل عن طريق الأرض مقابل السلام، وحلَّت محلها وسائل القوة لفرض الأمر الواقع والتطبيع مع أطراف عربية لسحب البساط من تحت أقدام الفلسطينيين، وسيادة مقولة «السلام مقابل السلام» (منذ عهد شامير إلى نتانياهو).
السلام والعنف البنيوي المركب
لكن ماذا تعني مقولة «السلام مقابل السلام» في الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي؟
هناك نقطتان بخصوص الرد على هذا السؤال أولها ماذا يعني السلام؟ وماذا يعني الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي؟ ولنأخذ السلام، ونرى ماذا يعني؟ فالسلام كان قد عُرِّف من طرف النرويجي يوهان جالتونج Johann Galtung ـ وكان أحد المتخصصين في دراسات السلام، وأسَّس في سبعينات القرن الماضي مركزًا لدراسات هذا الموضوع ـ وتلخَّص تعريف السلام لدي جالتونج بأنه ليس فقط خلو العالم من الحرب بل خلو العالم من العنف البنيوي المركب.
ولو عرَّفنا ذلك العنف البنيوي المركب كما جاء به جالتونج نجد أنه يشمل سياسات التمييز والإهمال المتعمد والتجويع والتعطيش والتجهيل والتطهير العِرْقي بالتهجير والطرد ومحو الهوية التي تتبعها سلطةٌ ما تجاه كتلة من البشر، سواء كانت هذه الكتلة البشرية هي شعب محتل من طرف قوة خارجة عنه (كما في حالة الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع والقدس الشرقية والجولان وغيرها)، أو سلطة ما تجاه شعبها ومواطنيها، كما يحدث في كثير من دول العالم ومنطقتنا العربية ولا تحتاج للدلالة عليها بشروحات.
وتطرَّق جالتونج لشرح ما تؤدي به سياسات العنف البنيوي المركب لخَلْق حالة هي حرب ضد المواطنين العزل، ولا يمكن تمييزها عن حالة الحروب النظامية المعروفة، فإذا كانت الحروب النظامية تؤدي إلى التجويع والتعطيش والتجهيل والتطهير العرقي، إذا بعكسها تصبح هذه الحالات هي أيضًا حربًا بالضرورة.
غزة: حرب مستمرة في أبشع صورها
بهذا ننتقل إلى الشق الثاني من السؤال ونضع الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي على طاولة البحث، ولنأخذ الوضع في قطاع غزة أولًا ـ وهي حالة بينة ـ فالمحتل الإسرائيلي كان قد انسحب من أراضي القطاع عام 2005، وأقفل مداخل ومخارج القطاع وراءه ووضعها تحت رقابته الصارمة، ومعها بدأت السياسات المقصودة من طرفه تجاه أهالي القطاع بالحصار وعزل القطاع عن العالم بأسره، ومن ثم كان التجويع والتعطيش والتجهيل والحرمان من الموارد الأساسية للحياة اليومية وغيرها من الممارسات التمييزية المعروفة، حتى أصبح معها القطاع سجنًا لا يُعد مفتوحًا؛ حيث إن الطائرات والمسيرات ووسائل الرقابة الإسرائيلية ترقبه ليل نهار.
إذن إنها الحرب بصورة أبشع مما كانت عليه من قبل.
أما الضفة الغربية فأصبحت بعد اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطيني عام 1993 – 1994 والاتفاقات المكملة لها لاحقًا، فأصبحت هي الأخرى مُقَطَّعة الأوصال بما يزيد عن 500 نقاط تفتيش إسرائيلية وُضعت على الطرق الرئيسية لمنع المواطن الفلسطيني من الحركة والذهاب إلى أرضه أو بيته أو زيارة عائلته، وحيث إنه لا يستطيع الوصول إلى أرضه إذن تُصادر تلك الأرض بصفتها أرض عشواء، كما كان الحال عليه بخصوص الأقلية العربية في الداخل الإسرائيلي ولمدة عشرين سنة كاملة، هذا علاوة على الدوريات الراجلة والمسيرة والاغتيالات السابق الإعداد لها للأبرياء، وعلى قاعدة الاشتباه، واعتقال الشباب من الجنسين دون الثامنة عشرة والعجز من الرجال لا على قاعدة قانونية بل على نفس القاعدة السابق ذكرها.
لكن المصيبة هنا أن السلطة الفلسطينية التي هرمت مع الزمن لم تعد فاعلة بالكفاية لتحمي شعبها عن الممارسات الإسرائيلية بواسطة قوات الجيش وقطعان المستوطنين المنكِّلة بالشعب بكافة طوائفه، حتى أصبح العنف البنيوي المركب ـ الذي يُعَدُّ لدارس السلام (جالتونج) حربًا ـ مُزحة لا مثيل لها في التاريخ البشري.
يزيد على ذلك ما يقوم به وزير الأمن القومي الإسرائيلي ـ الفاشي النزعة ـ من مبادرات على الأرض؛ بتشكيل فيالق حماية تطوعية من مواطني الدولة من اليهود، وتوزيعه للسلاح عليهم في صورة احتفالية؛ بدعوى حماية مواطني الدولة (من اليهود) من الإرهاب العربي الفلسطيني، وقيام هؤلاء باستخدام هذا السلاح فعليًّا على الأرض ضد جيرانهم من الفلسطينيين العزل، سواء في الأراضي المحتلة، أو في الداخل الإسرائيلي، وقيام وزير آخر بالتهديد والوعيد بالترانسفير (وهو نقل السكان عنوة أو دون رغبتهم من موطنهم لموضع آخر)، وهي ما يُعرف تحت اسم الطرد الجماعي أو التطهير العِرْقي لكل الفلسطينيين من الضفة والقطاع، وآخر بإمكانية استخدام الدولة للسلاح النووي ضد هذا الجزء من الأراضي المحتلة أو تلك، مما لم نعاصره من محتل سابق على هذه الصورة على مدار التاريخ البشري المعاصر.
من كل هذا وذاك نصل إلى نقطة هامة تلخص ما فات من الذكر في صورة سؤال يقول: هل ما نراه الآن على الساحة الفلسطينية حربًا أم نزاعًا مسلحًا؟ في الحقيقة أن ما يجري الآن من قتال بين حركة حماس الفلسطينية ودولة إسرائيل من جهة، وبين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمواطنين العزل في مدن الضفة الغربية، من جهة أخرى هو حرب مُعلنة طبقًا لرواية (جالتونج).
أما القانون الدولي فيرى غير ذلك ويَعِدُّ ما نراه الآن نزاعًا مسلحًا، ولكن هل يلزم أن تكون الحرب بين شخصين اعتباريين أو دولتين فقط؟ وهل الحرب تقتصر على استخدام الطرفين للدبابات والطائرات والمدفعية الثقيلة وفِرق المشاة الراجلة والراكبة؟ هنا يلزم على القانون الدولي أن يغيِّر بعض نصوصه لتوائم ما نعيشه من تحديثات، وهي تحديثات ـ بلا شك ـ مهمة حتى يُسمي العالم العدوان باسمه الحقيقي، وتأخذ الشعوب المعذَّبة حقها في الدفاع عن نفسها والحماية الدولية التي تستحقها.
---------------------------------
بقلم: د. عادل السيد *
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة انسبروك بالنمسا