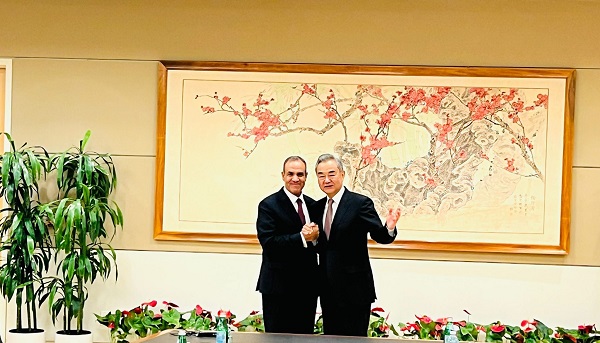«لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في الوزن، ومضادٌّ له في الاتجاه»، مقولة تُعدُّ قانونًا طبيعيًّا، وحِكمة إستنها لنا اليونانيون القدماء، وأصبحت منذ سماعها ولأول مرة سارية المفعول اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، ولنا في حركة اللا عنف بقيادة المهاتما غاندي في الهند، وثورة الجزائر العظيمة، وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية في ستينات القرن الماضي تحت قيادة القس مارتن لوثر كينج، والحركة المضادة لقوانين الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تحت قيادة السجين نلسون مانديلا، وحركة التحرر الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي على اختلاف مشاربها وخاصة تحت قيادة ياسر عرفات دليلًا على صحة هذه المقولة التاريخية.
كنت قد سمعت من السيد وزير الثقافة المصري السابق (حلمي النمنم) في إحدى المحاضرات العامة مؤخرًا موجزًا ثقافيًّا رائعًا لنفس المقولة اليونانية التاريخية ـ أو ما يعني أن كل احتلال تقابله حركة تحرر أو مقاومة تساويه في الفعل الحضاري الذي يُنتجه على الأرض المحتلة ـ فالاحتلال البريطاني في الهند لم يكن احتلالًا عسكريًّا بالمعنى المفهوم؛ وذلك أنه كان دون جيوش تحرس فئة قليلة من الأجانب البريطانيين في مملكة لهم تُدار منهم وتَحلب خيراتها لصالحهم (وهو ما يُطلق عليه بالإمبريالية)؛ بمعنى أن ذلك الاحتلال كان حضاريًّا نوعًا ما، ويعتمد الإدارة ونهب الثروات كما لو كانت الهند تعدُّ لهم جزءًا لا يتجزأ من بريطانيا العظمى، وكان البريطانيون يفرضون معاملتهم كأسياد في بلد من العبيد تُدار من طرفهم كخلية نحل، الغريب فيها كانت الملكة وحاشيتها فقط، بينما بقي الشعب على ما هو عليه من أوضاع لا تقربه من السلطة الوطنية بأي حال من الأحوال.
ومع ذلك آمن البريطانيون بإمكانية أن يظل ذلك الوضع للأبد حتى قابلتهم مقاومة من رجل بسيط كان محاميًا هو المهاتما غاندي، وكان قد تلقَّى العلم في فرنسا وبريطانيا، وعمل في جنوب أفريقيا مدة من الزمن، وعاد ليعمل على تحرير بلاده بفكر متحضر هو الآخر، ألا وهو فكر العصيان المدني، ووسيلته لذلك كانت ليس فقط «عدم العنف»، بل وزاد عليها أيضًا «أحبوا أعداءكم»؛ ذلك أن الاحتلال كان يعتبر نفسه حضاريًّا بالكفاية، وتمثل الهدف الموضوع من طرفه ـ ككل احتلال ـ في العمل على رقي وتحضر البلاد، فقابله غاندي بهدف أكثر رقيَّا تمثل في مقاومة سلبية لا يعمل فيها الشعب تحت ظل ملكة نحل تريد للشعب أن يعمل لها، ونجح غاندي دون سلاح، اللهم إلا الامتناع عن عمل الشعب كشعب من الدرجة الثانية، ونجح في الوصول إلى الهدف المأمول، وهو استقلال الهند ونهاية المستعمر.
أما المثال الثاني فكان دمويًّا للغاية؛ ذلك أن فرنسا التي احتلت للجزائر عام 1830 اعتبرت الجزائر ولاية من ولاياتها في أفريقيا، وعملت على جعلها فرنسية كفرنسا بواسطة المهاجرين من أهلها، ومع الوقت بلغ عدد المهاجرين الفرنسيين إلى الجزائر المليون ونصف المليون، وهم الذين اعتبروا الجزائر بلدهم الأصلي ولا بلد لهم غيرها.
وبلغت سطوة المحتل الفرنسي في الجزائر من العنف مبلغًا كبيرًا، فكانت كل صحوة وطنية تطالب باستقلال الجزائر تقابل بعنف شديد، حتى ضد أولئك الجزائريين الذين حاربوا في صفوف جيوش فرنسا والحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وهم الذين تظاهروا مع نهاية الحرب العالمية الثانية (الثامن من مايو عام 1945) مطالبين باستقلالهم عن فرنسا، فكان قمعهم بالرصاص الحي، وسقوط كثير من القتلى بين صفوفهم هو بداية الثورة المسلحة من طرف الوطنيين الجزائريين، وهي التي كلفتهم مليونًا ونصف مليون من شهداء الحرية، حتى وصل الأمر في النهاية إلى اتفاق يقضي باستقلال الجزائر، وجلاء المستوطنين الفرنسيين عنها، وعودتهم إلى بلادهم.
أما المثال الثالث فكان حركة الحقوق المدنية للمواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قادها القس البروتستانتي مارتن لوثر كينج في نهايات خمسينات حتى نهاية ستينات القرن الماضي، ولك أن تتخيل مواطنًا يُعامَل على خلفية لون بشرته فقط لا غير، ويُمنع بناء عليها من الجلوس بجانب مواطن أبيض البشرة في حافلة أو مدرسة أو جامعة أو مطعم من المطاعم، وحتى الأحياء ودور السكن كانت قاصرة على سكنى مواطني ذوي بشرة بيضاء أو سوداء، ويمنعهم غيرهم من الدخول إليها، وويل لمن كان يجرؤ على مخالفة تلك القوانين؛ حيث إن هناك ما كان يشير دائمًا إلى «عدم دخول الكلاب والسود» إلى أي من هذه الأماكن.
كان ذلك يجري في القرن العشرين لا في العصور الوسطى، وفي بلد تدعي الرقي الحضاري، وتقود العالم الحر عاملةً على تحرير الشعوب من المبادئ التي رأت أنها هدامة كالشيوعية والاشتراكية، وتقيم الحروب من أجل سوق عالمية حرة.
ومن بين المناضلين من أجل نَيْل حقوقهم المدنية كاملة كان القس مارتن لوثر كينج ومالكولم إكس والملاكم العالمي محمد على كلاي وغيرهم، وكان القس كينج خطيبًا بارعًا، تقع كلماته وطريقة إلقائها القوية موضع السحر من قلوب مستمعيه، خاصة ذلك الخطاب الذي ألقاه في العاصمة واشنطن في يوم 28 أغسطس من عام 1963 وبدأه بعبارة «لديَّ حلم» I have a dream والتي انتشرت في جميع أنحاء المعمورة ورددها الجميع وراءه.
ولم ينتهِ العام (1968) إلا وكان القس كينج هدفًا للاغتيال من طرف قوى الكراهية في المجتمع الأمريكي، ولكن حلمه تحقق مع الوقت، ونال المواطنون الأمريكيون من أصول أفريقية حقوقهم بالقانون، وبعدها بعقود عديدة تولى أول أمريكي من أصول أفريقية (باراك حسين أوباما) رئاسة الدولة عن الحزب الديمقراطي، وتتولى حاليًا سيدة من أصول أفريقية (كاميلا هاريس) منصب نائب الرئيس.
والاختلاف في حالة جنوب أفريقيا عن الحالة الأمريكية أن المواطنين الأصليين في جنوب أفريقيا ـ وهم المشكِّلون للسواد الأعظم في البلاد ـ نزعوا إلى استخدام الكفاح المسلح كرد فعل على فعل الكراهية الموجه إليهم من طرف نظام الحُكم العنصري من طائفة (البوير) الهولندية الأصل وحملاتهم العسكرية والشرطية التأديبية القاسية على مدن الصفيح التي كانوا يسكنونها على أطراف المدن الكبرى، وفي هذه الحالة وَلَّد العنف مثيله من الفعل، وكانت الفظاعات المرتكبة من الطرف العنصري تقابل بفظاعات من الطرف الذي لا حول له ولا قوة إلا الدفاع عن نفسه، وبنفس الأسلوب، حتى أُرغم العنصري على قبول حل العيش معًا، وتولت الأغلبية الأفريقية زمام الحكم في البلاد.
ولم يكن ذلك سهلًا للمحاربين الأفارقة ضد قوى الكراهية في جنوب أفريقيا، ولكن النجاح كان بمساعدة كل قوى الحرية في قارة أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا، وكان لمصر والجزائر دورٌ كبيرٌ في هذا المضمار، وهذا ما لم تنسه جنوب أفريقية لها بعد تخلصها من نظام الفصل العنصري للأبد.
والدرس الأخير والذي نحن بصدده الآن هو الدرس الفلسطيني الإسرائيلي؛ حيث إن الطرف الأخير يمتلك ليس فقط جيشًا قويًّا يقمع به كيفما شاء من دول وجماعات، بل يمتلك أيضًا أجهزة دعائية قوية تنتشر في العالم أجمع، وتعكس الحقائق بأكاذيب يصدقها العالم عن وجودها في محيط عربي يكرهها ويكره مواطنيها، لا كمغتصبين للحقوق، بل بصفتهم يهودًا، وإن ذلك يعني لهم إمكانية تكرار المحرقة التي تعرض لها يهود أوربا في ظل نظام أدولف هتلر النازي الفاشي في كل من ألمانيا والنمسا في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
هذا وتُصدِّر إسرائيل للعالم كيف تعرَّضت للهجوم عليها من ست دول عربية بعد اعلان قيامها عام 1948، ولا تذكر النكبة الفلسطينية، ولا اللجوء الفلسطيني والتطهير العرقي إلا بناء على رؤيتها الخاصة بها للنزاع، فما حدث لم يكن لهم إلا هروبًا من جانب الفلسطينيين من الدولة الجديدة، هذا ولم تذكر معها كيف مُنِعَ هؤلاء من العودة إلى مدنهم وقراهم في فلسطين التاريخية، ولا مصادرة أراضي الغائبين، وحتى الحاضرين منهم بصفته قد غادرها ومكث كيلو مترًا واحدًا بعيدًا عن بيته.
ومع صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقرار حق الفلسطينيين في العودة أو التعويض عن أملاكه ـ ذلك القرار الذي حمل رقم 194 لسنة 1949 ـ قابله البرلمان الإسرائيلي بـ «قانون العودة اليهودي»، وهو القانون الذي أتاح لكل يهود العالم الحق في العودة وحصوله على الجنسية الإسرائيلية فور الوصول إلى أراضيها.
ولم يكن لاقتراح الرئيس الأمريكي هاري ترومان في بداية خمسينات القرن الماضي بإمكانية إقرار السلام بين الدول العربية ودولة إسرائيل حظًّا وافرًا، فقد اقترح ترومان قبول الأخيرة عودة مائة الف من اللاجئين إلى ديارهم في الدولة الجديدة كقاعدة للسلام بين العرب ودولة إسرائيل، وقابلت الأخيرة هذا الاقتراح بكثير من التردد والمماطلة حتى أتت فضيحة وزير الداخلية لافون في مصر (حاول الوزير الإسرائيلي إفساد المفاوضات المصرية البريطانية بشأن الانسحاب من مصر عام 1954 بتجنيد بعض الشباب من بين اليهود المصريين وقيام هؤلاء بوضع قنابل في دور العرض المصرية لإعطاء الانطباع بانعدام الأمن في مصر، ومعها تتمسك بريطانيا بالبقاء في مصر بغرض حماية مصالحها ومصالح الغرب) وينسى العالم معها اقتراح الرئيس الأمريكي للأبد.
ومع عام 1967 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية من الأردن وقطاع غزة من مصر، بالإضافة إلى الجولان السورية، وسيناء المصرية، أخذت القضية الفلسطينية بُعدًا خطرًا؛ حيث عملت إسرائيل على محو الهوية الوطنية الفلسطينية محوًا تامًّا، وضم القدس إلى إسرائيل ضمًّا قانونيًّا عام 1968، وما كان تصريح رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير في بداية سبعينات القرن الماضي عند سؤالها عن حقوق الفلسطينيين وردها على أحد الصحافيين: «من هم هؤلاء الفلسطينيون؟ نحن هم الفلسطينيون!»، إلا عاكسًا لقَدَر الفلسطينيين تحت سيطرة احتلال ينفي صفتهم الوطنية وحقهم في تقرير مصيرهم وبناء الدولة الخاصة بهم كما جاءت القرارات الأممية بذلك.
ولو قارننا الحالة الفلسطينية بالحالة الجزائرية وحالة جنوب أفريقية معًا نجد أن هناك تشابهًا كبيرًا بينها؛ فإذا كانت فرنسا قد اعتمدت على جلب الفرنسيين إلى الأراضي الجزائرية لجعل الجزائر فرنسية كانت الحالة الإسرائيلية تعتمد على الهجرة بصفة أساسية، فالدولة قد أنشئت لليهود وهي مفتوحة لليهودي فقط على حساب الفلسطيني، والتشابه بحالة جنوب أفريقية بيِّنة في معاملة الفلسطيني داخل الخط الأخضر (1948) والأراضي المحتلة (1967)، فالأول كان ـ وما زال ـ مواطنًا من الدرجة الثانية، والثاني ليس له وجودٌ أصلًا في العُرف الصهيوني.
ومن هنا كانت الانتفاضات الواحدة تلو الأخرى، ومن هنا جرى ويجري حمام الدم على حساب طرفي النزاع، وإن كانت إسرائيل قد استغلت هجمات الفلسطينيين لتبدو للعالم كما لو كان وجودها مهددًا حتى بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بها رسميًّا عام 1993، إلا أن ماكينة الدعاية لم تعرف الراحة في إظهارها خاصة والفلسطينيين عامة بمظهر المُتَحَين لقتل اليهود، وأنه لا يوجد لها شريك على قدر المسؤولية يتحمل عبء الدفاع عنها وعن أمنها القومي لا أمن المضطهدين من الجانب الآخر.
ولا شك أن السابع من أكتوبر 2023 كان هو ردة الفعل الأخيرة في هذا الصراع الطويل، وليس هو آخر الصراعات التي نراها أو سنراها بين طرفين غير متساويين لا في القوة ولا في كيفية تطويع أجهزة الدعاية الحديثة لصالحها.
لكن يبقى الرهان دائمًا على العزم والمثابرة في المطالبة بالحرية والخلاص، وهذا ما يفعله الفلسطينيون.
--------------------------------
بقلم: د. عادل السيد
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة انسبروك بالنمسا