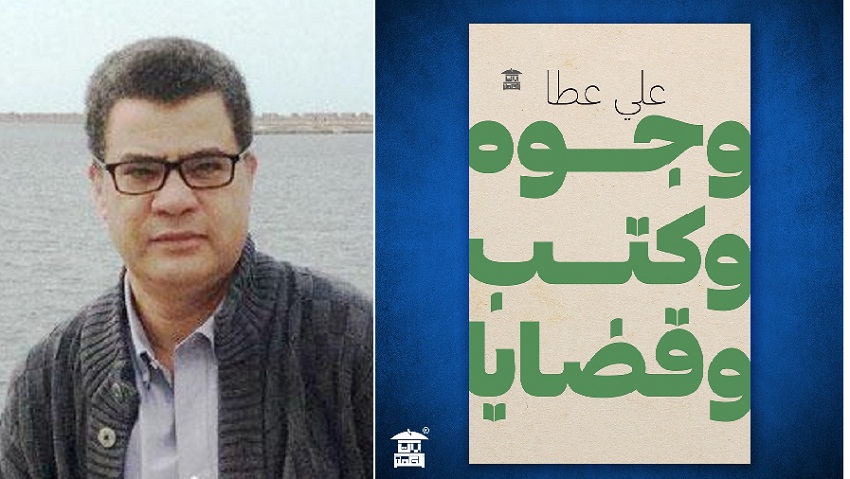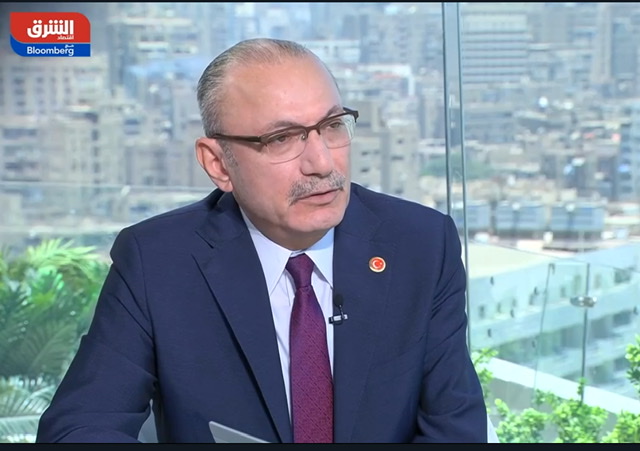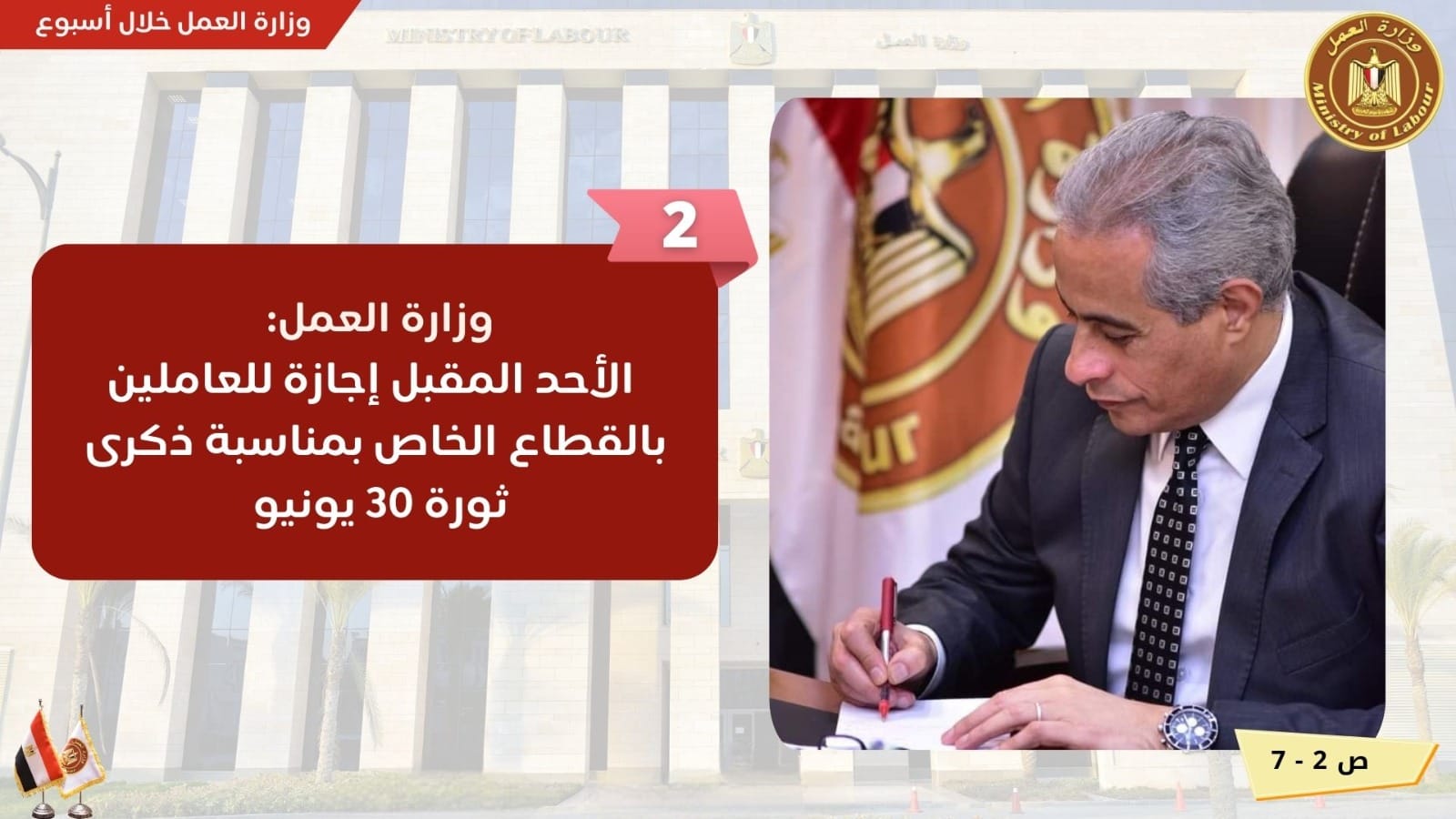لم أبالغ حين وصفتُ الشاعر والروائي علي عطا بأنه "صائد الكنوز"، حيث نستطيع أن نطالع مايقوم به من عروض وقراءات لكتب على درجة كبيرة من الأهمية والجاذبية في كافة فروع المعرفة: الأدب بأجناسه المختلفة، والنقد الأدبي، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، إضافة إلى الكتب المترجمة التي لاغنى للقارئ العربي عن معرفتها.وذلك من خلال تألقه الصحفي بوصفه محررا ثقافيا صاحب خبرة طويلة منذ عمله لسنوات في مكتب جريدة "الحياة" اللندنية بالقاهرة مع الروائي الكبير إبراهيم أصلان، ثم جريدة "اندبندنت عربية" اللندنية، و"النهار العربي" اللبنانية، وأخيرا "المشهد" المصرية.
وأستطيع أن أؤكد أن علي عطا متابع جيد وواسع الاطلاع على أهم ماتصدره دور النشرالحكومية والخاصة. وهذا مانلاحظه في كتابه الجديد "وجوه وكتب وقضايا" الصادر عن "بيت الحكمة" في القاهرة، والذي ينقسم إلى: مدخل يوضح فيه دافعه إلى كتابة مقالات الكتاب، وهو "محبة الكتاب في شكله التقليدي (الورقي) الذي بات مهددا من جانب الصيغة الإلكترونية المستجدة حتى أصبحت بعض دور النشر تكتفي بالنشر الإلكتروني. ولاشك أن ارتفاع سعر الورق وتكاليف الطباعة يقف وراء انتشار هذه الظاهرة. وهذه قضية ينبغي مناقشتها بجدية لتفادي آثارها.
ثم يتوقف علي عطا أمام ضرورة الترجمة بوصفها "فرض عين"، وليس "فرض كفاية"، بعد أن أصبح العالم قرية واحدة، وبوصفها أيضا "قاطرة التقدم" بتعبير المفكر والناقد الكبير جابر عصفور الذي وضع كتابا كاملا – وليس مجرد مقال – عن أهمية الترجمة وضرورتها. ويلفت الكاتب نظرنا في هذا السياق إلى عدم الاكتفاء بالترجمة عن الغرب الأوروبي؛ بل ينبغي أن تمتد رقعتها لتشمل الأوطان "شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، مع مراعاة أولوية الاهتمام بثقافات محيطنا الأفريقي غير العربي". وهذا صحيح بعد أن أهملنا البعد الأفريقي كثيرا، وكأننا لسنا جزءا منه.
ثم يستعرض على عطا فصول كتابه التي تنقسم إلى خمسة فصول، يحمل الأول عنوان "وجوه من هنا وهناك"، ويدور حول سِير العديد من الشخصيات التي لعبت دورا بارزا ومؤثرا في السياسة والأدب والثقافة عامة، من خلال ماكتبته هذه الشخصيات عن رحلتها في الحياة، أو من خلال ماكتبه الآخرون عنها. ومن هؤلاء: الكاتب الصحفي الكبير محمد سلماوي الذي جمع بين كتابة المسرح والرواية، وذلك من خلال كتابه "العصف والريحان" الذي يكشف فيه عن أسرار كثيرة منها – مثلا – "صدمة نظام حكم الرئيس حسني مبارك إزاء خبر فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل"، حيث كان يرغب في فوز كاتب آخر لم يذكر محمد سلماوي اسمه. وأغلب الظن أنه كان توفيق الحكيم، أو ربما وهذا هو الأرجح عبد الرحمن الشرقاوي. وقد كتب سلماوي – كما يشير الكاتب – عدة مسرحيات لافتة هي "سالومي" في بداية الثمانينيات، و"رقصة سالومي الأخيرة" في أواخر التسعينيات، ومسرحيتي "فوت علينا بكرة" و"الجنزير" وقد عرضت الثانية عام 1995 و1996وحضر عرضها الرئيس مبارك والسلطان قابوس. وهي كانت مكرّسة لمواجهة الفكر المتطرف الذي كان يقف وراء ما شهدته مصر من حوادث إرهابية في عقد التسعينيات.
ومن خلال استعراض أعمال سلماوي عامة نلحظ انشغاله بالقضايا الوطنية والقومية، ومن ذلك رواية "الخرز الملون"التي كتبها عن القضية الفلسطينية. أما الرواية المهمة حقا فهي "أجنحة الفراشة" التي كتبها قبل اندلاع ثورة يناير وانتهت أحداثها بقيام "ثورة كبرى" في ميدان التحرير، ينحاز لها الجيش؛ "ما تسبب في سقوط الحزب الحاكم وترنح النظام".
مزيد من الوجوه
أما سيرة مصطفى الفقي فقد كتبها تحت عنوان "الرواية رحلة الزمان والمكان"، ويوضح فيها أن حياته توزعت أفقيا بين العمل الدبلوماسي والنشاط الأكاديمي والاهتمام السياسي والظهور الإعلامي والإسهام البرلماني. أما السير الغيرية، فنجدها في ترجمة "يوميات وجيه غالي: كاتب مصري من الستينيات المتأججة " للباحثة مي حواس، وهي مذكرات كانت بحوزة ديانا آثيل التي انتحر غالي في شقتها. ولعل أغرب ماورد فيها زيارته لإسرائيل والأيام الأخيرة من حياته بعد عودته إلى إنجلترا.
ويعود علي عطا ثانية إلى السياسيين فيتحدث عن عمرو موسى في سيرته "سنوات الجامعة العربية" والتي تبلغ 19فصلا، وأهم ما يركز عليه هو معركة موسى لمشاركة "الثقافة العربية في فرانكفورت 2004"؛ لإيمانه أن العالم العربي ليس فقط حكومات بل مجتمع أهلي فاعل وحركة ثقافية وفنية تتجاوز الإطار الرسمي. وكان من الطبيعي أن تشن إسرائيل وحلفاؤها حملة مضادة للتشويش على هذه المشاركة لكن موسى ينجح في النهاية.
بعد ذلك ينتقل إلى ألبير قصيري من خلال كتاب "ألبير قصيري: التهميش إجابة على الحداثة" لباسم حنا شاهين والذي يؤكد معارضة قصيري للتقدم والتحديث بنصوص تعبر عن ازدراء كلي لقوى السلطة، وهكذا ترسم مؤلفاته جمالية أخلاقية التبطل والخمول والكسل. ثم ننتقل إلى "أحمد مرسي المشهور عالميا والمهمش محليا"؛ الذي اشتهر في فن الطباعة وكان يصف نفسه بأنه "شاعر يرسم"، في ديوانيه "أغاني المحاريب" و"الهجرة إلى زمن آخر".
أما العرض الأكثر أهمية، فكان لكتاب "إدوار سعيد: أماكن الفكر" لتيموثي برينان (تلميذ سعيد) الذي تقصى فيه التأثيرات العربية في فكر سعيد،وأوضح مواقفه، خاصة في كتابه "الثقافة والإمبريالية".
ثم ينتقل علي عطا إلى الكتاب الموسوعي "شكسبير: ابتكار الشخصية الإنسانية" لهاولد بلوم وترجمة د.محمد عناني الذي يؤكد أن الشخصية الأدبية قبل شكسبير كانت ثابتة نسبيا، أما عند شكسبير فإن الشخصيات تتطور بدلا من أن تتكشف لنا فحسب.
بين واقع ومجاز
وفي الفصل الثاني يتوقف الكاتب عند "أدب الرحلة بين واقع ومجاز"، فيستعرض كتبا من قبيل "البحث عن شاروخان: 40 يوما في الهند" للكاتب الصحفي مهدي مبارك، وكتاب "كل المدن أحلام" لجرجس شكري، و"القمر" لبرونر هنا، الذي ترجمته هبة الشريف عن الألمانية.ومن كتاب "حكايات جحا الصقلي" لفرانشيسكا كوراو وترجمة حسين محمود ولمياء الشريف، نعرف أن شهرة جحا أصبحت كبيرة في القرن السابع الميلادي، كما يظهر في قول عمر بن أبي ربيعة: "دلهت عقلي وتلعبت بي / حتى كأني من جنوني جحا". ثم ينتقل علي عطا إلى كتاب "إبراهيم ناجي.. زيارة حميمة تأخرت كثيرا" لسامية محرز والذي فاز بجائزة ساويرس في دورتها الأحدث، وفيه تحرص على تصحيح كثير من المعلومات المتداولة عن جدها. كما تناول كتبا يمكن وصفها بأدب الرحلة مثل "رحلة إلى جبال سراييفو" لسيف الرحبي الذي كتبه في ظل تفشي وباء كورونا. ومن ذلك أيضا كتاب "على خطى هيمنغواي في كوبا" لهايدي عبد اللطيف.
أما الفصل الثالث فيدور حول "تجليات الشعر بين قديم وجديد"، وتناول فيه "بلاغة التشكيل في قصيدة النثر" لهويدا صالح، و"شعرية شوقي: قراءة في جدل المحافظة والتجديد" لمحمد السيد إسماعيل، و"أحمد عبد المعطي حجازي شاعر اليوتوبيا المفقودة" لرضا عطية، و"سلاطين الوجد: دولة الحب الصوفي" لأحمد الشهاوي، و"الصمود: الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني" لحاتم الجوهري.
نقد النقد
ثم خصص الفصل الرابع لنقد النقد، واستعرض فيه كتاب "الأنثى المقدسة: أساطير المرأة في الصحراء" لميرال الطحاوي، و"الدخان واللهب: الإبداع والاضطراب النفسي" لشاكر عبد الحميد، و"التفكير النقدي والخطاب الأدبي: جدلية التراث والمعاصرة عند جابر عصفور" لمحمد زيدان، و"الشر والوجود: فلسفة نجيب محفوظ الروائية" لفيصل درّاج، و"الجمال المضاد" لسمير غريب.
أما الفصل الخامس فقد جاء تحت عنوان "قضايا ثقافية وفنية وسياسية"، وتناول فيه علي عطا العديد من القضايا المهمة مثل السجال الذي دار حول بدايات المسرح المصري، وحال الترجمة من لغة الضاد وما يستشعره الغربيون من رعب ناجم عن تدفق اللاجئين إلى أوروبا، والحديث عن الانترنت وكيف تحول إلى ساحة حرب، والإجابة عن سؤال: "هل يتحول البشر إلى آلات؟"، في ظل عصر الرقمنة، و"لماذا يكره بائعو الكتب أمازون؟"، وعدم رواج الأدب الصيني عربيا، وطقوس الكتابة الإبداعية في زمن الكومبيوتر، واقتباس السينما المصرية من الأدبين الغربي والعربي، ودور الشوام في بدايات النهضة المصرية. وأخيرا يتحدث عن "ألف ليلة وليلة" التي مازالت تفتن العالم. من خلال هذا العرض نلاحظ مدى التنوع الذي حرص علي عطا على تقديمه للقارئ العام بأسلوب سلس وموجز ومعبر.
------------------------------
بقلم: د. محمد السيد إسماعيل