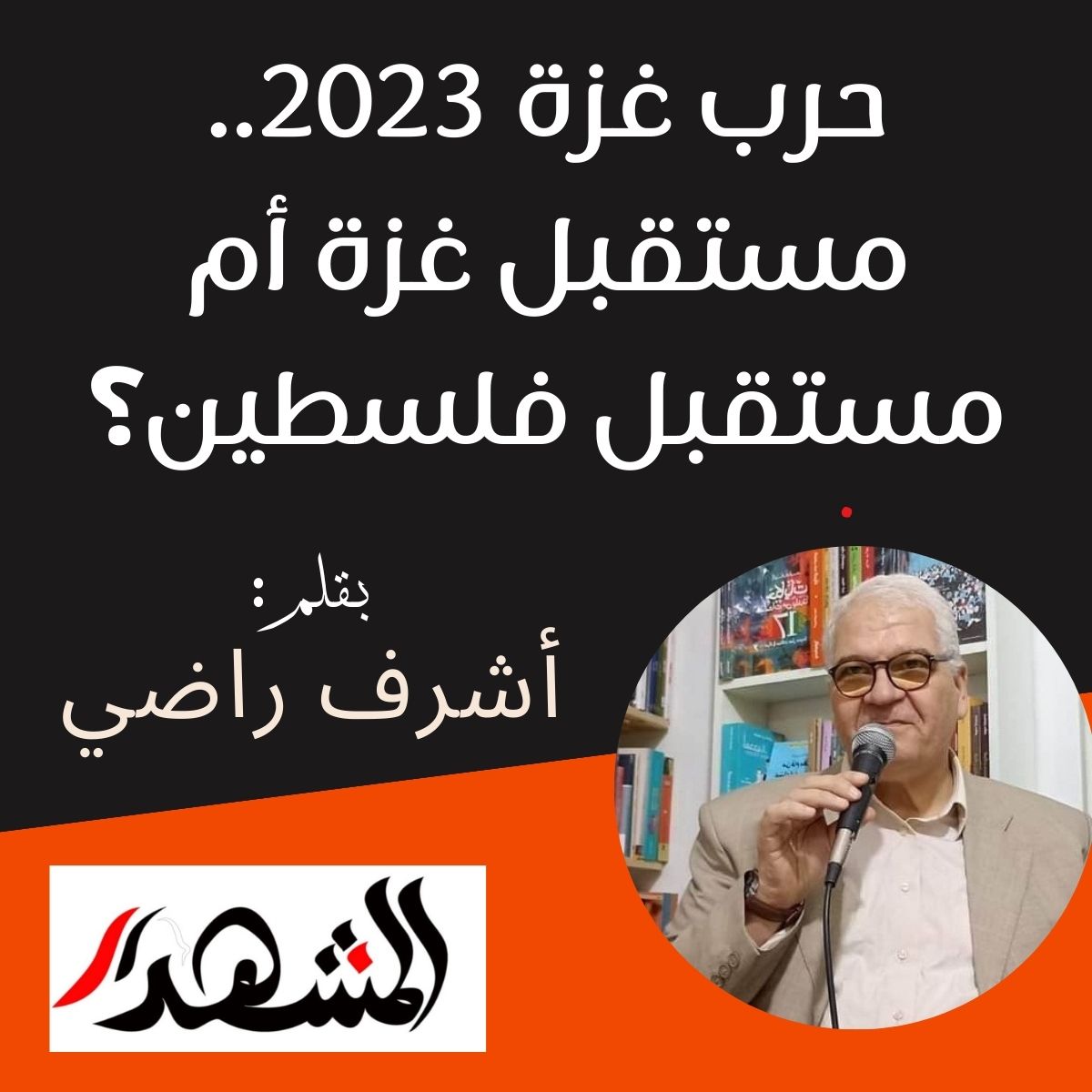كثيراً ما يُوصف الصراع مع إسرائيل بأنه "صراع وجود وليس صراع حدود"، بمعنى أنه صراع لا يمكن حسمه إلا بقضاء أحد طرفيه على الطرف الآخر، ولا مجال فيه لأي تسوية تحقق السلام، ذلك أن السلام لا يتحقق إلا عند الوصول إلى نقطة يحقق فيه هذا الطرف أو ذاك نصراً حاسماً ومبيناً، لتتحقق هيمنته باستسلام الطرف المهزوم وقبوله بسيطرة المنتصر. وهذا الوصف-"صراع الوجود"- يعكس السردية السائدة لدي قطبي هذا الصراع: الإسرائيليين والفلسطينيين، بالمكونات المختلفة للهويتين المتصارعتين.
علي الجانب الإسرائيلي، تقوم السردية السائدة، وفقاً للأيديولوجيا الصهيونية، على فكرة نفي الوجود الفلسطيني، على الأقل، في حدود أرض فلسطين تحت الانتداب، بل نفي الوجود العربي إذا تم ضم الأردن إلى حدود فلسطين تحت الانتداب كما تصورها بعض الأدبيات الصهيونية، أو إذا تم توسيع حدود ما يسمى "أرض الميعاد"؛ الأرض التي وعد الرب بأن تكون لشعب إسرائيل، لتمتد ما بين النيل والفرات، وهو طموح لا تزال بعض الحركات الصهيونية تحلم به، ولا يزال كثير من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، يعتبرونه الهدف النهائي للمشروع الصهيوني، الذي يجب التصدي له ومحاربته.
على الجانب الفلسطيني، سادت لعقود طويلة سردية ترفض أي وجود لإسرائيل في المنطقة، وتعتبرها كيانا غريباً تم زراعته لأداء أدوار محددة لصالح المشاريع الاستعمارية، عبر تهجير اليهود وتوطينهم على الأرض التي جرى، ولايزال يجري سرقتها، بأساليب شتى من أصحابها، وفرض هذا الوجود بالقوة المسلحة التي تعهدت القوى الاستعمارية الكبرى بتعزيزها ودعمها، بل التدخل العسكري المباشر عند الضرورة لحمايته. ولم تقتصر هذه السردية على الفلسطينيين وحدهم بل يشاركهم فيها قطاعات كبيرة من الجمهور في العالم العربي والإسلامي، وتتبنى أنظمة حاكمة، أبرزها النظام الإيراني، الدعوة للقضاء على إسرائيل.
هاتان السرديتان تعطيان لهذا الصراع خصوصيته باعتباره مباراة صفرية، لا مجال فيها لأي تسوية، وتجعله من أكثر الصراعات في العالم قابلية للاستمرار بصور وأشكال مختلفة. غير أن دراسة هذا الصراع دراسة علمية تستند إلى وقائع التاريخ تكشف أنه يدور أيضا حول الحدود السياسية والجغرافية، كما أن له حدوداً تغيرت عبر الزمن مع الانتقال من مستوى الصراع العربي - الإسرائيلي إلى مستوى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتظل هناك إمكانية لتوسيع حدود الصراع مرة أخرى، نظراً لطبيعته المركبة والمتعددة الأبعاد، ونظراً لارتكاز بعض السرديات السائدة بخصوص الصراع ومساراته المختلفة على نبوءات دينية وتفسيرات لنصوص في الكتب الدينية ، وعلى معتقدات راسخة لدى شعوب كثيرة، إذ يذكر أن أقلية كبيرة من بين 100 مليون مسيحي إنجيلي أمريكي تعتقد بأن إسرائيل جزء أساسي من خطة المسيح لآخر الزمان، كما يسود الاعتقاد بين قطاعات غفيرة من المسلمين، السنة والشيعة على حد سواء، بأن زوال إسرائيل مرتبط بظهور إمام آخر الزمان. ولا يمكن في ظل سيادة هذه التصورات الدينية الحديث عن أي نهاية لهذا الصراع.
لكن إلى أن يحقق الله وعده ماذا يمكن للبشر عمله لتحسين شروط العيش، هل من مساحة لأن يكون للبشر اختيارات من أجل حياة أفضل؟ إن التركيز على مقاربة الحدود في سياق هذا الصراع، مدخل مهم ورئيسي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية تحد من الآثار المدمرة لاستمرار هذا الصراع على شعوب المنطقة، وربما على شعوب العالم، إذا أخذنا الآثار الاقتصادية في الاعتبار، وأيضاً إذا أخذنا في الاعتبار ارتباط هذا الصراع بكثير من المشكلات الأمنية والصراعات في العالم، وفي مقدمتها قضية الإرهاب. وهذه المقاربة مهمة وضرورية، أيضاً، في ضوء حقيقة أنه لا أفق في المدى المنظور أو في التاريخ القريب لحسم الصراع الوجودي بين إسرائيل وأعدائها. وتكشف الحرب الشرسة الدائرة منذ أكثر من خمسة شهور في غزة صعوبة تحقيق هذا الهدف.
فمن ناحية، هناك صعوبة في القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة في القطاع، بل استحالة القضاء على مقاومة أي شعب للاحتلال، ناهيك عن استحالة القضاء على الشعب نفسه، إذ أن التجربة التاريخية تشير إلى أن إسرائيل تضم في حدودها المعترف بها بموجب اتفاقيات الهدنة، بعد حرب عام 1948، أقلية فلسطينية كبيرة نسبياً، لها هوية متمايزة وتتمتع بحقوق للمواطنة وإن كانت منقوصة مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها اليهود، وتلعب دوراً مؤثراُ في السياسات الإسرائيلية وفي رسم حدود الصراع مع الفلسطينيين، رغم تمايزهم عن فلسطيني الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كذلك، تكشف خبرة الصراع الدائر منذ أكثر من مائة عام أن القضاء على إسرائيل يفوق إمكانات وقدرات شعوب المنطقة ودولها، وأثبتت التجربة التاريخية أن المواجهات العسكرية والحروب، النظامية وغير النظامية، ضد إسرائيل لم تضعف المشروع ولا الكيان، وإنما زادتهما تثبيتاً ورسوخاُ، لاعتبارات كثيرة في مقدمتها طبيعة النظام الدولي القائم، الذي يحرص على حماية الحدود القائمة والموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وثمة شواهد كثيرة على عدم قبول القوى الكبرى الفاعلة والمؤثرة في سياسات المنطقة لفكرة إعادة رسم الحدود السياسية القائمة وقيام كيانات سياسية جديدة، نتيجة لتفكك الدول القائمة ضمن الحدود الموروثة أو نتيجة لعمليات توحيد قسرية، رغم الحديث المتكرر عن وجود مؤامرات خارجية لإعادة رسم خريطة دول المنطقة وتقسيمها. علاوة على مسألة الحفاظ على الحدود القائمة، هناك أسباب أخرى لدعم وجود إسرائيل في المنطقة وتعزيزه، والتعامل بحذر مع مسألة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، رغم أنه الحل العملي الأكثر قبولاً الذي من شأنه أن يغير طبيعة الصراع ويحد من وتيرة انفجاره في حروب كبيرة، سواء فيما بين الدول أو في مواجهة جماعات وفصائل وحركات مقاومة مسلحة.
جغرافيا سياسية مطعون في شرعيتها
غير أن مقاربة الحدود هذه تحتاج بدورها إلى معالجة نقدية، بسبب الملابسات التاريخية لتطور النظام الدولي للإقليم الذي ظل لقرون طويلة جزءاً من امبراطوريات كبرى، لم تسمح بالتطور السياسي لدوله الوطنية إلا في استثناءات قليلة ومحدودة. في كتابه،” خط في الرمال: بريطانيا وفرنسا والصراع على الشرق الاوسط“، الذي صدرت طبعته العربية الأولى في لندن عام 2015، يوضح جيمس بار الدور الذي لعبه التنافس الاستعماري البريطاني الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى في رسم الحدود السياسية في منطقة المشرق العربي، والدور الذي لعبته العصابات اليهودية في فلسطين تحت الانتداب البريطاني، والمدعومة من فرنسا تحديداً، في هذا الصراع الذي انتهى بتسليم بريطانيا فلسطين للوكالة اليهودية. وتناولت العديد من الكتب والدراسات الحدود بين الدول التي رُسِمت نتيجة للتنافس الاستعماري الأنجلو- فرنسي، ونتيجة أيضاً لصراعات الكثير من القوى المحلية والتي رسمت ملامح النظام الإقليمي الراهن في صيغتيه العربية والشرق أوسطية، وحددت مسار صراعاته وحروبه لعقود.
في البداية، كانت السردية القومية العربية التي تتبنى مشروع الوحدة العربية وتدافع عن النظام الإقليمي العربي في مواجهة النظام الشرق أوسطي، تميل إلى اعتبار أن واقع التجزئة ومشروع الدولة القطرية هو المسؤول بشكل أساسي عن العجز الذي تعاني منه الدول العربية على أكثر من صعيد، وكانت تفترض أن مشاريع الوحدة العربية المنشودة من شأنها أن تحل كثيراً من مشكلات الاستقلال والتنمية لشعوب المنطقة، ورغم أن التيارات القومية الوحدوية عدَّلَت كثيراً من رؤيتها لحساب التصالح مع واقع الدولة القطرية والبحث في مشاريع للتكامل والعمل المشترك فيما بين الدول العربية، إلا أن ترسخ النخب العربية الحاكمة كرَّس واقع الدول الوطنية التي نشأت في الفترة اللاحقة على الحرب العالمية الأولى والتي تم ترسيخها مؤسسياً من خلال مشروع جامعة الدول العربية.
فالواقع الراهن يشير إلى تراجع السردية الوحدوية لصالح الدولة الوطنية القطرية التي تسعى لترسيخ هويتها المتمايزة وتدافع عن مصالحها الوطنية التي تعطيها أولوية على أي مصالح أخرى، وأيضا لصالح صعود مشروع الخلافة الذي ترفع لواءه تنظيمات الإسلام السياسي، الأمر الذي أبرز أزمة بناء الدولة الوطنية ومنازعة شرعية قيامها. ويعكس هذه الأزمة أيضاً ما آلت إليه القضية الفلسطينية، التي باتت الآن على مفترق طرق تاريخي، ما بين التصفية نتيجة لكثير من المتغيرات الإقليمية والدولية، وما بين الدخول في مرحلة نوعية جديدة لبناء الهوية الوطنية الفلسطينية وتجسيدها على الأرض. لقد نجحت منظمة التحرير الفلسطينية، وفي قلبها حركة فتح، في بلورة ومأسسة مشروع الهوية الوطنية الفلسطينية، لكن هذا المشروع يقف الآن في مواجهة تحدي مزدوج، تمثله إسرائيل ومشروعها التوسعي، وحركة حماس وفصائل المقاومة الإسلامية الأخرى التي تعلي من الأيديولوجية الإسلامية على حساب الهوية الوطنية، كما تعرض المشروع لإنهاك مستمر بسبب عداء التيارات القومية العربية والمشاريع الإقليمية الأخرى.
قديماً، كان الرأي السائد المناصر للقضية الفلسطينية يرى أن مشروع تحرير فلسطين هو في الوقت نفسه مشروع للتحرر العربي، بل والتحرر الوطني للبلدان العربية، ذلك لأن المواجهة هي بالأساس مواجهة للمشاريع الاستعمارية المستمرة في نهب ثروات الشعوب العربية وتكريس تخلفها الاقتصادي والاجتماعي عبر ربطها بالمراكز الرأسمالية العالمية الكبرى، واستمرار التبعية كنمط عام يحكم هذه العلاقة بين دول المنطقة وهذه المراكز رغم التغيرات الاقتصادية الكبرى التي شهدتها المنطقة وتكون مراكز اقتصادية ومالية، أعادت صياغة العلاقة بين المراكز الرأسمالية وبين المراكز الإقليمية. وتتعامل برامج الكثير من حركات التحرر في العالم العربي مع وجود إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني وسياساتها العدوانية باعتباره استمرارا لعجز النخب والشعوب العربية على انجاز مهمة التحرر الوطني والاستقلال، الذي لن يكتمل إلا بتحرير فلسطين.

أزمة بناء الدولة
رغم التصالح مع مشروع الدولة الوطنية القطرية والقبول تدريجياً بشرعية الحدود السياسية القائمة في المنطقة، إلا أن هناك أزمة ترصدها الدراسات السياسية للمنطقة تتعلق ببناء الدولة. قد يعترف بعض الحكام والساسة، في مجالسهم الخاصة، وفي مرات نادرة في تصريحاتهم العامة، بهذه الأزمة، حسبما ورد في إشارة عابرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأننا "نعيش في شبه دولة"، لقد عالج عالم السياسة الأمريكي الراحل صمويل هنتنجتون هذه الإشكالية في الاجتماع السياسي، في كتابه الصادر في عام 1968، بعنوان "النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة"، والذي صدرت له ترجمتان باللغة العربية. إذ اشار إلى أن الفارق السياسي الأبرز بين النظم السياسية إنما يقوم بين الدول التي يتجسد في سياستها، التوافق العام والاتفاق والشرعية والتنظيم والفعالية والاستقرار، وبين تلك الدول التي تعاني سياستها من عجز على هذا الصعيد، بغض النظر عن نمط الحكم السائد، ديمقراطي أم استبدادي، أو طبيعة النظام الاقتصادي -الاجتماعي، اشتراكي أم رأسمالي.
ففي المجتمعات الأولى، استقرت تقاليد لتداول السلطة والتناوب على الحكم، وهي لا تعاني من أزمة على هذا الصعيد، إذ يوجد توافق عارم من قبل الناس على شرعية النظام السياسي القائم، وعلى رؤية المصلحة العامة للمجتمع والتقاليد والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد السياسي، كما تُوجد إجراءات معقولة لتنظيم انتقال السلطة وضبط الصراع السياسي، وتوجد حكومات ترعى ولاء مواطنيها، في المقام الأول، ومن ثم تمتلك هذه الحكومات القدرة على فرض ضرائب على الموارد وتحصيلها بفاعلية، وعلى حشد القوة البشرية ووضع سياسة معينة وتنفيذها. في المقابل، هناك فشل كبير في تجربة الدول التي تحررت من الاستعمار في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية في تحقيق مثل هذا التوافق العام، في تجسيد لأزمتي الحكم والشرعية وأزمة بناء الدولة، وهذه الأزمات جميعاً هي مظهر من مظاهر التحلل أو الاضمحلال السياسي الذي تعاني منه هذه المجتمعات.
كان هناك إدراك من بعض المثقفين العرب لهذه الأزمة في أعقاب الهزيمة في حرب 1948، ثم الهزيمة بعد حرب 1967، إلا أن هذا الإدراك لم يترجم إلى إعطاء أولوية لمشروع بناء مؤسسات الدولة ومعالجة أزمة الحكم، ويجسد الخلاف الجذري بين رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يدافع، ومنذ انتفاضة الأقصى عام 2000، عن فكرة النضال السلمي غير المسلح من أجل الاستقلال، وعلى استكمال بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية لتكون ركيزة للدولة المأمول في قيامها، وبين رؤية حماس وفصائل المقاومة المسلحة الأخرى التي تعطي الأولوية للكفاح المسلح من أجل التحرير أولاً. إن الكارثة الماثلة الآن أمام أعيننا في غزة لا بد وأن تدفعنا إلى إعادة نظر جذرية في هذه الرؤية، خصوصاً بعد تخلي حركة حماس بوصفها سلطة حكم في غزة عن مسؤوليتها الأساسية كحكومة تعمل من أجل مواطنيها، كما أن المنطقة ليست بحاجة إلى كيان آخر يُجسد أزمة الحكم وبناء الدولة. فالتحدي الحقيقي أمام النخبة الفلسطينية يتمثل في تقديم نموذج جديد مغاير للإطار المؤسسي للهوية الوطنية الفلسطينية، كي يكون جديراً بأن تكون له دولة تتوافر لها مقومات البقاء، وهذا ما نجح المشروع الصهيوني، رغم معارضتنا له وموقفنا منه، في تحقيقه.
إن مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه معظم البلدان العربية، ولن تستطيع كسب معركتها في مواجهة المشروع الصهيوني، الفعلي والمتصور، بدون إنجاز هذه المهمة. على النخب الوطنية في العالم العربي أن تضع يدها على مكامن الخلل الرئيسية في تجربة الدولة الوطنية المستقلة والوقوف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ آلاف الخطط والبرامج والمشروعات التي وضعت لإحداث نهضة اجتماعية واقتصادية ومعرفية، والوقوف على الأسباب الجذرية لهذا المستوى من التردي الذي وصلت إليه والانتباه إلى التدهور السريع لشروط بقائها كاتحاد سياسي يعمل من أجل مواطنيه ولصالحهم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بترسيخ مفهوم دولة المواطنة الدستورية القانونية، التي تقوم على احترام الجميع للدستور والقانون. إن العصف بهذه المتطلبات تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" أو تفضيل المقاتلين على المدنيين في الأمن والحماية، ليس طريقاً لتحقيق هدف التحرر والاستقلال، وإنما طريق مؤكد لاستمرار التآكل والاضمحلال.
حدود الصراع والشرعية الجديدة
على الرغم من صمت الرأي العام العالمي، لاسيما الغربي، على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في الأسابيع الأولى من العدوان على غزة، والذي كان نتيجة لنجاح الدعاية الإسرائيلية في تصوير العدوان على أنه حرب ضد "الإرهاب الإسلامي" الذي تقوده حركة حماس، إلا أن كثيرا من المراقبين يلاحظون، عن حق، أن القضية الفلسطينية استطاعت أن تعود من جديد إلى الصدارة عالمياً، كقضية عادلة تتعلق بحق شعب يكافح من أجل حقه في تقرير المصير، وفي مقاومة الاحتلال ويناضل من أجل الحرية والعودة والاستقلال، وهذا التحول بات يستلزم تطوير رؤية شاملة تؤسس لشرعية جديدة لمشروع التحرر الوطني الفلسطيني تقوم على برنامج وطني فلسطيني يميل إلى الواقعية، ويسعي لتحقيق أهداف محددة وقابلة للتحقق تتمثل في إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس، ويتبنى مشروعاً للمقاومة الشاملة بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون الدولي، مع الاستعداد، في الوقت نفسه للدخول في مفاوضات سياسية واتباع وسائل دبلوماسية وسياسية لتحقيق هذه الأهداف، لكن هذه الرؤية وحدها لا تكفي ما لم يكملها تصور لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها، لا يكون تكراراً لنماذج الدولة الوطنية القطرية في المنطقة التي أثبتت فشلها.
ولا يمكن لمثل هذا المشروع أن يتحقق إلا من خلال تطوير آليات مؤسسية على المستوى الإقليمي، تبدأ بإعادة تعريف لحدود الصراع، فمن الملاحظ ارتباط الحرب الدائرة الآن في غزة بصراعات كثيرة على مستويات متعددة ومتداخلة، داخلية وإقليمية ودولية، كما أن هذه الحرب تنطوي باستمرار على احتمالات قوية لتوسعها إلى حرب إقليمية شاملة تتداخل فيها القوى الدولية، مع ازدياد اشتعال الجبهات في لبنان وسوريا واليمن وإيران، كما أنها تتأثر بالصراع السياسي الداخلي في إسرائيل وفي فلسطين وفي لبنان، وتدور في ظل انقسام واضح في العالم العربي على الموقف من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، باعتبارها جزءاً من مشروع الإسلام السياسي الذي تعتبره كثير من الحكومات تهديدا مباشراً ليس لسلطتها فقط وإنما لوجود الدولة، وحول كيفية التعامل مع إسرائيل إذ يبرز التناقض بين محور التطبيع ومحور المقاومة، الأمر الذي يشير إلى مدى تعقد هذا الصراع واستعصائه على الحل، نظراً لمستوى الخصومة والعداء بين الأطراف المتورطة واحتدام التناقضات فيما بينها.
غير أن التأثير الذي تتمتع به القوى الدولية، لاسيما الولايات المتحدة، ونفوذها القوي في المنطقة يشير إلى أهمية القرارات التي يمكن أن تتخذها لتغيير معادلة الصراع، ويقف المراقبون عاجزين أمام إجابة السؤال عن عدم إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ قرارات أكثر حزماً فيما يتعلق بإجبار إسرائيل على وقف الحرب أو على الأقل منعها من الإقدام على خطوات يدرك الجميع أنها ستقود حتماً إلى توسيع نطاق الحرب والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة لن يستطيع أحد توقع ما قد تؤدي إليه أو أن يتحكم في مسارها. قد تكون الإجابة الوحيدة المحتملة على هذا السؤال هو الحسابات المعقدة بسبب طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها أي تحرك أو قرار. لكن يجب الإشارة إلى أن أزمة الشرعية التي كشفها العدوان على غزة لا تتعلق فقط بشرعية نظم الحكم في المنطقة، وإنما باتت تمس أيضا ما يعرف بالشرعية الدولية، وقد لا يدرك العالم في اللحظة المناسبة وقبل فوات الأوان خطورة استخفاف إسرائيل بهذه الشرعية وتآكلها.
وإذا كان حسم الصراع مع إسرائيل يتطلب إجراء تغييرات واسعة في البيئات الداخلية والإقليمية والدولية، فإن التحرك من أجل تسوية مرضية للأطراف من شأنه يكون مقدمة لإحداث هذه التغييرات ولكن في إطار تعاوني يوفر الأرواح والموارد ويوجهها لخدمة الإنسان، لكن مثل هذه التسوية تحتاج إلى إرادة أخرى مغايرة، كما تحتاج إلى شخصيات تمتلك رؤية للمستقبل ولديها الشجاعة والإقدام اللازمين، وتحتاج إلى تغيير للوعي يحرره من الاستسلام لما يُعتقد أنه قدر حتمي، وهو استسلام لا يؤدي إلى شيء سوى استمرار الصراع وتجدد الحروب واستمرار البؤس والفقر والتخلف للشعوب.
---------------------------------
بقلم: أشرف راضي