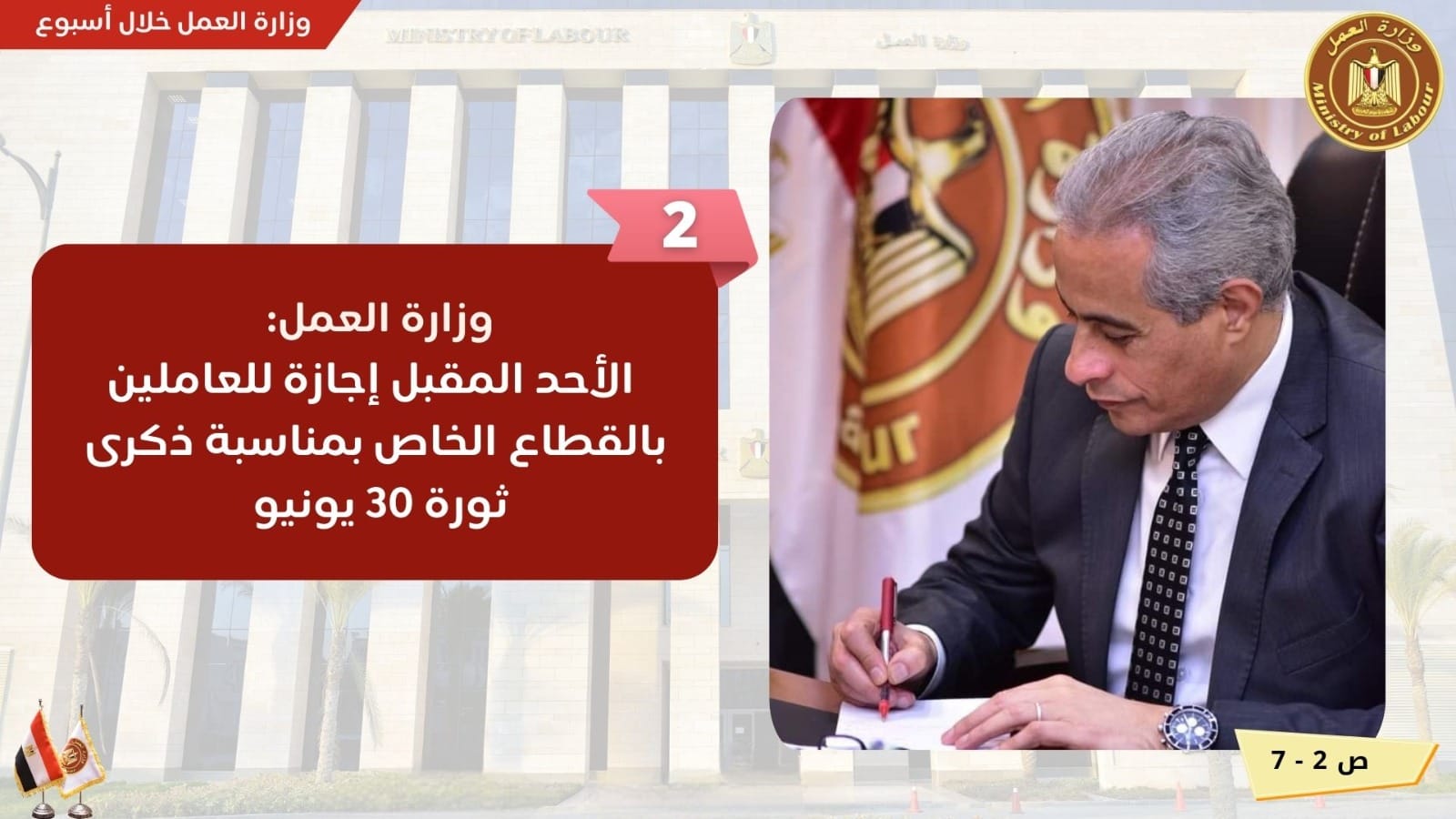يطالبنا الناس أن نكون شجعانا غير هيابين، نكشف الحقائق ونقاوم الفساد ونتصدى لعسف السلطة وننتقد مكامن الضعف ونعري الاستبداد، سواء كان ذلك مجديا .. او عملا سيزيفيا بقصد إراحة الضمير.
ونريد نحن - أقصد مئات ممن ظلوا قابضين على الجمر في الجماعة الصحفية والإعلامية، وليس شخصي - أن نكون أحرارا تماما من أي ضغوط أو مخاوف تجعلنا نؤدي ضريبة الوطنية الحقة، فالصحفي الحر يفعل ما يفعله الجندي أو الضابط المرابط على ثغر، أحدهما بالقلم والآخر بالسلاح، وكلاهما على استعداد دائم لبذل الدم فداء لكرامة واستقلال بلده، يسهر لتنام في أمان ويموت لتحيا عزيزة.
الأعداء كثر والمطامع أكثر، لم يعد الاستهداف غزوا أو احتلالا أجنبيا أو اختراقا خشنا للسيادة، تغير الزمن وتغيرت أدوات سلب الدول وإسقاطها وتحويلها إلى تابع ضعيف ذليل، يستجدي بدل أن يأمر.
الجهل وسوء التخطيط وإهدار الموارد والاستبداد واختيار الأسوأ للمناصب وإفساد حياة الناس وإغراق البلاد في الديون والبطانة السيئة والتفريط في حقوق الدولة وتقزيمها وارتهان الدولة لفئة أو جماعة (أيا كانت هويتها) واحتكار الوطنية والظلم الاجتماعي، كل هؤلاء أعداء حقيقيون أشد خطرا من العدو الظاهر البادي للعيان، فاعتداء الثاني يثير الحماسة الوطنية ويجمع الشعب على هدف ويوحد القلوب ويوقظ الهمم ويشعل النخوة، عكس الأفعال والتصرفات المتسترة بوطنية زائفة - أيا كان فاعلوها والداعون لها والمدافعون عنها – فهي تفرق الشعب وتغرقه في حالة من اللا يقين وفقدان الأمل وقتل الطموح والصدمة المخططة (والتي تجعله يقبل مالا يقبل ويرضى بما كان يفترض أن يثير غضبه).
وسط بحر الظلمات هذا، مطلوب ممن يمارس مهنة الصحافة ويعرف دورها ورسالتها، أن يكون منصفا وشجاعا وفارسا للحقيقة، بينما يتخلى عنه الجميع ويتركونه عريانا، دون سند من سلطة – يفترض أنها الحارسة على مصالح الشعب لا على الكراسي – أو قانون أو نقابة، أو حتى قراء يستطيعون التمييز بين الغث والسمين، والحقيقة من الزيف، والحق من الباطل. الجميع يتركه فريسة سهلة للكيد السياسي والأمنى وضحية لمكارثية ممقوتة، دون أن يشفع له تجرده أو إيثاره لمصالح الوطن على مصالحه الشخصية، وتفضيله لحياة الكفاف على حياة القصور، والتعايش وحيدا منبوذا مع الحقائق المرة، بدلا من الاستئناس بالزيف والخداع والانخراط في قطيع يساق إما رهبة من سيف المعز أو رغبة في ذهبه.
لدينا دستور رائع يحمي حرية الصحافة – ضمن مايحمي من حريات عامة – لكن نصوص هذا الدستور نفسه تواجه بكتيبة من الأعداء، تتفنن في إبطاله وتحويله إلى مجرد نص متحفي، سلطة تخشى النقد ولا ترى من وظيفة للصحافة والإعلام إلا وظيفة المنادي الذي يصدع بالأوامر السلطانية والحاجب الذي يحجب من تلقاء نفسه كل من وما يكدر صفو السلطان – خبرا كان أم بشرا – والسياف الذي ينهال تقطيعا وتشويها على كل من يشار له بالبنان من جانب الحاكم وحاشيته والمتطوعين للسير في ركابه. أما الوظائف المتعارف عليها للإعلام عالميا، من توفير المعلومات والتعبير عن أطياف المجتمع وتلاقح الآراء لصناعة توافق اجتماعي وحماية مصالح المجتمع وإشاعة روح المواطنة، فهي ممقوتة لاتناسب مجتمعنا، فهي في نظر السلطة وتابعيها حروب جيل خامس ومن أعمال "أهل الشر".
القانون الذي كان يحمينا يجري العبث به – بأيدي عدد من أبناء المهنة إمعانا في الكيد – فيسن قانون لقتل الصحافة والإعلام، يعيد الحبس الاحتياطي للصحفيين من باب خلفي، ويمهد لقتل الصحف القائمة، وتحويل الصحفيين إلى موظفين - يسمعون ويطيعون دون تفكير- ويفرض توفيق أوضاع سيدفع الصحف، التي ظلت محافظة على رمق حياة، إلى إغلاق أبوابها وتشريد الآلاف من محرريها.
والنقابة التي كانت - حتى وقت قريب - قلعة للحريات، أصبحت مستأنسة لا تضر ولا تنفع، يجري الالتفاف على إرادة غالبية أعضائها، ولا تجدي معارضة المخلصين من أعضاء مجلسها .. فالتيار أقوى منهم، وهي تتحول على استحياء إلى ذراع من أذرع السلطة، تقبل التكييف القانوني لحبس عشرات من أعضائها – على اعتبار أنهم ليسوا سجناء رأي وإنما سجناء جنائيون – وهذه أكذوبة كبيرة، آخر مثال لها عادل صبري الذي أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة أمرا بإخلاء سبيله بعد حبس احتياطي دام نحو ثلاثة شهور، بتهمة نشر خبر كاذب، لكنه لم يكد يضع قدمه على أسفلت الشارع، حتى وجد نفسه ملحقا بقضية المحور الإعلامي للإخوان (القضية رقم 441 لسنة 2018) ومتهما بالتورط فيها لتبدأ دورة الحبس من جديد.
والقضاء الذي كان سندا وظهيرا لحرية الرأي، أصبح ضحية لمكارثية سياسية غير مسبوقة في مصر، ويكتفي بتقرير كتبه مخبر صغير كدليل يستند إليه في اتخاذ قرار بالحبس – ولو كان تقريرا يدعي أن فلادمير لينين من المتعاطفين مع تنظيم الإخوان أو طابور خامس لهم -.
أما الجمهور العام الذي نتوجه له وندافع عن مصالحه، فحدث ولا حرج، أصبح الناس يشكون في أصابع يدهم – بفعل الصدمة – لو أظهر الصحفي جسارة أو شجاعة وأعلى مهنته على خوفه، فهو متهم بأنه يلعب دور المعارض لصالح السلطة، مع أن السلطة تعتبر مجرد المناقشة كفرا، أو محمي من أعدائها – مع أنهم لايملكون حماية أنفسهم – أو محمي من الخارج، رغم سعادة الخارج بالخراب الذي يجري.
قبل نحو ثلاثة أسابيع كتبت على صفحتي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" داعيا الكتاب الذين تمنع مقالاتهم في الصحف إلى إرسالها للنشر في المشهد، إيمانا بوظيفة الصحافة ورسالتها ويقينا بأن فرض الإظلام التام على بلد لا يفيد غير اللصوص، وفوجئت بتعليق من مثقف كبير يقول: ما هو الدليل على ان المشهد ليست مجرد مكان للصياح والزعيق بحيث يشعر الكاتب بانه خلاص عمل اللي عليه؟ أو قد تكون - والله اعلم - مصيدة تشتغل لحساب الامن؟". صحيح أن الرجل تحلى بشجاعة نادرة واعتذر علنا عما كتب، لكن الطعنة كانت قد نفذت إلى القلب وانتهى الأمر!، وإذا كانت هذه هي الطريقة التي يفكر بها كبار المثقفين، فما بالنا بصغارهم، وما بالنا بغمار الناس الذين لاحظ لهم من ثقافة أو معرفة.
الصحفي الحر – فعليا – أصبح يمارس مهمة انتحارية، إن نجا منها يعيش مهددا طوال الوقت، يضيق به وطنه، وإن لم ينج مات مشيعا باللعنات، حتى من أقرب الناس إليه، فسيقول الجميع: هو من ألقى نفسه في المهالك!
---------------
بقلم: مجدي شندي