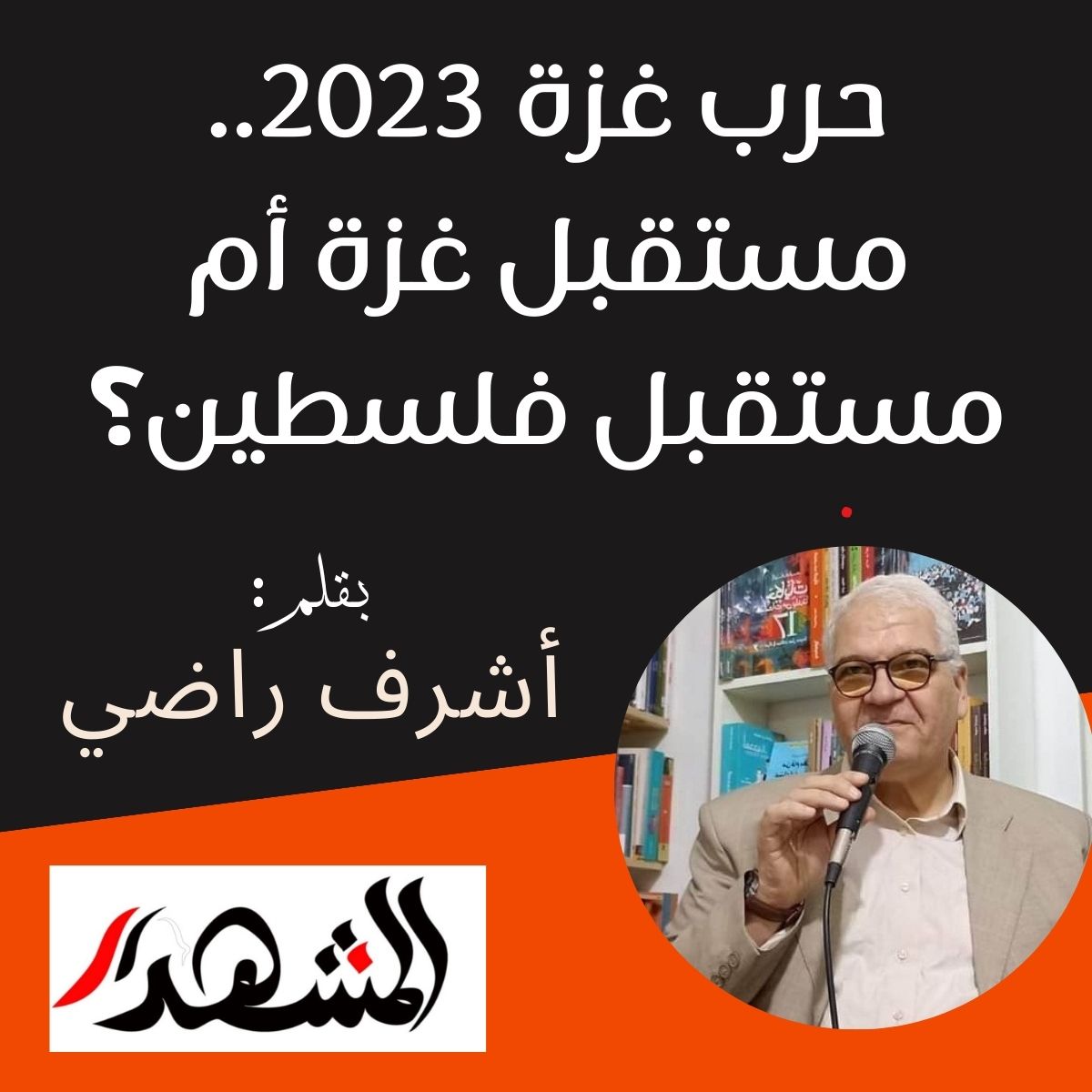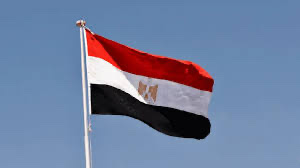لا يختلف اثنان على أن الحرب الراهنة بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تحمل فلسطينيا اسم "طوفان الأقصى" وإسرائيليا اسم "السيوف الحديدية"، تعد علامة فارقة في الصراع الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، ونقطة تحول تاريخية سيكون لها آثار بعيدة المدى، لا تقل في حجمها عن آثار حرب 1948 بين الجيوش العربية والفيالق اليهودية والتي انتهت بما يعرف بالنكبة وقيام إسرائيل على حدودها المعروفة قبل حرب عام 1967، والتي منحت إسرائيل سيطرة على معظم أراضي فلسطين في عهد الانتداب باستثناء الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين خضعتا لإشراف الأردن وقطاع غزة الذي وضع تحت الإدارة المصرية.
كذلك لا يقل تأثير هذه الجولة الأخيرة من جولات الحروب العربية-الإسرائيلية عن الآثار التي أحدثتها هزيمة الجيشين المصري والسوري في حرب عام 1967، والتي انتهت باستكمال احتلال ما تبقى من أرض فلسطين بالإضافة إلى سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، لتنشأ مرحلة جديدة من الصراع. ولم تؤد حرب أكتوبر 1973 والتي حقق فيها الجيش المصري انتصارا محدودا أدى إلى تحرير مساحة من سيناء عبر اتفاقيتي فض الاشتباك الأولى، أو اتفاقية النقاط الست، الموقعة في 11 نوفمبر 1973 واتفاقية فض الاشتباك الثانية، التي وقعت في أول سبتمبر 1975، إلا لإدخال تعديلات طفيفة على خريطة الصراع، إلى أن أعلن الرئيس أنور السادات مبادرته في خطاب تاريخي أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس في نوفمبر 1977، والشروع في نهج لاستكمال استرداد الأرض المصرية المحتلة عبر المفاوضات.
وبغض النظر عن موقفنا من الخطوة التي أقدم عليها السادات وموقفنا من منهجه وتصوره الشامل لحل الصراع مع إسرائيل من خلال الاعتراف الرسمي بوجودها، فإن هذه الخطوة فتحت مسارا موازيا لمسار الكفاح المسلح والحرب وأيضا لمسار حالة "اللاسلم واللاحرب" التي سادت لعقود على كل الجبهات الرسمية في الصراع.
وتخلل هذا الوضع عدة جولات عسكرية تمثلت في اجتياح الجيش الإسرائيلي لبيروت في يونيو عام 1982، وإخراج المقاومة الفلسطينية من بيروت ونقل مقار منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت إلى تونس، وإقامة حزام أمني في جنوب لبنان الذي احتلته إسرائيل ودعمت أثناء احتلالها ميليشيا مسيحية لبنان باسم جيش جنوب لبنان، فيما بدأ حزب الله في الظهور كميليشيا شيعية مسلحة على أنقاض حركة المحرومين وكمنافس للميليشيا الشيعية الرئيسية الممثلة في حركة أمل.
ثم اندلعت الانتفاضة الشعبية الفلسطينية التي عرفت إعلاميا بانتفاضة أطفال الحجارة في ديسمبر عام 1987، وبدء العمليات المسلحة من قبل حزب الله والقوات الفلسطينية المتبقية في لبنان والتي أجبرت إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان في عام 2000، وهو العام الذي شهد أيضا محاولة لاستكمال اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1996 والتي كانت ثمرة لانتفاضة عام 1987 وتطورات إقليمية أعقبت انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في عام 1988، وحرب تحرير الكويت 1991، ثم انطلاق مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.
في الحرب وإدارة الصراع
أحد المشكلات الأساسية لدينا في التفكير هي عدم التمييز بين الصراع والحرب. وهذا التمييز ضروري لسببين: الأول أن الرؤية الواقعية في الفكر السياسي تنطلق من فكرة أن الصراع أحد حقائق المجتمعات البشرية التي يتعين علينا التعامل معها. وأن هذا الصراع منشؤه تعارض المصالح والرؤى بين البشر والتسابق على الاستحواذ على القيم المادية أو فرض القيم المعنوية على الشعوب والجماعات ومقاومة محاولات الفرض.
السبب الثاني، أن الحرب أو اللجوء إلى القوة المسلحة ليست سوى أداة من أدوات إدارة الصراع، فالحرب ليست غاية في ذاتها وإنما أداة من أدوات تحقيق الهدف والذي يمكن تحقيقه أيضا بوسائل أخرى، والمؤكد أن هذه الوسائل الأخرى لها تكلفتها أيضا تماما مثل الحرب.
لا يزال المنطق الحاكم للصراع مع إسرائيل هو منطق إدارة الصراع لا حله.. فمنذ أن طرح وزير الخارجية البريطانية تصوره في عام 1840 عن ضرورة قيام دولة يهودية في فلسطين لمنع قيام دولة عربية كبرى تضم مصر والشام وأصبح الحفاظ على هذا الكيان في منطقتنا مصلحة استراتيجية عليا للمصالح الإمبراطورية للقوى الكبرى، سواء كانت بريطانيا أم فرنسا أو الولايات المتحدة.
إن تغييب هذا البعد للصراع مع إسرائيل واختصار الصراع كله في الدفاع عن المسجد الأقصى يضعف من قدرتنا على إدارة العلاقات مع القوى الكبرى التي هي علاقات محكومة بمنطق الصراع بالضرورة، والأهم من ذلك أنه يضعف من قدرتنا على امتلاك أدوات تحرر إرادة الشعوب والدول وتوسع من الاختيارات المتاحة أمامها ولا تجعلنا ردود فعل لتصور وخطط تعدها القوى الدولية مثلما فعلت في السنوات اللاحقة على الحرب العالمية الأولى، وتحديدا في السنوات ما بين 1917-1922، والتي ساهمت في تشكل الدول العربية المعاصرة بحدودها، وجرى تكريس وضع الدول القطرية هذه من خلال إنشاء جامعة الدول العربية برعاية بريطانية.
لم تكن الدولة القطرية/الوطنية التي تشكلت في ظل الاستعمار البريطاني والفرنسي لدول المنطقة نتيجة لهزيمة تركيا العثمانية في الحرب ونتيجة للتسابق على اقتسام ممتلكات رجل أوروبا المريض في العالم العربي والشرق الأوسط فيما عرف في تاريخ الدبلوماسية والعلاقات الدولية باللعبة الكبرى، متطابقا تماما مع التصورات البريطانية والفرنسية لشكل دول المنطقة التي وردت في تفاهمات وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا التي اشتهرت باسم اتفاقية سايكس-بيكو وإنما لعبت عوامل محلية دوراً كبيراً في تشكيل حدود الدول الراهنة.
فعلى سبيل المثال لعبت ثورة العشرين في العراق دورا في تشكيل العراق بصورته الراهنة وبمكوناته الثلاثة الشيعية والسنية والكردية، وأقيمت إمارة شرق الأردن برعاية بريطانية لتكون العرش الهاشمي الثالث إلى جانب العراق وسوريا ووضعت فلسطين تحت الانتداب مع سياسات ممنهجة لتحقيق وعد بلفور بإقامة "وطن قومي لليهود" في فلسطين وأعلنت الحماية البريطانية على مصر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني منذ عام 1882، ورسمت حدود الدولة المصرية بإشراف بريطانيا وتركيا العثمانية التي كانت قائمة من الناحية الاسمية كمقر للخلافة حتى عام 1923، عندما أطاح مصطفى كمال أتاتورك الضابط بالجيش العثماني بالسلطان عبد الحميد الثاني وألغى الخلافة الإسلامية وأعلن الجمهورية التركية كجمهورية علمانية ذات توجه أوروبي غربي.
كذلك وفرت بريطانيا الحماية لعدد من شيوخ الإمارات على ساحل الخليج العربي في مواجهة التوسع العسكري السعودي لتضع حدا لطموح آل سعود في السيطرة على الجزيرة العربية.
لقد علق المحامي والمؤلف الأمريكي ديفيد فرومكين على السلام الذي فرضه الاستعمار البريطاني والفرنسي على المنطقة بأنه "سلام أنهي كل سلام" في كتاب له بهذا المعني، وهو ما أكدته العديد من الدراسات الفرنسية والبريطانية اللاحقة.
على الرغم من الخلل التأسيسي في الوحدات الأساسية المشكلة للنظام الإقليمي العربي، الذي جسدته جامعة الدول العربية، كمشروع يستوعب حلم الوحدة العربية الذي يراود بعض القوى والشعوب العربية ويحتويه ويكرس في الوقت نفسه الحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية دونما اعتبار لتجانس المكونات الاجتماعية لهذه الدول أو الشروع في برامج فعلية لبناء الدولة في تلك الحدود، على نحو يسمح بدمج هذه المكونات المتنوعة عرقيا وقوميا ولغويا وثقافيا ودينيا في صيغة للدولة الوطنية المؤسسة على حكم دستوري يمنح حقوقا متساوية للمواطنين أمام القانون. إسرائيل ذاتها التي كان من المتصور أن تكون "دولة لليهود"، استنادا للمخيلة الأوروبية التي كانت تنظر إلى فلسطين وأيضا إلى سيناء المصرية، على أنهما "أرض بلا شعب" تعين عليها استيعاب من صمد على الأرض من الفلسطينيين العرب لتصبح هي أيضا كيان متعدد الهويات القومية والثقافية.
وازداد الأمر تعقيدا مع تباين الخلفيات الثقافية والقومية لليهود الذين هجروا من بلادهم ليعيشوا في فلسطين التي جرى تقسيم أرضها في عام 1947 بين اليهود والعرب. لقد أوجد هذا الواقع المتعدد الهويات مع تأزم مشروع بناء دول دستورية حديثة في المنطقة إلى موجات لا تنتهي من الصراعات التي يجري تأجيجها أو تخفيضها حسب المصالح المتغيرة للقوى الاستعمارية الكبرى التي لم تكف عن التدخل الممنهج والمستمر في شؤون المنطقة وتدير صراعاتها.
عبء الجغرافيا السياسية
يمكن القول بأن شعوب المنطقة وقعت ضحية للعبة الاستعمارية الكبرى وللوضع الاستراتيجي للمنطقة والذي يجعلها ركيزة أساسية للطموحات والأحلام الإمبراطورية. وأصبح النظام الإقليمي العربي يوصف في أدبيات العلاقات الدولية بأنه من أكثر النظم الإقليمية الفرعية اختراقاً، الأمر الذي يعني التدخل المستمر وبأدوات مختلفة ليس فقط في الشؤون الخارجية ما بين دول المنطقة وإنما أيضا في السياسات الداخلية وبناء التحالفات الخارجية للنخب الحاكمة.
وساعد هذا الوضع المعقد على رواج نظريات المؤامرة في تفسير كل أحداث المنطقة الرئيسية والتافهة. ولم تسلم عملية "طوفان الأقصى" الراهنة من نظرية المؤامرة. الخطورة في نظريات المؤامرة أنها تسلب من الشعوب إرادتها وقدرتها على التحرك وامتلاك أدوات الصراع.
والقوى الاستعمارية التي تدير الصراع في المنطقة في كل حالاته وأطواره بما في ذلك العنف والحروب، هي المستفيد الأكبر من رواج هذه النظريات التي تدجن الشعوب وتخضعها لإرادتها. فثورات الربيع العربي، التي شكلت لحظة من لحظات نهوض الشعوب العربية من سباتها الطويل، جرى تصويرها على أنها مؤامرة أمريكية وغربية لتفتيت دول المنطقة لصالح مشروع إقليمي كبير يخضع لسيطرة إسرائيل باعتبارها وكيل لتلك القوى الاستعمارية.
وأخطر ما في نظريات المؤامرة أيضا أنها تغيب العقل وتجعله أسير جملة من الغيبيات الحتمية وتعوق التنوير باعتباره استعمالا للعقل بجرأة. والحداثة أيضا بكل ما تحمله من قيم لبناء الأمم والدول على أسس من المساواة بين الأفراد في الحقوق والفرص تصبح مرفوضة، فقوى الحداثة التي ظهرت في تركيا بتأثير غربي هي المتهم الأول في سقوط الخلافة العثمانية، وتباكت قطاعات من النخب عندنا على انهيار الخلافة العثمانية رغم مسؤوليتها المباشرة عن التأخر الشديد الذي عانت منها الشعوب التي خضعت لها.
إن عبء الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية هو العامل الرئيسي الذي دفع نابليون بونابرت لغزو مصر في عام 1797 في سياق صراع فرنسا مع إنجلترا. وكانت الحملة الفرنسية على مصر بمثابة الصاعقة التي أحدث صحوة لدى المصريين ليفيقوا لأول مرة من سباتهم الطويل الأمر الذي مهد لمشروع الدولة الحديثة التي نشأت مع تولي محمد علي الحكم، وبدء مشروعه التوسعي حتى تحالفت عليه القوى بريطانيا وفرنسا والقوى الكبرى وهزمته في موقعة نافارين البحرية في عام 1827، لتفتح الطريق أمام احتلال مصر.
وكرست الحملة الفرنسية الوضع الاستراتيجي للمنطقة من منظور الجغرافيا السياسية. إن الخروج من هذا الوضع وتغيير معادلة الصراع مع إسرائيل نتيجة لتراكم الخبرة وامتلاك قدرات أكبر لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يتطلب منا رؤية جديدة للصراع وأساليب إدارته وتحديد ملامح ومقومات تلك الرؤية، وهو موضوع المقال التالي..
-------------------------------
بقلم: أشرف راضي