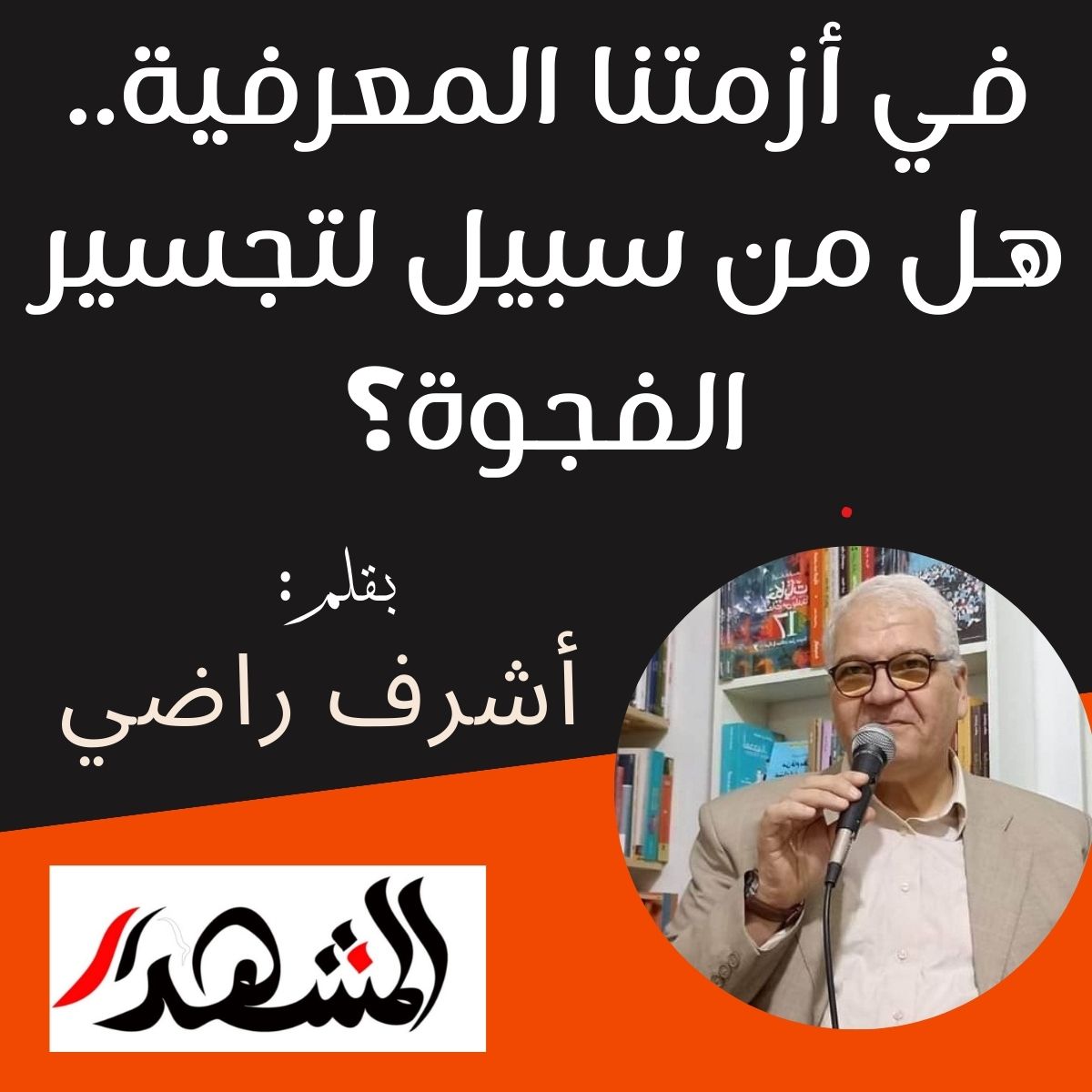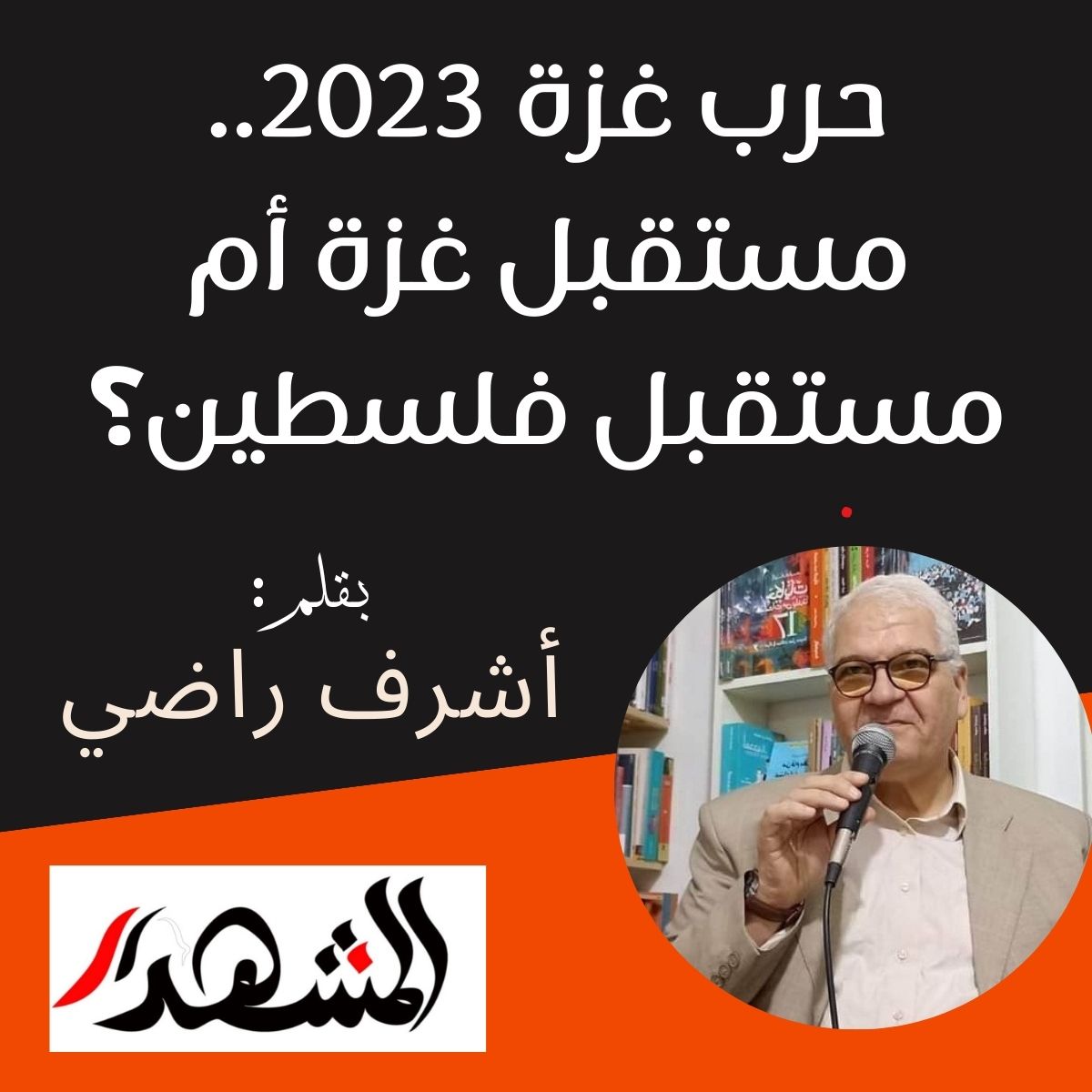يُعد سؤال المعرفة من الأسئلة المؤرقة في كل البلدان العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج، وفي القلب منها مصر، على الأقل خلال العقدين المنصرمين، وتحديداً، بعدما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2002، إلى نقص المعرفة كأحد أبرز ثلاثة أوجه للقصور الذي تعاني منه تلك البلدان. ونظراً لأن المعرفة ركيزة أساسية لأي برنامج إصلاحي وتنموي، فقد كانت المعرفة وبناء مجتمع المعرفة موضوع تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني الصادر في عام 2003، والذي قدم تقييماً شاملاً لحالة المعرفة في العالم العربي آنذاك، وتطرق إلى المعوقات التي تحول دون اكتساب المعرفة ونشرها، أملاً في يوم يصبح فيه التعلم والبحث قوة الدفع المحركة للإبداع الاجتماعي والاقتصادي في دول المنطقة.
صدر التقريران في وقت بلغت فيه أزمة العالم العربي المركبة ومتعددة الأبعاد، حداُ باتت معه تشكل خطراً على العالم، أو هكذا كان يرى العالم في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، التي وضعت العرب والمسلمين في مواجهة مع العالم الغربي، بل والعالم بأسره، نتيجة انخراط جماعات نشأت ونمت في المنطقة، وانطلقت منها، في عدة هجمات عنيفة استهدفت مراكز حضرية في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية وفي مناطق متفرقة من آسيا وفي منطقة الساحل الأفريقي، والتي نعتها الخطاب الغربي بالإرهاب. لكن مراكز التفكير الغربية لم تكتف بالخطاب والاستراتيجيات والسياسات الأمنية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد نمط الحياة فيها، بل راحت تفتش في جذوره وأسبابه، وتبلور ما يشبه الإجماع على أن أحد الأسباب الأساسية في ظاهرة العنف المنطلق من أيديولوجية دينية في المنطقة، هو فشل الدولة ما بعد الاستعمارية في إحداث التنمية في هذه المجتمعات وزيادة الفجوة فيما بين العالم الأول والعالم الإسلامي، على كافة المستويات.
إن اهتمام هيئة الأمم المتحدة بهذه المشكلة ودراستها للوقوف على أبعادها المختلفة وأسبابها وسبل معالجتها كان أمرا متوقعاً في سياق تطور الوعي العالمي بأن تحقيق التنمية يُعد شرطاً أساسيا للاستقرار على المستويين الوطني والمحلي. ونَهَج البرنامج الإنمائي التابع للمنظمة الدولية مسلكاً مختلفاً عن المسلك الذي سارت فيه مراكز التفكير الغربية، في بحثه للمشكلة وتحليلها، فشكل فريقاً من الباحثين والمفكرين العرب لإصدار سلسلة من تقارير التنمية الإنسانية العربية، لتسليط الضوء على قضايا ومشكلات التنمية الإنسانية في منطقة لها خصوصيتها الثقافية، ولم تكتف بالقسم المخصص لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقاريرها عن التنمية الإنسانية في العالم. إن فهم الآلية التي عمل بها تقرير التنمية البشرية العربية مدخل مهم لفهم طبيعة أزمة المعرفة في العالم العربي في سياقها العالمي، من ناحية، ولاستشراف إمكانات طرح الفجوة المعرفة للنقاش وإيجاد حلول عالمية في هذا السياق من ناحية أخرى.
ويُعد تقرير التنمية الإنسانية العربية نقطة انطلاق ملائمة لإعادة فتح النقاش حول أزمتنا المعرفية، سواء في مصر أو في البلدان العربية الأخرى، التي تتطلع شعوبها لمستقبل أفضل. ومقارنة حالة المعرفة في الوقت الراهن بما كانت عليه قبل 20 عاماً على المستوى العالمي وعلى المستويين الوطني والإقليمي، في ظل الانفجارات المعرفية الكبيرة التي يشهدها العالم بشكل متسارع في السنوات القليلة الماضية وهو يتهيأ للدخول في عصر الذكاء الاصطناعي، وغيره من تطورات تبشر بدخول المجتمعات البشرية لعهد جديد لم تعرفه من قبل.
أين نحن من هذه الثورات المعرفية والفكرية، وما هو موقعنا على الخريطة المعرفية التي ترسم حدوداً جديدة لعالم الغد؟ وهل ساعدتنا الأدوات الجديدة لمجتمع المعرفة العالمي في اللحاق بالثورة المعرفية الكبرى التي يشهدها العالم، وهل أدى ذلك إلى تجسير الفجوة التي كانت قائمة قبل 20 عاماً بين المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية، أم أدت إلى تعميقها؟ وهل كان للوعي الذي أحدثه صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول والثاني تأثير في زيادة وعي النخب العربية الحاكمة بهذه القضية وكيف كانت الاستجابة؟ وهل التطورات التي شهدها العالم العربي في السنوات العشرين الماضية تبشر بأننا نمضي في الطريق لتحقيق الهدف المنشود، الذي حدده التقرير الثاني وهو أن يصبح التعلم والبحث القوة المحركة للإبداع في دول المنطقة؟
هذه أسئلة نطرحها للنقاش العام، تتجاوز إجاباتها حدود هذا المقال، وتستدعي منا نقاشاً عاماً وموسعا، عبر الأطر والمنابر المختلفة، وهذا المقال ليس سوى مساهمة متواضعة في هذا النقاش المأمول، تكمل ما بدأته في مقالي "القوى الناعمة" و"أزمة الثقافة والفكر"، وتتبعه مقالات أخرى تسلط الضوء على الجوانب المختلفة للأزمات التي نعاني منها، أملاً في أن تكون هذه الأزمات نقطة تحول نحو عصر جديد يدخلنا مرة أخرى إلى التاريخ بعد أن غادرناه لقرون تحت وطأة الاستبداد بصوره المختلفة وإغلاق العقل والاجتهاد وما أدى إليه ذلك من تدهور شديد في الشروط الإنسانية للحياة الكريمة والتي لم تعد مجالاً لمناقشات نظرية بل أصبحت قابلة للقياس بمؤشرات كمية يجري تطويرها وتحسينها في كثير من الهيئات العالمية، بل تحولت إلى برامج لها مستهدفات محددة يمكن رصدها للوقوف على ما في سبيل تحقيقها.
إن نظرة سريعة على طبيعة النقاشات الدائرة الآن في وسائل الإعلام العامة والمنتديات الثقافية والمحافل العلمية في العالم ومقارنتها بالخطاب العام السائد في مجتمعاتنا، لا بد وأن تثير لدى أي مثقف أو مفكر أو حتى متعلم، يشغله سؤال المستقبل ويتطلع إلى تقدم مجتمعه قدرا كبيرا من القلق، بل الانزعاج. لا يتعلق الأمر هنا بخلافات ثقافية وقيمية بين مجتمعاتنا وبين المجتمعات الغربية، ولا بخصوصيتنا الثقافية وهويتنا الدينية، وإنما يتعلق الأمر بأزمتنا المعرفية التي تضعنا خارج سباق الأمم من أجل التقدم والمستقبل، وهو سباق تنخرط فيه مجتمعات متباينة ثقافياً وقيمياً، فلم يعد مقبولاً بأي حال تصدير مسألة الخصوصية الثقافية لتبرير افتقار مجتمعاتنا لشروط العيش الكريم الذي يجسده مؤشر إشباع الاحتياجات الأساسية، وهو المؤشر الذي ضمن لكثير من المجتمعات الانتقال من الانشغال بمسألة البقاء إلى الانشغال بمسألة التحقق وإثبات الذات.
في عام 1967، وتحديداً بعد هزيمة الخامس من يونيو، كتب الصحفي والمفكر المصري الراحل، أحمد بهاء الدين، مقالاً يحلل الهزيمة وأسبابها تحليلا علميا ومنطقيا، في وقت ذهب فيه كثير من الشيوخ والفقهاء، بل وبعض المفكرين، في اتجاه معاكس في تحليل أسباب الهزيمة التي لخصوها في ابتعاد المجتمعات العربية عن الالتزام بالدين وقيمه. لقد أشار بهاء الدين بوضوح إلى أن الهزيمة العربية في حرب يونيو 1967، لا يمكن فصلها عن مجمل أوضاع المجتمع، ودعا إلى ضرورة "تطوير أوضاعنا ونظمنا ومؤسساتنا".وزادته الهزيمة اقتناعاً بأن أن التنمية يجب أن تقوم على المجتمع المعرفي، وبضرورة الأخذ بالمنهج العلمي وبالمعرفة. لقد أرجع بهاء الدين الهزيمة إلى عدم بلوغنا مرحلة الدولة العصرية، فيما دعا آخرون إلى ضرورة التراجع عن مشروع الدولة العصرية هذا، والترويج لحلم استعادة تاريخ ولّى، والتطلع إلى نهضة ماضية متخيلة، دون تدقيق لتقييمها ودون معرفة كافية بالتجربة التاريخية التي تثبت أن المعرفة والعلم أحد شروطها ومقوماتها الأساسية. إن الفجوة الهائلة بين التقدم العلمي وثورة المعرفة وبين ما نحن فيه إلى الآن، أمر لم نعد نملك رفاهية السكوت، إنها مسألة مصير ومستقبل.
بناء مجتمع المعرفة وأزماته
إن سهولة حصول الأجيال الجديدة على المعرفة، نتيجة لثورة الاتصالات والمعلومات، وما ترتب عليها من نتائج كبيرة على مستوى المعلومات والوعي والتنظيم والحركة، على النحو الذي رأيناه في انتفاضات الربيع العربي، لا تعني أن تلك المجتمعات العربية اجتازت فجوة المعرفة، ذلك أن افتقار قوى التغيير للأفق المعرفي كان أحد الأسباب الرئيسية لفشل تلك الانتفاضات، في رأي كثير من المراقبين. فمن ناحية، أوجدت السهولة في الحصول على المعلومات مشكلات تفوق كثيراً ما وفرته من حلول. ومن ناحية أخرى، هناك مشكلة في اكتساب المعرفة وانتشارها أو حسن توظيفها واستغلالها لترشيد اتخاذ القرارات، الأمر الذي لفت النظر إلى أهمية مجتمع المعرفة ونبه إلى ضرورة بنائه وأهميته لإنتاج المعرفة وهي عملية وثيقة الصلة بقضية التعليم والبحث العلمي. من ناحية ثالثة، خلصت دراسات كثيرة إلى أن أزمة بناء مجتمعات المعرفة في العالم العربي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزوع الاستبدادي للسلطة وما يستلزمه ذلك من قتل لإرادة المقاومة لدى الجمهور. هذه النقطة تحتاج إلى استطراد لأنها تشكل سبباً جذرياً يتصل بالعلاقة المتأزمة بين السلطة وبين المثقفين وهي مسألة تعود إلى قرون.
إن العلاقة بين السلطان وبين المثقف لم تكن على ما يرام طوال تاريخ منطقتنا. فالسلطة كانت ولا تزال تنظر إلى المثقف بعين الشك والريبة، نظراً لامتلاكه أدوات وآليات للتأثير في وعي الجمهور من خلال ما يملكه من معرفة، وخشيتها أن يُشكل هذا التأثير عقبة أمام تنفيذ سياساتها. والسلطة، خصوصا إذا كانت سلطة مستبدة، تخشى دوما من استقلالية المعرفة وحرية التفكير والإبداع، ذلك أنها تدرك أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتشار الأفكار التحررية في المجتمع، كما تدرك أن امتلاك المعرفة والوعي يقلص من سطوتها على المجتمع. وعليه فإن السلطة تتعامل مع الفكر الحر بمنطق الرقابة والاحتواء، وتمارس نهج الاقصاء والتهميش في حق ذوي الكفاءات العالية، من المثقفين والمتعلمين وهذا يقلص من النشاط المعرفي في المجتمع. وعلى الرغم من إدراك السلطة، بما في ذلك السلطة الاستبدادية، أهمية بناء مجتمع المعرفة، الذي أصبح هدفاً رئيسيا لكل برامج التنمية في الدول العربية، إلا أنها لم تعدل من موقفها من الثقافة والمثقفين، ومن ثم لم يطرأ تغير كبير على وضع المعرفة في تلك البلدان التي تخضع لأنظمة حكم استبدادية على الأغلب، بل وضع المعرفة ازداد تأزماً لغياب هامش الحرية الضروري للبحت العلمي والافتقار للمناخ الثقافي الحي الذي يقضي على الجهل والأمية، وهو ما تؤكده المعطيات الواردة في التقارير التي ترصد حالة المعرفة وفق مؤشرات محددة قابلة للقياس.
حتى في حالة السلطة الاستبدادية المستنيرة التي تسعى جاهدة لتطوير البنى التحتية اللازمة لربط مجتمعاتها بالثورة المعرفية الراهنة، والاستفادة من ثورة المعلومات، على النحو الذي يقدمه نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة، قد لا يُحدث تحولاً جذرياُ في جسر الفجوة المعرفية، ولا يساعد في نشر ثمار المعرفة للمجتمع، وكل ما قد ينتجه هو جزر متقدمة مرتبطة بحركة المعرفة والعلم في العالم وسط محيط من الجهل والأمية على النحو الذي تكشفه التقارير الصادرة عن حالة المعرفة في العالم العربي، والتي تكشف عن تدنٍ شديد في مستويات التعليم ومعدل القراءة السنوي، الذي لا يتجاوز في أفضل التقديرات كتابا واحدا لكل 20 ألف مواطن، وهو وضع مزرٍ وبائسٍ مقارنة بمعدلات القراءة في دول مثل انجلترا وإسبانيا، إذ يقدر عدد قراء الكتاب الواحد ببضعة مئات، تتراوح بين 500 ونحو 800 قارئ للكتاب الواحد. وعلى الرغم من أن تطور المكتبات الإلكترونية والمواقع التي تتيح لمستخدميها قراءة الكتب والدراسات والتقارير، لم تدخل تحسينات كبيرة على الوضع. والمؤشرات فيما يتعلق بجودة التعليم الجامعي التي تعدها جامعة جياو تونغ الصينية في شنغهاي تشير إلى أنه لا توجد جامعة عربية واحدة بين أفضل 500 جامعة في العالم وأن متوسط تكلفة الطالب في الجامعات العربية لا تتجاوز 2500 دولار في السنة مقابل 45000 دولار في بعض الجامعات الغربية. والوضع أسوأ إذا ما نظرنا إلى مساهمة البلدان العربية في براءات الاختراع والتي تعد هزيلة مقارنة مع دول مثل كوريا الجنوبية، وكذلك الحال في انتاج البحوث والكتب.
وبالتركيز على الحالة المصرية، التي تهمنا بالأساس، فإن نتائج المؤشرات الخاصة بالمعرفة وبالتعليم العام قبل الجامعي والتعليم الجامعي لا تبعث على التفاؤل، وفقاً لمؤشر المعرفة العالمي الذي تصدره مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"والذي يصنف الدول وفقا للمؤشر العام للمعرفة ويرتبها من حيث التعليم قبل الجامعي، وهو مؤشر بالغ الأهمية لأنه يقيس "رأس المال المعرفي" والبيئة التعليمية وإذا كانت تتيح فرصاً متكافئة وتمكن الأفراد في المجتمع والتعليم العالي والتعليم الجامعي، والبحث والتطوير والابتكار، من حيث الانفاق ومن حيث المساهمة، بالإضافة إلى حالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد تراوح ترتيب مصر في هذه المؤشرات جميعاً بين 90 و94 من بين 140 دولة على مستوى العالم، ولا يبعث ترتيب مصر عربياً وإقليمياً على الارتياح. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات التي تستند إلى قياسات دقيقة لعدد كبير من المتغيرات، على أهميتها، لا تعكس بشكل دقيق حقيقة الموقف فيما يخص حالة المعرفة، والتي من المتوقع أن تزداد تدهورا في ظل الثورة الناجمة عن التطورات الحادثة على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تراكم قدراً هائلاً من البيانات والمعلومات بمعدلات أسرع بكثير، الأمر الذي يعمق الفجوة المعرفية.
وأشار تقرير "بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية: اللغة العربية بوابة المعرفة"، الصادر في 2019، عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى تأثير عامل اللغة في بناء مجتمع المعلومات محذراً من تأثير تراكم المعلومات باللغة الإنجليزية التي غدت لغة مهيمنة في العالم نتيجة لثورة المعلومات على وضع اللغة العربية في هذا الصدد، مشيراً إلى أن التهميش المتزايد للغة العربية سيكون له تأثير كبير على انتشار المعرفة وإنتاجها في المنطقة العربية، ويعمق الانقسام داخل هذه المجتمعات بين قلة تجيد اللغات الأجنبية وقادرة على التعامل مع مصادر المعلومات وتوظيفها والاستفادة منها وبين أغلبية فقيرة ومحرومة من هذه الإمكانيات. وهو وضع يجب أن يدفعنا إلى التفكير في أدوات ووسائل للتغلب على هذه الفجوة التي تترك الجمهور العريض في العالم العربي ضحية للجهل والخرافة، وهو أمر له انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويشير إلى صعوبة إن لم يكن استحالة بناء مجتمعات للمعرفة ومن ثم اقتصادات للمعرفة، الأمر الذي يزيد الفجوة بين الشعوب العربية وشعوب العالم.
تمكين الشباب معرفيا هو سبيلنا للخروج من النفق المظلم
لا يمكن التفكير في مستقبل مختلف ومسار مختلف للعالم العربي دون إعادة نظر جذرية في الهياكل الاجتماعية والسياسية القائمة التي تؤدي إلى هدر كثير من الموارد وتبديد طاقات هائلة، والدفع بالشباب إلى صراعات قاتلة نتيجة لتأزم الأوضاع السياسية والاجتماعية. إن معظم الدراسات التي تتصدى لموضوع الانتقال إلى مجتمعات المعرفة، يتطلب جودة عالية في نظم التعليم والتكوين، وتراكم منتجات البحث العلمي والتطوير التقني، ويحتاج إلى قدرات فائقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز للبيئات التمكينية التي تشكل السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتحقيق هذه المكونات. وعلى الرغم من أن جيل الشباب اليوم في البلدان العربية، يُعد أكثر تعليماُ ونشاطاً وارتباطاً بالعالم الخارجي، الأمر الذي انعكس على وعيهم بواقعهم وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل، إلا أن النتائج المتوقعة من هذا التطور في وعي الشباب يصطدم بواقع يؤدي إلى تهميشهم، كما أن انسداد قنوات التعبير والمشاركة الفعَّالة في وجوههم، وتقلص فرص كسب العيش بسبب ارتفاع معدلات البطالة وغياب تكافؤ الفرص، يؤدي إلى تنامي مشاعر الإحباط في أوساطهم مما يتسبب في دفعهم إلى التحول من طاقة هائلة للبناء إلى قوة كاسحة للهدم.
إن الموقف السلبي الذي تتخذه أنظمة الحكم القائمة في العالم العربي من انتفاضات عام 2011، وعدم قدرتها على التمييز بين ما كانت تشير إليه هذه الانتفاضات وبين موقفها من سعي قوى الإسلام السياسي المنظمة من الاستفادة من هذه الانتفاضة ومشاعر الاستياء التي كانت دافعا وراءها، يضيع فرصة، لا تزال سانحة في تقديري، للاستفادة مما عبرت عنه تلك الانتفاضات والتي تشير إلى قدرة الشباب على المبادرة بالفعل وعلى تحفيز التغيير والاستفادة من حالة الوعي التي عبروا عنها بخصوص الأوضاع العامة القائمة وما تفرضه من تحديات خطيرة للتنمية. وبدلا من تعزيز قدرة الشباب على التعبير عن عدم رضا المجتمع ككل عن الأوضاع القائمة، جرى تقييد هذه القدرة ومطاردة الشباب، الذي هاجر معظم النابهين منهم إلى الخارج، وملاحقة المطالبين منهم بضرورة تغيير هذه الأوضاع من أجل مستقبل أفضل؛ وتغييب قطاعات واسعة منهم وتهميشهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وحرمانهم من أدوات العمل السياسي المنظم التي تضمن التغيير السلمي واستدامته، وهي جميعاً أمور حذر منها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2016، الذي نبه إلى أن حصر الاستجابة لمطالب التغيير بالتعامل الأمني دون التصدي لمعالجة أسبابها، والالتفات إلى التحديات وفي مقدمتها تحدي المعرفة، يؤجل دورات الاحتجاج فحسب ولا يقلل من فرص تكرارها، بل يؤدي إلى تراكمها لتعود إلى الظهور بأشكال أكثر عنفاً، حتى وإن تحقق الاستقرار فإنه يكون مؤقتاً وقصير الأجل.
من شأن الدفع بتحدي المعرفة إلى النقاش العام والمفتوح حول أوضاعنا السياسية والاجتماعية، من شأنه أن يفتح مساحات أرحب للخروج من المأزق الحالي الذي تعاني منه المجتمعات العربية، إن نظرة عامة على الصراعات الدائرة الآن في مناطق مختلفة من العالم العربي، بما في ذلك العدوان المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي اليمن وفي ليبيا والسودان ولبنان وسوريا، يشير إلى الخطر المحدق بمستقبل هذه المنطقة، إذ يعد الشباب الممتلئ بالطاقة والعنفوان الوقود الأساسي لهذه الصراعات. والخروج من هذا المأزق يتطلب إلى إعادة نظر جذرية في الثروة البشرية الهائلة التي تمتلكها دول المنطقة والنظر إليهم كركيزة أساسية للتنمية وأساس لرأس المال بمفهومه الشامل، والذي يتجاوز الأموال التي يجري اقتراضها، وهدرها فيما لا يفيد من مشروعات لن تجد من يستغلها ويطورها.
------------------------------------
بقلم: أشرف راضي