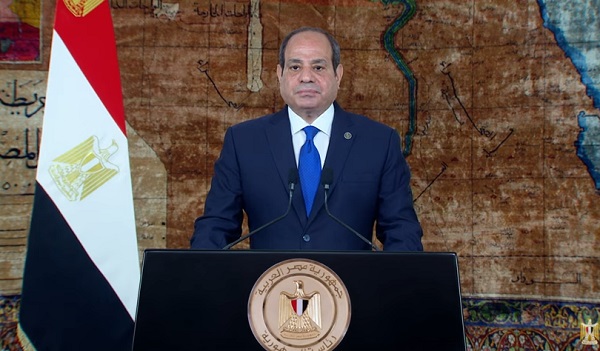في مقالةٍ لافتة نُشرت بجريدة الأهرام (تحت عنوان «نداء إلى باشوات مصر»)، بتاريخ 10 إبريل، طرح الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والمفكر السياسي المخضرم، فكرةً استفزازيةً تثير الجدل حول الهُوية والسلطة في مصر المعاصرة- إعادة الألقاب المدنية، وعلى رأسها لقب "باشا"، لكن بصيغةٍ مُنظمة تخضع لمعايير موضوعية، تُمنح على إثرها هذه الرتب لرجال الأعمال والمُبدعين الذين يُسهمون بإنجازاتٍ جليلة في خدمة المجتمع..
وبرغم أن اقتراحه يبدو للوهلة الأولى حنين إلى ماضي ملكي باذخ، إلا أنه يحمل في ثناياه رؤيةً نقديةً لأزمة التكريم في النظام الاجتماعي الحديث، حيث يرى أن إلغاء الألقاب عام 1952، وإن كان ضرورةً ثوريةً لتفكيك الإقطاع، إلا أنه أفقد المجتمعَ آليةً رمزيةً لتقدير النخبة المنتجة، التي يُمكن أن تكون حافزًا لتعزيز المشاركة العامة للأثرياء، على غرار نظام الألقاب البريطاني (كاللقب الفخري "سير" الذي حمله الدكتور مجدي يعقوب)..
لكن مقال الغزالي حرب لا يخلو من سخريةٍ ذاتية حين يُطلق على نفسه لقب "أسامة أفندي"، في إشارةٍ إلى التناقض الذي يعيشه المجتمع المصري بين رفض الألقاب رسميًّا وتداولها شعبوياً، اقتراحه – الذي يدعو إلى تكريم أسماء مثل "نجيب باشا ساويرس" أو "طلعت باشا مصطفى" – يفتح بابًا فلسفيًّا حول علاقة الرأسمالية بالهُوية، ومدى قدرة الرموز التاريخية على إعادة تشكيل الولاءات الطبقية في عصرٍ تُهيمن فيه القوة الاقتصادية على الخطاب الاجتماعي..
فهل تُعيد الألقابُ تعريفَ "المواطنة" لتكون مرتبطةً بالإنجاز المادي لا بالانتماء الثوري؟ أم أنها تُكرِّس انقسامًا جديدًا بين "باشوات المال" و"الجماهير" في زمنٍ تُعيد فيه الرأسمالية العالمية إنتاجَ أشكال الإمبراطوريات القديمة تحت عباءة العولمة؟ هذا الاقتراح برغم بساطته الظاهرة، يُلامس أسئلةً وجوديةً عن دور الرمز في صناعة الشرعية، وعن التوتر الأبدي بين المساواة والتميُّز في المجتمعات التي تتخبط بين حداثةٍ ناقصة وتراثٍ مُعَادٍ للحداثة . فالباشوية الجديدة – كما يُصورها الغزالي حرب – ليست مجرد لقب، بل هي استعارةٌ لصراعٍ أعمق: هل يُمكن تحويل رموز السلطة القديمة إلى أدواتٍ لتكريس قيم الجمهورية؟ أم أن العودة إلى هذه الرموز هي اعترافٌ ضمنيٌ بفشل المشروع الثوري في خلق بديلٍ ثقافيٍ قادر على تجاوز إرث الإمبراطوريات؟ ..
وفي سياق فلسفة التاريخ، تُعيد هذه العودة إنتاجَ "أسطورة العظمة" التي تعتمدها الدول لتعزيز شرعيتها، فاستدعاء الألقاب القديمة قد يُفسَّر كاستراتيجية تأويلية تهدف إلى ربط الحاضر بماضٍ مُتخيَّل، حيث تُقدَّم السلطة كاستمراريةٍ لمجدٍ تاريخي، مما يُضفي عليها هالةً من القداسة والاستقرار، وهنا يلعب اللقب دورَ أيقونة ثقافية تذكِّر بمرحلةٍ كانت فيها مصر مركزًا إقليميًّا مهيمنًا، وهو ما يتوافق مع الخطاب السياسي المعاصر الذي يرسم صورة مصر كقلعةٍ حامية في محيطٍ مضطرب، ولكنَّ هذا الاستدعاء لا يخلو من تناقضٍ مع مبادئ الجمهورية التي قامت على إلغاء الامتيازات الطبقية، مما يفتح باب النقاش حول حدود التوفيق بين الحداثة السياسية والتراث الرمزي..
ومن منظور مدرسة "ما بعد الكولونيالية"، قد تُعتبر عودة الألقاب تعبيرًا عن أزمة الهُوية في مجتمعاتٍ تسعى لاستعادة شرطها الثقافي بعد صدمة الاستعمار، فلقب "باشا" - بوصفه لقبًا ذا جذورٍ عثمانية وأوروبية (حيث اُعتمد لاحقًا في بروتوكولات القرن الـ١٩) - يجسِّد التمازجَ بين الموروث الشرقي والغربي الذي طبع النخبة المصرية، مما يجعله مرآةً لصراع الهُوية بين الانتماء العربي - الإسلامي والتأثيرات الغربية، ولكنَّ اللقب في الوقت ذاته، قد يُقرأ كمقاومةٍ رمزية لخطاب العولمة الذي يُهيمن على الثقافة المعاصرة، عبر التشبث بعلاماتٍ محلية تُعيد تعريف "المصري" في مواجهة النموذج الكوني المُعولم..
المقترح في الميزان: بين النوستالجيا وإدارة الرأسمالية
يستند طرح الغزالي حرب إلى ثنائيةٍ مثيرة: من ناحية، يرى أن الألقاب تشكل حافزًا نفسيًا واجتماعيًا لإشراك النخبة الاقتصادية في الحياة العامة، ومن ناحيةٍ أخرى، يُلمح إلى أن المجتمع المصري – بغناه الثقافي – قادرٌ على استيعاب هذه الرموز دون أن تسقط في فخ الامتيازات الطبقية، ولكن هذا الطرح يطرح إشكاليةً فلسفيةً حول مفهوم "الجدارة" في عصر الرأسمالية العالمية:
- هل تُمنح "الباشوية" الجديدة بناءً على معايير اقتصادية صرفة (كحجم الثروة)؟ أم على أساس إنساني (كالإسهام في العمل الخيري)؟
- وهل يُمكن فصل "التكريم" عن "التسييس" في مجتمعٍ تتداخل فيه السلطة الاقتصادية بالسلطة السياسية؟
- وأخيرًا، ألا يُعيد هذا النظام إنتاجَ نموذج "الباشا الإقطاعي" الذي ثارت عليه الجمهورية، وإن بثيابٍ حديثة؟
لا يُمكن فصل عودة "باشا" عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي أعقبت ثورة 2011، حيث شهدت مصر حالةً من البحث عن مرجعياتٍ ثابتة في خضمِّ الفوضى الإقليمية، وهنا يتحول اللقب إلى أداةٍ أسطورية تُعيد إنتاج الهيبة الرمزية للدولة، عبر توظيف التاريخ كمساحةٍ آمنة تُحاكِم عليها الحاضر، غير أن المثقف النقدي مُطالبٌ بمساءلة هذه الظاهرة: هل هي مجرد موضةٍ نخبوية تعكس حنينًا رومانسيًّا للماضي؟ أم هي تعبيرٌ عن رغبةٍ في إعادة تأسيس هرمية اجتماعية جديدة، تُكرِّس الانقسام بين "النخبة" و"الجماهير" في عصرٍ تُعلن فيه الدولة شعارات العدالة الاجتماعية؟
إن تسمية رجال الأعمال بألقابٍ تُذكِّر بالعصر الملكي – مثل "نصيف باشا ساويرس" أو "هشام طلعت مصطفى باشا" – ليست بريئةً ثقافيًا، فهي تربط بين الرأسمالية المعاصرة وأنظمة الحكم القديمة، وكأنما تُعيد تعريف "الهُوية المصرية" عبر مزج الرأسمالية الجديدة بالتراث الإمبراطوري، هذا التفاعل يُشبه – من منظور مدرسة فرانكفورت – تحويل الرموز التاريخية إلى "سلعةٍ ثقافية" تُباع في سوق الهُويات الحديثة..
لا ينفصل اقتراح الغزالي حرب عن السياق العالمي لصعود النيوليبرالية، حيث تُصبح الرأسماليةُ ليست نظامًا اقتصاديًا فحسب، بل أيديولوجيةً تفرض رموزها الخاصة، فلقب "الباشا" الجديد قد يكون تعبيرًا عن حاجة النخبة إلى شرعنة مكانتها عبر ربطها برموز الماضي، بينما تبحث الدولة عن أدواتٍ لاحتواء القوة الاقتصادية في إطارٍ رمزيٍّ يُحيّدها سياسيًا.
وفي النهاية، فإن دلالة عودة "باشا" تظلُّ مرهونةً بسياقات تأويلها، وقد تكون مجرد زخرفةٍ لغوية في خطابٍ ثقافي، أو مؤشرًا على تحوُّلاتٍ أعمق في بنية السلطة والهُوية، ولكنَّ جمالية الظاهرة تكمن في كونها تُذكِّرنا بأن التاريخ ليس سردًا مغلقًا، بل حقلًا من الإمكانات التي تُعيد المجتمعات تشكيلها وفقًا لحاجاتها الرمزية المتجددة، وهنا يبرز السؤال الأعمق: هل تُريد مصرُ أن تُعيد إنتاجَ "باشوات" جدد كمحركٍ للتنمية؟ أم أن عليها أن تخلق نموذجًا لتكريمٍ حديثٍ لا يرتهن لرموز الإمبراطوريات البائدة؟ الإجابة تكمن في قدرة المجتمع على اختراع لغةٍ جديدةٍ للقيمة، تكون جذورها في المستقبل، لا في متحف الماضي.
-------------------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش